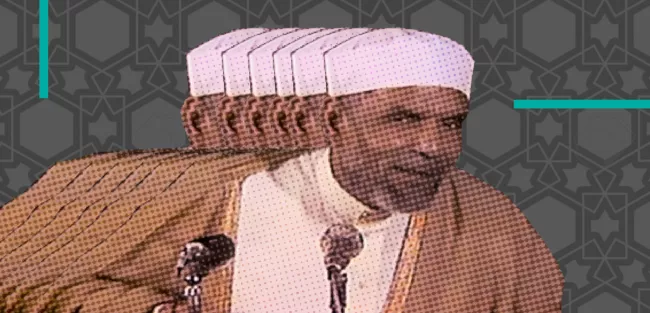بعد عام الطوفان.. المثقفين عايزين مننا إيه يا كابتن متحت؟
لم يحظَ رجل دين في تاريخنا المعاصر بحجم تقديس وتبجيل وتنزيه مثل الذي حظي به الشيخ محمد متولي الشعرواي. إلا أن سجوده شكرًا لهزيمة مصر في عام 1967، على خلفية أيديولوجية تأبى التصالح ولو أثناء الحرب مع "النظم الاشتراكية"، كما قال، ظلَّ نقطة انطلاق هجوم الأقلية الكارهة له إلى حدّ الاحتقار والمعايرة، ومبعث حرج للأغلبية التي تكاد تقدِّسه ولكنها لا تجد منطقًا يستقيم للدفاع عنه سوى بالتعقيب "له ما له وعليه ما عليه".
ثم دارت الدنيا دورتها، لنجد من هاجموا الشعراوي بالأمس على سجوده شاكرًا للهزيمة، وهو فعل أراه مُخزيًا، يرقصون طربًا للأسباب ذاتها وبالدوافع ذاتها. استدارت عيناي دهشةً وأنا أتابع مَن قَلَب شفته السفلى ازدراءً للشعراوي بالأمس، يتهلل فرحًا لانتصار العدو الصهيوني، من المنطلقات نفسها؛ خصامه الأيديولوجي مع الإسلام السياسي، أو عدائه الطائفي للشيعة وللأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي قضى نحبه في غارة إسرائيلية مدوية، راح على أثرها عشرات الأرواح البريئة، وإن كانت شيعية!
وزامن هذه العملية احتفال صهيوني، بنصر وصفه نتنياهو بـ"غير المسبوق"، وأنه هزيمة قاصمة لكل من يؤيد "الإرهاب ضد إسرائيل"، وبشرى سارة لكل "أصدقاء إسرائيل". فحسن نصر الله بالنسبة لنتنياهو "ليس إرهابيًا، بل هو الإرهابي"، ويرى أن مقتل هذا "الإرهابي" سيُحْكِم الحصار على غزة "فلن يجد السنوار من يخفف عنه الضغط الإسرائيلي من الشمال"، كما قال رئيس الحكومة المعادية لمصر بالدعوة لاحتلالها، مهما وقَّعنا معها من معاهدات.
يهدِّد نتنياهو بأن عملية الاغتيال الناجحة هذه، التي استبشرت بها أصوات عربية، لن تكون الأخيرة، ويبشرنا بما أعدَّه لنا من مفاجآت، بعد جريمة البيجر، ومن قبلها وبعدها جرائم كثر، تُسعد بعض الناس لمجرد أنهم لا يحبون الإسلام السياسي.
قبل هذا النصر الإسرائيلي المؤزر على حزب الله، قتلت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وهو سني، انحاز لمن كان حزب الله يقاتلهم في الحرب الأهلية السورية. ومع ذلك وجد نفس الناس، الذين يحلو للبعض تسميتهم بالمثقفين، مدخلًا للهجوم على جثمانه المسجى تحت صاروخ إسرائيلي، بالادعاء كذبًا أنه قتَل جنودنا في سيناء، فأنهكونا في تفنيد هذه التهمة الباطلة بدلًا من تركنا نحزن في صمت.
كل هذه الاحتفالات بانتصارات العدو التي تبهجهم، والشيخ الشعراوي لا يزال "كُخة" من أجل سجدة؟
لماذا نرفض نقد بعض "المثقفين" لموقف المقاومة في حرب غزة؟ هل لا نزال متمسكين بشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" الذي أودى بنا إلى هزيمة 1967؟ هل نسينا أن القمع الصدَّامي هو من جلب الاحتلال على العراق الذي عانى ويعاني قبل وإبان وبعد حكمه الغاشم؟ ألا نذكر أن استجلاب الصراعات أصبح الحل السحري لكل سياسي مأزوم يتلمس تلمظ الشارع والحرب هي اللجام الذي يكبح به ذلك الغضب؟ وليس أدل على ذلك من نتنياهو نفسه، الذي يخرج من صراع ليدخل آخر، هربًا من المنظومة التي تتوق إلى ملاحقته قضائيًا.
لماذا إذن كنا ندعم التظاهرات الأمريكية المعارضة لاحتلال فيتنام والعراق، ولم نصمها بخيانة الأوطان؟ لماذا لا نحذو حذوهم فنتظاهر ضد حماس وحزب الله؟ ولماذا نسعد بالتظاهرات ضد نتنياهو إذن؟ هل نحن مع الإسلام السياسي، بكل ما نعلمه عنه من قمع وقهر باسم الله، والرغبة في تدمير كل الدول المؤسسية؟ هل نغض الطرف عما ارتكبته حماس ضد الفلسطينيين في غزة؟ هل نضرب صفحًا عن ممارسات حزب الله في سوريا؟ أليست هذه المنظمات طائفية بالتعريف، معادية للنساء بالممارسة؟
أسئلة سأمثل نفسي في الإجابة عنها، وسيغضب الجميع مني كالعادة.
نعم، كل هذه الأسئلة الاستنكارية سليمة تمامًا وأتفق معها جملةً وتفصيلًا، ولكن بشروط معينة.
الشرط الأول: أن تكون هناك معركة!
أين هي المعركة؟ أنا لا أراها. لا أرى سوى جريمة كوكبية تمالأت عليها قيادات العالم أجمع، أو ربما مجلس إدارة العالم، الذي يبدو والله أعلم أنه موجود رغم سخريتنا منه.
ثم انكشافات لعدد لا بأس به من الناس، بأن الاحتلال في فلسطين هو احتلال عولمي وليس إسرائيليًا فحسب، وأن "الشعوب الحرة"، ليست حرة، وليس لها رأي، ولا يحسب حساب اعتراضها. وأن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمساواة، وحقوق النساء، وحقوق الأطفال، والحقوق الشخصية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في السكن، والحق في الحياة، وحق الأشجار في الوجود، ومكافحة الاحتباس الحراري، بل والحق في الاتصاف بصفة "الإنسان"، ما هي إلا أكاذيب خُدعت بها الشعوب "المتحضرة"، "الحرة"، التي "تملك قرارها"، وتتمتع "بانتخابات حرة نزيهة"، وتفهم "التعددية" و"قبول الآخر".
عاشوا، لعقود، باسمين، راضين، متحمسين في مشيتهم الصباحية وهم ذاهبون إلى أعمالهم التي تضمَن لهم الرفاه، والتنعم، والدعة، ثم اكتشفوا أن كل ذلك ملوث بدماء نساء وأطفال، وصُدموا صدمة مَن ملأ بطنه بوليمة شهية، ثم قيل له وهو يغسل يديه: الستيك الشهي الذي أكلته الآن كان لحم طفل.
فلنخل جريمة الاحتلال القائمة منذ ما يربو عن ثمانية عقود، ولنكتشف سويًا جريمة ترتكب في حق شعوب الأرض قاطبة! أين المعركة؟ المعركة تكون بين جيشين، قوتين يمكن أن نقيس تكافؤهما نسبة لمعيار ما.
أما الحدث الجاري فهو جريمة عالمية تدهس كل القيم التي قيل للناس جمعاء بأن الحضارة الحالية قائمة عليها. وإذا اجتمعت عدة عناصر في هذا المشهد المفجع، فلا بد أن نتنبه إلى الاعتداء علينا أولًا قبل الاعتداء على من يجاورنا.
ما يحدث هو تهديد لكل إنسان يقبع في بيته، من قوى عالمية لا يحكمها حاكم ولا يردعها رادع، ولا تعترف بقرارات منظمات هي التي أنشأتها، لتقول لنا بكل تبجح: محكمة دولية على نفسك!
بينما نتحدث عن "حماقة" قرار القسام باختطاف جنود لمبادلتهم، وهو حق مشروع لمواطنين تحت الاحتلال، أو "تشيع" حزب الله ومشاركته في الحرب الأهلية في سوريا، تُسَّن سُنَّةٌ بأن لا حرمة لإنسان، أو قيمة، أو مؤسسة، أو قانون، أو استجداء، أو استعطاف، أو غضب، أو ناخب، أو ضغط شعبي، أو مقاطعة اقتصادية، أمام مصالح الرأسمالية العالمية.
هذه السُّنة ستطال كل من على الأرض عاجلًا أم آجلًا، وهذه السُّنة لها الأولوية في الـzoom in، لأن تلك الحناجر التي بُحَّت وهي تطالب بحقها في عدم المشاركة في الجريمة، سوف تُنحر في يوم لا محالة. ولا أعلم لماذا حين نطرح هذا الطرح نقابل بابتسام ساخر "مش معقول!" لماذا "مش معقول"؟ هل ما نراه الآن معقولًا؟
الشرط الثاني: أن نأكل سويسرا ونشرب سويسرا
أستعير قول الحاج حناوي في فيلم كركر؛ أن نكون "بناكل سويسرا ونشرب سويسرا ونتكلم سويسرا". ما هذه المقارنة العجيبة للحيوانات البشرية، نحن، بالأمريكيين والأوروبيين الذين يتظاهرون ضد قيام بلادهم باحتلال الآخرين؟ حسنًا، سوف أتظاهر جدًا جدًا جدًا ضد حماس وحزب الله وأي حكومة عربية تقرر احتلال الصومال أو جزر القمر أو تايلاند أو جرين لاند. وسوف أدعم الشعب الفلسطيني في غزة في تظاهراته ضد حماس، ولكن أوقفوا القصف ليتمكن الفلسطينيون من التظاهر ضد حماس! هل يستطيع المتشدق بهذه الأسئلة أن يوقف القصف لتمكين معارضي حماس من حق التظاهر؟ هل تمكَّن المتظاهرون في أوروبا وأمريكا وإسرائيل من وقف تلك المجزرة؟
حين يتظاهر المواطن الأبيض ضد حكومته فهو يطالبها بوقف إطلاق النار أو التراجع عن العملية العسكرية. ما الذي تطلبه أنت الآن من القسام أو حزب الله؟ ألَّا يموتوا حين تسقط القذائف فوق رؤوسهم؟ أم أن يتوقفوا عن المقاومة وهم في النزع الأخير، حاملين سلاحهم بأيديهم السليمة بينما أذرعهم الأخرى مقطوعة، زاحفين على بطونهم بأرجلهم المبتورة؟ ما هي مطالبك بالضبط الآن؟ ما هي مطالب نتنياهو ذاته الآن؟
الشرط الثالث: أن تطرح البدائل!
ذات مرة، كنت أتحدث مع أمريكي يعمل في مجال أدوات التجميل، ولا علاقة له مطلقًا بالسياسة، لكنه باغتني متسائلًا؛ "صدعتونا بقضية فلسطين، لماذا لا تشترونها؟ أنا أعلم، بحكم عملي، أسماء رجال الأعمال العرب المساهمين في شركات التجميل العالمية، ناهيك عن أولئك المساهمين في شركات صناعة السينما الكبرى بل وشركات صناعة السلاح. هؤلاء قوة اقتصادية لا يستهان بها، وهم ليسوا بحاجة إلى دفع المال، مجرد التهديد بسحب كافة أسهمهم من تلك الشركات كفيل بتأسيس دولة فلسطينية". لم أملك سوى أن أقول "هؤلاء ليسوا مخلصين". فهز كتفيه وقال؛ "فلماذا عليَّ أنا أن أكون مخلصًا؟".
بالطبع كانت إجابتي "لأنك إنسان". لكن يبدو أن هذه الإجابة لم تقنعه. في لحظتها لم أفهم لماذا لم يقتنع بتلك الإجابة التي ظننتها مفحمة. لكن الرد جاءني حين وقف نتنياهو يقول في الكونجرس "إبراهيم ويعقوب وإسحاق والملك داود والملك سليمان!". ووقف أعضاء الكونجرس يصفقون لهذا الهراء. ثم أعقبوا تصفيقهم بآخر أكثر حماسًا حين قال إن هذا صراع بين الحضارة والتخلف. علمًا بأن سكان هذه المنطقة، من الحيوانات البشرية، يؤمن أغلبهم بإبراهيم ويعقوب وإسحاق والملك داود والملك سليمان وكل الجمع الكريم. إلا أن نتنياهو، ومن خلفه المصفقون، يرون أن إبراهيمهم رمز الحضارة، بينما إبراهيمنا رمز التخلف، هو هو نفس ذات الإبراهيم!
لا، لست داعمة للإسلام السياسي، ولا أقبل أن يحكم بلادي ولو ربع ساعة. ويمكنني رص كل الحيثيات الكفيلة بإقناع أعضاء داعش أنفسهم. ولم أنسَ ما قامت به حركة حماس بحق الفلسطينيين في غزة في أوقات الهدوء النسبي، ولم أتغاضَ عن دور حزب الله في الحرب الأهلية السورية، ويمكنني إدانة الحركتين على كل شيء وأي شيء، إلا الشيء الوحيد الصحيح الذي يفعلونه؛ حمل السلاح ضد المحتل! ولن أنتقدهم على حمل السلاح ضد المحتل إلا إذا قدمت بديلًا.
أود، بل وأرغب، بل وأطالب كل أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال، بحمل السلاح ضد المحتل، وهو حق مشروع كفله ميثاق الأمم المتحدة الذي يُضرَب به عرض الحائط الآن. المقاومة المسلحة ليست من اختراع الإسلام السياسي. ذات يوم، كان القائمون على اختطاف الطائرات، والعمليات ضد المستوطنين، وتفجير ثكنات جيش الاحتلال، واغتيال كل من يتعاون معه، أناس ينتمون إلى أطياف وأيديولوجيات تخاصم الإسلام السياسي، بل معادية له.
والأنكى، أنهم اِتُّهِموا في ذلك الوقت بالكفر والإلحاد، والسُكر والزنا، و"طبل وزمر وعلاقات جنسية كاملة". وكانوا يوصمون بالإرهاب، وبأنهم يعتدون على "المدنيين" من المحتلين، ووصل الأمر إلى اتهامات أخلاقية بحق المناضلات الفلسطينيات اللاتي حملن أرواحهن على أكفهن.
إذن فالموقف ليس ضد الأيديولوجيا، كما يدعي بعض الناس، وإنما هو موقف ممنهج ضد المقاومة المسلحة للاحتلال، وكانت هناك بعض الاقتراحات بالمقاومة "السلمية"، عن طريق الرقصات الشعبية، والغناء الفولكلوري، والأطعمة الوطنية. تحت الاحتلال! دبكة وميجانا وعتابا ومسخن تحت القصف، في نقاط التفتيش، أمام جدار الفصل العنصري، أثناء هدم البيوت لبناء المستوطنات، وتجريف مزارع الزيتون والكروم؛ هذا هو نوع المقاومة الذي يراه المعادون للكفاح المسلح ناجعًا، ترويج للسياحة في دولة الكيان؛ "تعالوا إسرائيل وشاهدوا الحيوانات البشرية وهي ترقص وتغني أثناء قتلهم". وهذا ليس تقليلًا من المقاومة الثقافية، لكنها فنون تصاحب الكفاح المسلح لدعم وتفسير أحقيته.
وليس هناك أدل على أن الأمر لا يتعلق بالعداء للإسلام السياسي بالذات، وإنما للكفاح المسلح من أجل تحرير الأرض أيًا كانت أيديولوجية من يمارسه، هو ازدياد نبرة الهجوم المفاجئ على اليسار! أين هو اليسار؟ ما هو الكيان التنظيمي اليساري المقصود بهذا الهجوم؟ اليسار انهار كمشروع مع انهيار الاتحاد السوفيتي، ولم تبقَ منه سوى مجموعات متشظية من المتمسكين بكلياته وأحلامه المبتورة، غير منظمين، ولا يهددون أحدًا.
حتى ذلك اليسار الغربي المزعوم، ليس يسارًا بأي حال كونه يعمل تحت منظومة رأسمالية، تغذيه وتحتفظ به كتميمة تستكمل بها صورة التنوع الزائفة. هذا هجوم بأثر رجعي على حركات المقاومة اليسارية التي كانت في يوم من الأيام واندثرت.
أين حدث، في أي بقعة من بقاع الأرض، أن استعاد أصحاب الحق حقهم بالرقص والغناء وطهي الطعام؟ حتى فكرة التظاهر السلمي لم تُطرح من قبل المعادين للمقاومة المسلحة. ويكفينا في موضعنا هذا مناقشة هذه الترَّهات؛ الصورة الواضحة الآن، هي أننا أمام شعب يريد أرضه، ويتمسك بحقه، ولا يرغب في التنازل عنه، ولا يبدو أنه مهتم بالأيديولوجيا بحد ذاتها.
ارتدى حلة اليسار مرة، وثوب القومية مرة، ورداء الإسلام السياسي مرة، وهو ساعٍ إلى أي مظلة تمنحه الحق في الكفاح. ونحن لا نصنف المعتدى عليهم بتصنيفات أيديولوجية! التصنيفات الأيديولوجية نبحثها في ظل الظروف الهانئة الوادعة اللطيفة ونحن نعقد انتخاباتنا الحرة النزيهة.
إنَّ تناحُر أصحاب الحق فيما بينهم، بل ورداءة سلوكياتهم، واستسخافك لبعضهم، وكراهيتك لبني جلدتهم كافة بسبب زميلك الفلسطيني أو اللبناني الذي هيَّأ لك "الخوازيق" أثناء عملك في الخليج، أو جارتك الفلسطينية التي كانت تسبُّ مصر، أو ذلك الشيعي الذي سبَّ الصحابة أمامك، كل ذلك لا ينفي حقهم في أرضهم. فأنت مع سوء طويتك، وانحراف أحكامك على الأمور والآخرين، لا يحق لأحد سلبك أرضك ووطنك أيضًا، حتى وإن أكلت ميراث أختك، أو تحرشت بنساء جيرتك، أو تقاضيت الرشاوى في محل عملك، أو كنت ممن يسكنون الساحل الشرير من مال السمسرة والتجارة في أقوات بني وطنهم الفقراء.
الشرط الأخير: لا نلوم الضحية!
صدقت حكومة نتنياهو وهو الكذوب وهي تردد أن كل أهالي غزة متورطون في السابع من أكتوبر، ولهم الشرف. ما حدث أن كتائب القسام ارتأت أن تختطف بعض الجنود من غلاف غزة، لتبادل بهم الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال بلا أي معايير قانونية أو إنسانية أو دينية، في تكرار لتجربة صفقة جلعاد شاليط. الفكرة بحدِّ ذاتها مشروعة، ولهم الحق، بل عليهم الواجب، في بذل كل الجهد لتحرير إخوتهم من بين أنياب الاحتلال، وهم ليسوا عجبةً في ذلك، فهذا ما سلكته كل حركات المقاومة في كل بقاع الأرض.
لكنهم لم يحسبوا حساب حفلة صاخبة يقيمها المحتلون على أرضهم، يأكلون ويشربون ويسمرون ويرقصون، على بعد كيلومترات قليلة من سجنهم المفتوح. فوجئت عناصر القسام بالمحتفلين قدر ما فوجئ المحتفلون بهم.
ثم إنهم لم يحسبوا أيضًا حساب انهيار دفاعات العدو بهذا الشكل، وتهلهل نظامه الأمني المراهن على خمول أصحاب الأرض.
كان غرض المقاومة إحداث ثقب في الجدار لاستخلاص بعض الجنود لمبادلتهم، فما كان من الجدار إلا أن انهار. لا يمكن لأحد أن يلقي باللوم على المواطنين المدنيين من سكان غزة، الذي قفزوا في التو إلى داخل أراضيهم المنهوبة، فرحًا بهوان قوة العدو. ولا يمكن لوم القسام على خروج الأمر عن سيطرتهم، وتوسعه لمدى لم يحسبوا حسابه. ولا يليق بأن يُقَرّع نازح مدني من أرضه لأسره مستوطنًا مغتصبًا بدعوى أنه "مدني".
تحول المشهد من عملية عسكرية للمقاومة، إلى احتفالات شعبية، حيث يجر فلسطيني، لم يجاوز السابعة عشر، صهيونيًا ويمسكه من قفاه وهو منتش بأنه، ولو لمرة واحدة في عمره، في موقف الأقوى. حقه!
هذا هو الحق وأحق الحق. ما ليس بحق هو الإبادة التي يسميها البعض "رد الفعل الإسرائيلي"! ما يقوم به الاحتلال ليس ردود فعل، الاحتلال هو الفعل، والمقاومة هي الرد عليه. والانتقام الدموي المروع الذي نشهده ليس إلا إمعانًا في ظلم تدعمه كل القوى العالمية شرقًا وغربًا، ولا يهدف إلا للقتل ثم القتل ثم القتل، وليس للقاتل أي مطالب إذا تحققت، توقف هو عن القتل، فقد أعلنها بأنه يرغب في هدنة لاستعادة المختطفين في أمان، ثم يعاود القتل مرة أخرى، ومن هنا توصف حماس بـ"التعنت"، لأنها ترفض أن تستكمل إسرائيل المقتلة بعد أن تستعيد مختطفيها.
هناك خط يفصل بين النقد الذي يوجه النصح والإرشاد للصالح العام، وذلك الذي يهدف إلى لوم الضحية. خاصة عندما تكون هذه الضحية شعب غزة أغلبه، لا حماس فقط. من الذين داهموا أماكن العدو محتفين بتمكنهم من زيارة أرضهم المغتصبة، وأسروا من قابلوه في طريقهم؟ على من يقع اللوم الآن؟ على تخطيط حماس للعملية؟ أم على المواطنين، وهم لاجئون أصلًا من بيوتهم التي هدمت وبني محلها المستوطنات، فعادوا إليها بمجرد أن فتحت لهم حماس الباب؟ أنت تلوم صاحب الأرض على زيارة أرضه؟ حقًا؟ هذا ما تفعله؟ أم أنك تلوم حزب الله -الشيعي، الرجعي، الذي ذهب إلى سوريا- لأنه قام بما لم تقم به أنت، وحاول تشتيت قوى العدو استجابة لصرخات الأطفال والنساء؟
ثم إن المقاومة ليست اختيارًا ديمقراطيًا. الديمقراطية رفاهية لا يملكها المغتصبة أرضه والمهانة كرامته. المقاومة واجب، ولا أحد يقترع على الواجب. لم يصوِّت الفرنسيون على مقاومة النازي، ولا الأيرلنديون على مقاومة البريطاني، ولا الفيتناميون على مقاومة الأمريكي. كل منهم هبَّ لواجبه، وأولئك "المعارضون"، لم تكن أصواتًا تستحق السماع، هم مقصرون في حق أوطانهم.
والسلام على من اتَّبع الإنسانية.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.