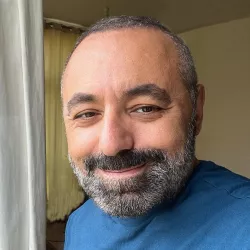هل "انتهت حلول الأرض" أم أننا لم نعد نراها؟
اضطراب البوصلة إلى حدود التلف
"انتهت حلول الأرض"، جملة أصبحت مألوفة هذه الأيام، يقولها المعارف والأصدقاء ويكتبها الناس على السوشيال ميديا، في تعبير جماعي عن درجة غير مسبوقة من اليأس والضجر من الأحوال العامة في مصر. فكيف وصلنا إلى هذا المستوى من الاستسلام التام للأقدار وانتظار الفرج من السماء وحدها؟
هناك أكثر من مردٍّ لجملةٍ على هذا اليقين من اليأس؛ سيادة نوع من القمع العاري الاستئصالي الطابع الذي تمارسه السلطة على كل من يخالفها، وغياب المعلومات الأساسية الصحيحة التي تُمكِّن الإنسان المتعلم من فهم ما يحدث حوله على المستوى العام وفهم انعكاس ذلك على حياته الخاصة، ثم تجهيل وسرية الكتلة الحاكمة التي يمكن التفاوض أو الصراع معها، ودور هذا التجهيل في الشعور بفقدان القدرة على امتلاك المصير.
لكني سأختار في هذا المقال زاوية أخرى، أراها أكثر مركزية في تفسير وفهم حالة "انتهت حلول الأرض"؛ وهي اضطراب البوصلة وغياب الوجهة، بمعنى غياب أي تصور عما يجب أن يكون عليه شكل المستقبل لدرجة انعدام اليقين، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية وعالمية صعبة تتطلب تضحيات جسامًا، من مجتمع سبق وقدم بالفعل تضحيات كبيرة منذ 2011، تمخض عنها حكم عصبي وعنيف وإحباطات مؤلمة، فكان اليأس المقيم على قدر الرجاء الكبير.
"متى" كان إردوغان؟
في تاريخ مصر الحديث، دائمًا ما كانت هناك بوصلة وهدف نهائي نعتقد أننا بالوصول إليه وتحقيقه ستصبح كل العقد والإشكالات في طريقها إلى الحل. في مرحلةٍ سابقة كان الاستقلالُ الوطني هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تخضع له باقي الأهداف، وشرطًا لازمًا لتحقيق العدل والتنمية والتقدم. وفي مرحلة لاحقة كانت الاشتراكية والوحدة العربية الهدف الأسمى، فالمجتمع المتقدم بالكفاية والعدل يحتاج إلى دولة كبرى موحدة لتحققه وتحميه.
بعد ذلك تغيّر الوعد الكبير، وأصبح الهدف النهائي هو الالتحاق بالعالم المتقدم عبر بوابة الاندماج الكامل في النظام الرأسمالي العالمي من مواقع لائقة ومتقدمة، لذلك فعلينا تلبية الشروط اللازمة لذلك، وفتح الأسواق للتبادل السلعي الحر الكامل الذي سيمنحنا فرصة الحصول على تكنولوجيات متطورة، ما يتطلب وجود بنية قانونية وتشريعية مغايرة تضمن ذلك، في ظل نوع من الديمقراطية السياسية والحكم الرشيد الذي يحمي ويصون هذه المنظومة ككل.
البوصلة النيوليبرالية في مصر قديمة ومؤجلة قِدَم سياسات الانفتاح الاقتصادي وتوقيع كامب ديفيد، التي تأسست على سرديةٍ تربط السلام مع إسرائيل بالرخاء والأمركة والديمقراطية والرسملة، وجميعها عناصر ستشكل في تفاعلها سبيكةً ستتجاوز من خلالها مصر عنق الزجاجة.
هذه البوصلة وضعت حدود وتخوم الجدل السياسي والاجتماعي، الذي دار بالأساس حول الأولويات التي تجعلنا نحقق هذا الهدف؛ هل الإصلاح الاقتصادي يسبق الإصلاح السياسي أم يلحق به؟ أم أن العملية تتطلب سيرهما معًا بالتوازي؟ هنا علينا أن نتذكر أن كلمة "إصلاح" هنا لا تشير إلا إلى المضي قدمًا في طريق النيوليبرالية والخصخصة.
تبنى النظام طوال عهدي السادات ومبارك أولوية الإصلاح الاقتصادي البطيء على الإصلاح السياسي شديد البطء، لكنه في الوقت نفسه ظل مؤمنًا بالمبدأ العام القائل بأن الإصلاح السياسي حتمي وإن تأخر. ولهذا ظل خطاب نظام مبارك يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي حتى وإن تأجل إلى الأبد، وهو ما ظهر بجلاء وصراحة في حوار عمر سليمان الشهير مع كريستيان أمانبور أثناء ثورة يناير، حين قال "كل الناس تؤمن بالديمقراطية، ولكن متى؟".
هذا الوعد الجديد هو ما دارت مصر في فلكه منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين حتى نهاية نظام مبارك. تلكأت كثيرًا في تحقيقه لأسباب داخلية أكثر منها خارجية، ولكنها لم تنجزه في وقته المناسب على أي حال، فالمسألة لا تتعلق فقط بما الذي يجب فعله به بل بتوقيته أيضًا، وكانت هذه الموجةُ رائجةً في مطلع التسعينيات، لكن النظام ظل يقتات على التأجيل المستمر لوعده، فأهدر فترة الثمانينيات والتسعينيات دون خطوات جادة على هذا الطريق.
في الوقت نفسه تقريبًا كان نجم رجب طيب إردوغان يسطع في سماء تركيا، ليتحول في غضون سنوات إلى بوصلة بنَّاءة لكثير من الإسلاميين المعتدلين في المنطقة، وإلى حالة تُعجب بها وتقدرها الولايات المتحدة نفسها. فقد نجح الرجل في إدماج تركيا بشكل ناجع في النظام الرأسمالي العالمي وفتح أسواقها عبر تطبيق الأجندة النيوليبرالية بمهارة، نالت قدرًا عاليًا من القبول الشعبي.
تمكن إردوغان من تمرير سياساته على هامش معارك طواحين الهواء الإسلامية العلمانية التي وسَمَت الجدل السياسي التركي ولا تزال، ونجح في تقليم أظافر بعض مكونات البيروقراطية العسكرية التي طالما أعاقت عملية الإدماج تلك بحكم طبيعة مصالحها.
كان هذا هو المفتاح الحقيقي لنجاح حكم "إردوغان الأول" بين عامي 2002 و2012، وما جعله رقمًا صعبًا في السياسة الإقليمية والدولية حتى الآن، وما عداه تفاصيل هامشية. لم يكن السؤال فقط من هو إردوغان وماذا يمثل، بل كان أيضًا متى ظهر إردوغان وما هي اللحظة التي اشتبك فيها مشروعه مع مسار التاريخ.
ولكن الأزمة عالمية هي الأخرى
في الأصل علينا أن نعترف أننا في مصر، وبصرف النظر عن المواقع الأيديولوجية ليبرالية أو اشتراكية أو قومية أو حتى إسلامية، لسنا أصحاب تفكير أصلاني ينتج برامجه المشتبكة من داخل واقعه المحلي واحتياجاته وأسئلته، بقدر ما يقلد الآخر وينقل عنه، سواء كان ذلك تقليدًا نابهًا أو نقلًا كسولًا.
لذلك، تضاعف من أزماتنا الحالية بشدة حقيقة أن ما نسعى لنقله وتقليده منذ منتصف السبعينيات أضحى اليوم في خريفه وشيخوخته، فلم نعد فقط متباطئين عاجزين عن التقليد، بل صرنا ندرك، ببطء أيضًا، أن الأصل الذي نقلد عنه بات مأزومًا وعاجزًا عن إجابة أسئلة وجوده هو، مع التسليم بكونه آتيًا من مصادر أكثر تقدمًا نراها قدوة يُحتذى بها.
ما كانت تؤمن به الطبقة الوسطى المصرية كوجهة وبوصلة نهائية استحال كابوسًا يدمر حياتهم
منذ أن تسيد منطقُ الليبراليةِ الجديدةِ العالمَ، واحتكر تقديم كل الوعود، اضمحلت السياسة إلى حدود البله والشعوذة، وتحولت مصطلحاتها إلى مصطلحات خيرية مجردة. سطعت شعارات سياسية مثل الإصلاح والتغيير والأمل، وهي كلمات غامضة على درجة عالية من التجريد والتأويل المفتوح. واشتد سطوعها مع صعود نجم باراك أوباما في خريف عام 2008، وعبّرت في غموضها عن وجهين لعملة واحدة؛ تأجيل الأزمة العنيفة التي أصابت النظام الرأسمالي العالمي.
الوجه الأول، هو التضليل الانتهازي المتعمد عبر استخدام كلمات لها مدلولات غامضة لكنها جامعة، تصلح لاحتواء آمال الجميع بدون وعد محدد، أو ربما هي لا تقدم وعدًا محددًا لتكون صالحةً لمخاطبة الجميع.
أما الوجه الثاني لهذا الغموض، والأكثر مادية، فهو اعتبار الإصلاح والتغيير والأمل حارات في مسار وطريق وحيد، وهو طريق النيوليبرالية والالتحاق بالسوق العالمية من مواقع متقدمة في إطار تصور كوكبي واحد ومصمت عن العالم.
أنت هنا لم تعد بحاجة إلى تحديد معنى الإصلاح أو تعريف التغيير والأمل، بما أنها أشياء معروفة سلفًا بيقين بديهي لا يحتاج شرحًا. لا توجد هناك أجندة أخرى على هذا الكوكب سوى هذه، وبالتالى عليك أن تُصلِح وتُغيِّر وتأمل في إطار الموجود والكائن، الذي لا يخضع للمناقشة بل لا يحتاج إلى ذكر من الأساس.
ومن داخل هذا العالم الغارق في فراغ محتواه، نجد أننا في ظل الحكم الحالي حققنا كل ما هو مشؤوم من داخل وعود النيوليبرالية؛ أُلحقنا بالاقتصاد الرأسمالي العالمي وأمواله الساخنة أو المغسولة ولكن من أدنى المواقع، وصارت عملتنا وقيمتها رهينة بالكامل لقرارات الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار.
يتم خصخصة كل شيء وأي شيء بدون حد أدنى من الرقابة والمحاسبة، وفي الوقت نفسه بدون أي صيغة من صيغ الديمقراطية أو الحكم الرشيد، وفي ظل استبداد هو الأعنف في تاريخنا الحديث، إلى درجة تمس بأهلية من تبقى من سكانٍ يتصورون أنهم مواطنون.
لم تعد حزمة الوعود التي قدمتها النيوليبرالية والعولمة للطبقات الوسطى في دول العالم المتخلف أو حتى المتقدم حافزًا للنضال ولا دافعًا للتضحية، وأصبحت محل شك شديد. يضحي الناس من أجل ما يؤمنون به، لكنهم لن يفعلوا ذلك ما لم يصدقوا إمكانية جعل قناعاتهم واقعًا ماديًا يشكل حياتهم ومستقبلهم.
وما كانت تؤمن به الطبقة الوسطى المصرية كوجهة وبوصلة نهائية، استحال كابوسًا يدمر حياتهم وهم يشاهدون المصدر الغربي، القدوة، غارقًا في أزماته لدرجة استساغ معها تفجير الحروب وتهديد السلام العالمي.
لذا، وفي ظل هذه الأزمة النظرية والعقائدية العميقة، يمكن فهم جانب ما من مقولة "انتهت حلول الأرض". نعم، انتهت الحلول القادمة من داخل المنطق النيوليبرالي كما تخيلها الكثيرون، أو أرادوها نموذجًا، لكنَّ هذه مشكلتهم على أي حال، لا مشكلة الأرض ولا كل من عليها، ولا مشكلة السماء بالطبع.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.