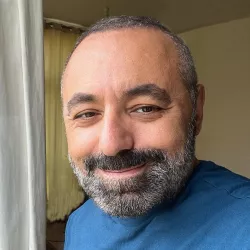لا تخشَ الأسوأ القادم.. لقد أتى
الحياة تحت سلطة لها ملامح فاشية فعل مُقاومة في حد ذاته، فالمسألة شديدة الوطأة ولها كلفتها المادية والروحية ومخاطرها المستمرة، والحفاظ على حدٍّ أدنىً من اللياقة الإنسانية والنفسية في عالم كهذا، كافٍ جدًا للشعور بالفخر، فالأمر ليس هينًا بالمرة.
مُرهِقٌ هو العيش تحت سلطة تحتكر الميكروفون وتتأرجح دعاياتها بين وعود أسطورية بالرخاء وتهديدات وجودية بالفناء، فهي إما مصر التي ستصبح، أو أصبحت بالفعل، "قد الدنيا" أو هي مصر "شبه الدولة" التي يتآمر عليها كل العالم ووجودها مهدد من طابور طويل من الأعداء؛ يبدأ بالإمبراطور الأمريكي وينتهي باللاجئ الأفريقي.
إذا همست بالقول إن مصر ليست "قد الدنيا" سيتم اتهامك بالتشكيك في الإنجازات الأسطورية فرعونية الملامح، وإذا عبرت عن ضجرك من تكرار الحديث عن المؤامرات الكونية سيتم اتهامك بأنك جزء منها، فأنت تعيش في ظل بروباجندا تتحرك فى اضطراب مأفون بين الرائع جدًا والفظيع جدًا، وعليك أن تتأرجح مع بندول هذه الاضطرابات وبإيقاع طبولها نفسه.
في كهوف الإنكار وأقبيته تغيب الفطنة وتصاب الأدمغة بدرجات من الأكسدة وبلادة الحس
بندول الإهانات والتكدير
حين تُتلى على مسامعك بُشرى وصول مصر لمنزلة "قد الدنيا" في لحظة تتدهور فيها مفردات حياتك وحياة من حولك، فهذه ليست مجرد دعاية متفائلة أو دفعة لرفع الروح المعنوية، بل هتك لعرض الكلمات الذي حدثنا عنه نجيب سرور، وإهانة للمعنى بحسب عبد الرحمن الأبنودي.
يُذعن بعض الناس إلى الدعايات التعبوية، وقد يخضع لها أعلاهم قدرًا وأرفعهم شأنًا، ربما لحدود تمس اللياقة الإنسانية، تصل ببعضهم إلى حد التصفيق بكفوف الأقدام قبل الأيدي بعد أن يستسلموا إلى تكرارها الدائم دون برهان، فترهبهم جرأة جهلها المفتون بالقوة واحتكار "المرجلة".
دعايات الطغاة التي في لا عقلانيتها تعجز عن إقناع طفل صغير، يمكن لها أن تُذِل أعناق الرجال وهم يهينون عقولهم بتصديق ما لا يُصدَّق وتبرير ما لا يُعقل. وربما يفعل البعض ذلك بوعيٍّ غائيٍّ، ظنًا منهم بوجود إمكانية لمماطلة الإهانة عبر النسيان وحيل الإنكار، بينما الإنكار هو عين الإهانة والنسيان هو الرجاء المستحيل.
وفي كهوف الإنكار وأقبيته تغيب الفطنة وتصاب الأدمغة بدرجات من الأكسدة وبلادة الحس، يعجز معها الفرد عن إدراك حقيقة أن الإمعان في الإهانة والتكدير هو الوقود الحفاز لآلة الطغيان المعاصر، فالمطلوب الطاعة لا الإيمان، فحتى التأييد المتحمس للطغيان الناتج عن إرادة حرة أمر غير مستحب ومشكوك في ولائه المستقبلي.
الإذعان هو الهدف المرجو من كل نفر تصور في ذاته صفة المواطنة، الذي أصبح عليه من الآن وصاعدًا طاعة الأمر النظامي حتى ولو كان خاطئًا ويعلم صاحبه خطأه، فطاعة الأمر الخاطئ وتنفيذه قبل التفكير فيه هو مسألة المسائل ولب العلاقة وهدف التدريب.
ليس كل الناس هكذا بالطبع، ويعلم الطغاة ذلك جيدًا، لذا فهناك صنف من الناس له نصيب آخر من طُرُق ووسائل الإخضاع تعتمد على التكدير المستمر، والإجبار على الرضا بالعيش في ظل السيئ الذي يٌراد لك التمسك به في صبر ووداعة لأن هناك دائمًا التهديد بما هو أسوأ منه.
كل شيء وارد والمساحات رمادية دائمًا
والأهم أنه لا قانونًا خطيًا للأسوأ الذي ينتظرك ويتم تهديدك به دائمًا. لا قواعد للعبة أو أصولًا للاشتباك، فلا يتم تعيين خطوط حمراء يفهم من خلالها الإنسان حدود حركته وأسقف حضوره بما يسمح له بإدراك عالمه وتحديد تموضعه ونطاق حركته، فكل شيء وارد والمساحات رمادية دائمًا.
الأمر ليس اعتباطيًا وليس وليدًا لصدفة أو نتاجًا لفوضى أو اضطراب رؤية، بل هو في صميم منهج الطغيان المعاصر وطريقة عمله. فالسيطرة المطلقة تستحيل دون أن يكف كل إنسان من تلقاء نفسه عن المبادرة، وأن يمارس رقابة ذاتية قلقة ورعديدة.
ولأنه لا يوجد جهاز يمتلك الإمكانيات التي تمكنه من السيطرة على عشرات الملايين طوال الوقت وفي كل لحظة، لذا يصبح شيوع القمع العشوائي بلا ضابط محدد هو الأساس في عملية الإخضاع. يمكن لإنسان أن يعبر عن رأيه بجرأة شديدة في شأن معين ويمر الأمر بسلام، بل ويتم التفاعل معه بشكل إيجابي، كما يمكن لنفس الشخص أن يعاقب بشدة لو أبدى نقدًا رقيقًا بشأن مسألة أكثر تفاهة وهامشية.
المطلوب هو حضور الخوف كإحساس مجرد ملازم للوجود، وتفكيك المعايير هو المدخل الضروري لكي يؤثر الإنسان السلامة وينسحب من كل وأي عام، بحيث تصبح الرقابة الذاتية ونزع ثقة الإنسان في نفسه وفي المحيط الذي حوله هو تجلي نجاح الطغيان ومعيار تحققه.
لن ينشق القمر.. على الأقل في السنوات القادمة
-كل سنة وحضرتك طيبة. إيه طموحاتك في السنة الجديدة؟
-أن القيامة تقوم
-إيه؟
-القيااامة تقووم!!
هذا الحوار المقتضب كان جزءًا من برنامج تليفزيوني استضاف مواطنين من الشارع المصري في نهاية عام 2016، بُهتت المذيعة من رد المرأة البسيطة ذات الخمار المزركش التي أجابتها بملامح ميتة وهي تحمل حزمة من الخضرة. أرادت المرأة النهاية المريحة العادلة، فهي تثق في عدالة رب العباد يوم العرض العظيم، وعلى القيامة أن تقوم الآن فهذه دنيا لا تُحتمل.
للنزعة "القيامية" حضور قوي في السينما الأمريكية المهيمنة عالميًا، خلقت منها نوعًا سينمائيًا صنع عشرات الأفلام ذات الإنتاج السخي تمحور معظمها حول لحظة "القيامة" والعالم الذي سينتج عنها. العالم "انتهى" 40 مرة على الأقل في أفلام أمريكية أُنتجت غالبيتها في تسعينيات القرن العشرين مع إطلاق صيحة "نهاية التاريخ" لصاحبها فرانسيس فوكوياما.
يؤمن كثيرون بأن أشد أهوال "القيامة" هو انتظارها. ينتظر الناس الحساب في توتر وخوف، نفوسهم رهينة ما كسبت، يطلبون الشفاعة من بعض الأنبياء فيردون عليهم "نفسي نفسي". اندمج هذا التراث مع الوعي المعاصر الذي يتجاور فيه القمع الشمولي مع ترسخ القيم الفردانية والإيمان بانتهاء "المجتمع"وانعدام الرجاء فيه، ليصبح فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه فكرة حداثية ودنيوية وليست مجرد سردية تراثية ليوم القيامة.
لن تحدث مجاعة قيامية وفقًا لمازورة الشدة المستنصرية في زمن الفاطميين ولكن المجاعة المعاصرة تحدث بالفعل كل يوم
والآن، نجح الطغيان المعاصر في تسريب "الهاجس القيامي" إلى وعي ووجدان الكافة، بالشكل الذي يخدم فكرة انتظار الأسوأ مما هو سيئ. في هذه العملية يفقد الفرد والمجتمع معيارية تقييم أي شيء، وتصبح عملية التماهي مع الانحطاط ملازمة لمتوالية الانحطاط ذاتها، فالحس القيامي قادر على قبول وامتصاص أي تدهور حادث بما أنه أكثر رحمة وأقل وطأة من "النهاية الكاملة"، فينتهي الأمر استعدادًا دائمًا للتطبيع مع التدهور والتأقلم معه، وهو الأمر الأسوأ والأشدّ إذلالاً من التدهور نفسه.
الأمثلة كثيرة ومعاصرة، العملة المصرية تنهار قيمتها تباعًا أمام الدولار الأمريكي، والأسعار تتضاعف يومًا تلو الآخر، لكن الحس "القيامي" يخشى المجاعة وثورة الجياع. لن تحدث مجاعة بالطبع، لأن معنى المجاعة في القرن الحادي والعشرين هو أن تفقد الطبقة الوسطى قدرتها على شراء البيض بشكل دوري، وأن تعجز الطبقات الفقيرة عن إيجاد الفول والطعمية والخبز طوال الأسبوع. لن تحدث "مجاعة قيامية" وفقًا لمازورة الشدة المستنصرية في زمن الفاطميين، ولكن المجاعة المعاصرة الحداثية تحدث بالفعل وبالتدريج وكل يوم.
الأمر ذاته صاحب التعامل مع وباء كوفيد، لأنه بشكل ما تم استدعاء تراث الجبرتي وابن إياس والمقريزي في ذكر الأوبئة، وكأن الجثث ستسد مجرى النيل أو تتراكم فوق بعضها في الشوارع. لم تتعفن الجثث في الشوارع لأن "قيامة الوباء" لم تقع وفقًا لشروط القرون الوسطى. ما قامت قيامته بالفعل هو عجز المنظومة الصحية وعدم قدرة الدولة على عمل خطة مكافحة تليق بدولة "قد الدنيا".
قامت القيامة بالفعل حين عجزنا عن حصر الأعداد الحقيقية للوفيات، وحين مات في صمت أكابر القوم وعامتهم جنبًا إلى جنب في المنازل خوفًا من "بهدلة المستشفيات"، وعندما كانت مصر من أقل البلدان توفيرًا للمسحات والاختبارات بشكل جعلها سلعة نادرة وبيزنس جشعًا وحقيرًا، وهي التي ظلت خدمة متوفرة مجانًا في أغلب دول العالم، ليتحول الوباء في مصر إلى شبح حاضر وعار يتم إنكاره في الوقت نفسه، مما ضاعف من وقعه الذي جاوز قسوة الموت ذاته. لقد وقع الأسوأ بالفعل لأنه لم يكن في الإمكان وقوع ما هو أسوأ منه بمعايير القرن الحادي والعشرين.
منذ 140 سنة خاطب زعيمنا الوطني العظيم عبد الله النديم أجدادنا في يأس مقيم منهم قائلًا لهم "يا معشر المصريين لقد نشأتم في الاستعباد وربيتم في حجر الاستبداد، لعن الله من يكره الحرية". ومنذ ما يقارب المائة عام، وبينما كان أنطونيو جرامشي يعلِّمنا أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل إلا بقدر مشاركتنا في صنعه، كان فرانكلين روزفلت يعلن للشعب الأمريكي في أعقاب الكساد الكبير بأنه ليس هناك ما يخيف أكثر من الخوف نفسه.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.