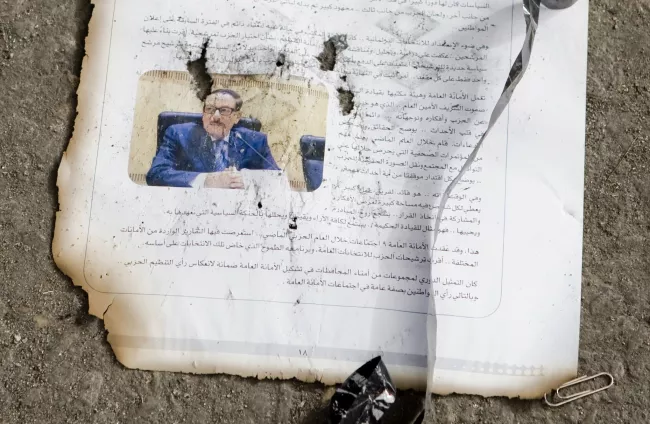ما لم يروِه زياد العليمي| نحن والجموع
تناولت في المقال السابق بعض جوانب منهج ولغة زياد العليمي بمراجعاته المنشورة في المنصة. ومن بينها حديثه من موقع الفاعل الأصيل، والإشكاليات التي يثيرها استخدام صيغة الجمع في الحديث، ووضعُ كلِّ من له علاقة بثورة يناير؛ من موقع المشاركة أو العداء، داخل "نحن" واحدة، ثم سؤال الوصول للسلطة والمشروع السياسي الفردي، كمدخل للوصول لما أراه أهم في تصوراته، وهو الاستبدالية.
الحنين إلى الينايريَن
يتحدث العليمي في مراجعاته عن رفض الحنين لكلا الينايريَن، يناير 1977، ويناير 2011. وأتفق معه بدرجةٍ ما في أنَّ الحنين عائق أمام المراجعات الجادة للحظات الكبرى. لكنَّ المفارقة أنَّ زياد لم يتخلص من هذا الحنين، ومن اللغة الذاتية، التي تمزج بين الشخصي والسياسي في مراجعاته.
لا تلائم طريقة الكتابة التي تخلط الشخصي بالعام، بالرغم من انحيازي لها عندما تكون متاحة ومبررة، تقديم فاعلٍ أصيلٍ من ثورة يناير مراجعاته الفكرية والسياسية لأخطائها، وبضمير الجمع، ودون الدخول في عالم الكواليس الذي يعرفه، والذي انتظره العديد من قرائه.
يعود زياد في سلسلة مقالاته إلى ذلك الطفل الصغير الذي كانَهُ، وإلى أبويه المنتميين ليناير القديم، وأنَّ على هذا الطفل أن يصنع لاحقًا، أو يشارك في صنع، يناير جديد.
لكنَّ المقاربة بين الجيلين والينايرين، بمقاييس النجاح والفشل التي قدمها، تحمل عدة مشاكل، أهمها أنَّ الينايرين مختلفان تمامًا في طبيعة الهدف والمهمة ودرجة الاتساع والتأثير المجتمعي. فيناير القديم هبَّةُ اعتراضٍ على سياسات محددة، أما الجديد، فاشتعل لأن "الشعب يريد إسقاط النظام".
لم يكن الآباء وزملاؤهم قيادات يناير القديم ولم يصنعوه. بالطبع كانت للحدث مقدماته التي شاركا فيها، مع غيرهما، عبر الحراك العمالي والطلابي السابق عليه. لكنه كان أيضًا، وقبل أن يكون نتيجة تراكم جهود الحركة اليسارية الشبابية وقتها، نتيجةً للإرث الناصري الاجتماعي الذي كان ما زال باقيًا ومؤثرًا اجتماعيًا، وشكّل رد الفعل الرافض لسياسات السادات بكل رجعيتها ويمينيتها، وتناقضها مع سياسات عبد الناصر.
تفاعل جيل الآباء فورًا مع يناير القديم، لكن من الصعوبة أن تُنسب انتفاضة الفقراء العفوية في يناير 1977 إليهم، أو أن يُوصفوا بقياداتها مثلما يصف العليمي.
وهو ما يفرقها أيضًا عن يناير 2011 ودعوة الشباب، الذين سيشكِّلون لاحقًا ائتلاف شباب الثورة، للتظاهر ضد قمع الشرطة في يوم عيدها، واستجابة الجموع لهذه الدعوة مع تصاعدها وتضخمها، لا يجعلهم بالضرورة قياداتها، إن اعتبرناها حدثًا ممتدًا بعكس تصورات العليمي واختصاره لها في ثمانية عشر يومًا. بل إنهم مفجرو شرارتها الأخيرة بعد شرارات كثيرة متكررة ومتراكمة خلال سنوات طويلة من حكم مبارك.
وليعذرني زياد، يخيل إليَّ أنَّ هذه الكتابة الشخصانية المفعمة في بعض مواقعها بالحنين، والقيادة التي يورثها جيل الآباء للأبناء، حاضرة لتصبغ روحًا قدريةً على مهام جيله كقيادة، الذي "لم ينجح هذه المرة"، لكنه يبحث عن خطئه ليتجنبه وينجح في المرة القادمة.
تقودنا معضلة القيادة هذه إلى الاستبدالية، التي سأتناولها قبل الاقتراب من ملمح المرة القادمة وسؤال المستقبل.
أنا والملايين.. أنا بديلًا عن الملايين
"لم نرَ سوى صورة الملايين التي خرجت تدعم مساعينا من أجل الحرية".
تعبر هذه الجملة لزياد العليمي من المقال الثالث ضمن السلسلة عن جوهر المشكلة في مراجعاته؛ الاستبدالية والفصل.
الفصل المقصود هو بين النشطاء السياسيين والجموع، باعتبارهما كتلتين. والاستبدالية هي تصور النشطاء أنهم بديلٌ عن هذه الجموع، بعد أن انفصلوا عنها. وأنها، أي الجموع، إما تستجيب أو ترفض مطالب الناشط وشعاراته. وفي هذه الحالة الينايرية؛ خرجت الجموع إلى الشوارع بالملايين لدعم مساعي الناشط. وكأنَّ الحرية والخبز لم يُشكلا مطلب هذه الملايين الثابت، وكأنَّ دور الناشط لا ينحصر في محاولة تنظيمها وبلورة مطالبها، الأصيلة، في صيغ وسياسات محددة، حين تقرر هي النزول.
مساعي العيش الكريم والحرية والعدالة، بكل أنواعها، هي مساعي الشعب المصري منذ عقود طويلة، وتكاد تكون همه الأساسي طيلة تاريخه، من قبل أن يدركها الناشط، لا العكس. بل إنَّ الناشط يصبح ناشطًا، وربما مناضلًا، عندما يدرك في لحظة معينة مساعي شعبه، أو مساعي القطاعات الاجتماعية المهموم بها. وهذه القطاعات نفسها هي التي تُحمِّل بعض أجيالها المتتالية مهام بلورة ما تعرفه جيدًا في صيغة مشروع سياسي. ولا تُحمِّل أجيالًا أخرى بأي شيء.
المشكلة في تصورات العليمي الفكرية، وغيره كثير من النشطاء، أنهم يرون هذه الملايين كداعمٍ لهم أو لمساعيهم. وهو مقتل مؤكد لمشاريعهم في التغيير، التي يفترض أن تتأسس على رؤية يكون فيها دورهم محصورًا في المشاركة بتشكيل تنظيمات ولجان ونقابات وأحزاب هذه الملايين، لتُمسك هي بالسلطة كفاعل أساسي وأصيل.
يرفض زياد الاستبداد بصدقٍ لا أشكك فيه. وهذا الصدق هو دافعي للاشتباك مع مراجعاته. يتبنى أفكارًا ديمقراطيةً واضحةً. لكنها من نوع الديمقراطية البرلمانية المحدودة، التي ترى السياسي الفرد مفصولًا عن الملايين، يحقق أحلامها التي يستطيع هو فقط صياغتها. وعليها أن تنتخبه في المواسم الانتخابية، أو تختار غيره من المنافسين.
وهو نموذج يقود للاستبداد الأنيق، حتى لو كان أوروبيًا أو أمريكيًا أكثر نعومة من نماذجنا الحاكمة. لأنه نموذج يستدعي الجموع في المواسم لتنتخب السياسيين المحترفين، في صيغ تضمن سيطرة الطبقات العليا على السلطة والدولة ورأس المال. فتحصر الديمقراطية في الممارسات البرلمانية، ومفاوضات على بعض الامتيازات هنا وهناك مع الفئات المتمردة في مواسم الاحتجاج.
جوهر المشكلة أنه لم يُسمح للقوى المشاركة في الثورة بممارسة الديمقراطية لتتعلمها
المفارقة الحارقة هنا، أنَّ ثورة يناير التي شارك العليمي في إشعالها، والثورات العربية الأخرى، وكل موجة الاحتجاج في البحر المتوسط عام 2011، وصولًا لاحتلال وول ستريت، وبعض الحركات الاحتجاجية في أمريكا اللاتينية، هي ما كشفت زيف واستبداد هذا النموذج الديمقراطي البرلماني المُعتمَد نموذجًا أمثلَ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهي التي دفعت أغلب الطامحين في التغيير الحقيقي في العالم حاليًا للبحث عن نماذج بديلة، في رفضٍ واضحٍ لنموذج السياسي الذي يدعي المعرفة بمصالح الجموع، وإن كان يساريًا آتيًا من حركات الاحتجاج، وينزعج من الفوضى ولا يرى أبدًا أنَّ الوقت مناسبٌ لاحتلال الشوارع والميادين، مقدمًا نفسه للملايين، لتختاره من بين منافسيه كل أربعة أو خمسة أعوام.
يبدأ العليمي مقاله الأخير بما يوضح بجلاء تصوره الانفصالي/الاستبدالي الخطر؛ "بعد انضمام الملايين إلى مطالبك في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية..."!! مرة أخرى تبدو هذه المطالب وكأنها مطالب النشطاء، وليست مطالب الجماهير/الملايين نفسها، التي يعي بها كلُّ فردٍ منذ ميلاده، ويفتقدها في كل تفاصيل يومه، وإن لم يصُغها في شعارات مقفَّاة.
التمثيل المشرف
في أحد الأيام قبل أن يخلع المجلس العسكري مبارك، وخلال حوار ضم في ميدان التحرير مجموعةً من الأشخاص مع يساريٍّ منتمٍ لائتلاف شباب الثورة، حول ضرورة توسيع الائتلاف ليصبح جبهةً حقيقيةً لها أساس اجتماعي واسع، قال لنا هذا العضو إنهم وسّعوه في صباح هذا اليوم نفسه، بأن ضربوا عصفوري النقص بحجرٍ واحدٍ؛ لم يكن لديهم نساء ومسيحيون، فاختاروا شابة مسيحية لعضوية الائتلاف.
يشير زياد لهذا الاختيار، أو الضم، في مراجعاته دون تفاصيل. لكنَّ السؤال الذي ربما يتبادر للذهن من نقده لفكرة التمثيل المشرف، وهو نقد أراه صائبًا، هو: لماذا هذه المرأة المسيحية بالذات؟ الإجابة سهلة، فأعضاء الائتلاف اختاروها لمجرد أنهم يعرفونها من مشاركاتهم سويًا في مظاهرات حركة كفاية ورفض التوريث.
الهوية الجندرية، وليس الوعي الجندري النسوي، والهوية الدينية المسجلة في البطاقة، وليس التعبير عن قطاعات من المسيحيين والقدرة على التأثير فيها، هي مبررات الاختيار.
لكنَّ المشكلة أكبر من كونها إجرائية تتعلق بتوسيع الائتلاف، ولن تحلها كلماتي أو كلمات زياد، ولن يحلها كذلك مجرد التسليم بأننا لم نتعلم الديمقراطية مثلما يقول. بل نستطيع فهم جوهرها من حقيقة أنه لم يُسمح لأي من القوى المشاركة في الثورة منذ لحظة اشتعالها أن تمارس الديمقراطية لتتعلمها، سواء كانت من النوع البرلماني المحدود، أو من أي أنواع أخرى، بعد أن لعبت المخاطر الأمنية دورًا أساسيًا في غياب الإمكانية، وأضيف لها مسلسل المذابح الصغيرة والكبيرة، والمعارك الحقيقية والوهمية، التي استنزفت الكثيرين فيها.
ولد ائتلاف شباب الثورة نخبويًا بطبيعته؛ مجموعة من الشباب التي تمثل قوى سياسيةً مختلفةً، معزولةً، باستثناء قوة وحيدة كان لها حضور اجتماعي وسياسي وجماهيري عشية الثورة، وهي جماعة الإخوان المسلمين. فإن كان الائتلاف نخبويًا، ولم يُسمَح لأعضائه بممارسات ديمقراطية تحت وطأة الأحداث السريعة المتلاحقة، والصراعات، والتخريب، وفلول البلطجية، والاعتقالات، والرصاص والقتل، والتحرشات الجماعية بالنساء في محيط الاحتجاجات، فلا بدَّ أن يكون توسيعه نخبويًا.
نعرف فلانة ونثق بها، وهي مسيحية، فلنضمها ليقال عن الائتلاف إنه يمثل قطاعات اجتماعية مختلفة. بينما هو فعلًا، حسب تعبير زياد، تمثيل مشرّف لا علاقة له بالواقع أو بالمجتمع. والاستبدالية هنا مفروضة وليست اختيارًا أو خطأً.
تراجع المستقبل
يناقش العليمي أحد أخطاء المنتمين للثورة، ضاربًا المثل بالحزب الوطني، الذي كان ينتمي إليه حسبما يقول مليون و900 ألف مواطن عشية يناير. فيؤكد على أن هناك أفرادًا "حاولوا تغيير الحزب من الداخل لتطوير مؤسسات الدولة". وأن النبذ الذي تعرض إليه هؤلاء هو أحد أخطاء معسكر يناير.
لكنَّ مشروع يناير لم يكن لتطوير حزب أو مؤسسات الدولة. بل إن السؤال الجوهري، الذي لم يستطع معسكر يناير بكل تنويعاته، أن يقترب منه مجبرًا، كان تغيير شكل هذه الدولة نفسها بكل مؤسساتها جذريًا، والسيطرة عليها من قبل الطبقات والفئات الاجتماعية التي صنعت يناير، وصاحبة المصلحة في أن تشتعل الثورة.
بل إنه يصل للقول "أصبح النبذ، ومحاولات العزل، باسم الحرية وحقوق الشعب المقهور، لعقود طويلة، جزءًا من خطاب القطاع الأوسع ممن انتموا للثورة. وهكذا، باسم الحرية جرى تكميم أفواه أعداء الحرية!".
تفرض هذه الصياغات أسئلة حول طبيعة يناير والهدف منه، أو المشروع الذي طمحت إليه الجموع وقتها، وليس الـ"نحن" الشهيرة. فيقع العليمي في مغالطة تاريخية، تدفعه إليها على الأغلب هذه الروح الطوباوية، التي سبق وأشرت إليها، والرغبة في نقد الذات وفتح الحوار، وأخيرًا الضعف الذي وصلت إليه القوى الديمقراطية للدرجة التي تجعلها تتصور بعد يناير بثلاثة عشر عامًا، أنَّ هدف الثورة كان تطوير مؤسسات الدولة.
"باسم الحرية جرى تكميم أفواه أعداء الحرية!"، أيُّ أفواهٍ كُمِّمت؟! أغلب الوقائع المتتالية خلال شهور طويلة لم تتضمن سوى قمع ومنع المنتمين للثورة ودعاة الحرية من التعبير أو الوصول لمنابر التأثير فعلًا. وإن كان بعضهم/بعضنا ظهر في بضعة برامج تليفزيونية، فلا يعني ذلك أنَّ أعداء الحرية كُممت أفواههم. فأعداء الحرية هؤلاء، من سُمّوا بالفلول، والأجهزة الأمنية المتنوعة، ورجال الأعمال، ظلوا متحكمين في كلِّ المنابر ووسائل الإعلام. يديرونها ضد يناير، حتى وإن وضعوا كاميرا ثابتة من شرفة عالية للبث المباشر ليلًا. هذا التضييق على "أعداء الحرية"، الذي لم يحدث، كان ضروريًا ومبررًا، وحدث في كل التجارب الثورية.
تصور زياد النقدي المتعلق بالحرية، الذي يوحي بأنَّ أبناء يناير وقعوا في فخ الاستبداد وتكميم الأفواه، هو ما يكشف عن مشكلة تقديمه لأسئلة المستقبل. يطرحها في صيغة تصور مختصر أقل ما يقال عنه إنه شديد التواضع، مثلما طرح مهام يناير بتواضع، ويختصرها في تطوير مؤسسات الدولة.
يتحدث عن مصر الأكبر من الجميع، صاحبة التنوع الثقافي والاجتماعي والعرقي والديني، الذي يراه "سمةً مصريةً"، وهذا غير صحيح، لأن التنوع والتعدد سمتان في كثير من بلاد العالم، إن لم يكن أغلبها، فيكتفي بالقول إن علينا أن نجد مشروع "نهضة ذات طابع مصري خالص"، دون أن يطرح أيَّ ملامح لتلك النهضة وذلك المشروع.
سؤال الماضي الذي لا يزال صالحًا ومُلحًّا ليجيب عنه جيل زياد، يظل كما هو: كيف تصوروا أنَّ بوجودهم، بمجرد وجودهم دون الاستيلاء على السلطة، ستُطبق السياسات التي يرغبون فيها؟! وكيف لم ينتبهوا إلى أنَّ القليل من السياسات الإيجابية التي تحققت في سنتي الثورة جاءت من خارجهم، من النضالات التي سُمِّيت، لتجريمها، بـ"الفئوية"، وكانت في أغلبها نضالات جماعية وطبقية؟!
ومثلما كان سؤال السلطة حاضرًا أيام يناير 2011، ولم يُجب أحدٌ عنه، تعرف الأجيال الجديدة التي لم تعش يناير، أنَّ حياتها أكثر بؤسًا بما لا يقارن بحياة كلِّ الأجيال التي سبقتها، بما فيها جيل زياد. لذلك، فإنها هي من ستطرح مشاريع المستقبل، وتعيد صياغة أسئلة السلطة.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.