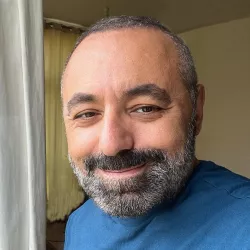خلاصات واستخلاصات عن الذين صعدوا إلى "الطبقة" والذين هبطوا منها
أردت في هذه السلسة، التي امتدت إلى سبعة مقالات، توضيح أن جانبًا لا بأس به من إشكالنا المعاصر يتعدى الأزمة السياسية الممتدة منذ عقد كامل، بل يؤسس لها. فالوعي بالموقع الاجتماعي هو ما يحدد المصلحة والدوافع التي تتأسس عليها الخطابات والميول، وأغلب الخطابات السياسية في مصر تتفنن في الهروب من سؤال تعيين المواقع والمصالح الاجتماعية ومسؤولياتها المتبادلة.
وتنحى تلك الخطابات السياسية إلى الحديث إما باسم الشعب كافةً أو الغوص في الهويات ومكوناتها والصراع على أيها أولى بالتبني. ويحدث ذلك إما عن قصد ونية وإرادة لخدمة الموقع الاجتماعي صاحب الامتيازات غير المبررة أو المتوازنة، أو بسبب اضطراب الوعي بذلك الموقع من الأصل بالشكل الذي يحول دون تكوين رؤى سياسية ممكنة من داخله.
وبالتالي تتحول الخطابات السياسية المتولدة من داخل تلك المواقع الاجتماعية إلى محض مصفوفات مثالية من الشعارات، أو تتحول في مراحل أكثر تأزمًا إلى مقولات عصابية تفتقر إلى الحد الأدنى من المنطق والتماسك.
وبما أن سلسلة المقالات تلك كانت موجهة بالأساس إلى قرّاء من أفندية الطبقة الوسطى وبعض من بكواتها وسيادييها، فالاستخلاصات التالية، في المقال الثامن والأخير، تخص مواقعهم وتصوراتهم هم بالذات.
أولًا: التعايش الملغوم بين مصر وEgypt لن يستمر دون ثمن
إن استمرار وجود قطاعات مُدولة ومحلية من الاقتصاد، تتجاور على الأرض نفسها، بما يترتب على ذلك من تأسيس لعوالم موازية بالكامل في البلد ذاته على مستوى جودة الخدمات والمفردات الاستهلاكية والمعايير المعيشية والتوقعات، سيفضي في النهاية إلى صراع أهلي شرس لا يمكن تخيل تجلياته. وهذه التجليات الصراعية ليس شرطًا أن تكون سياسية الطابع.
لا يحول حاليًا بين ظهور تجليات الصراع وانفلاته التام إلا قبضة أمنية شديدة الشراسة، تُرسي الأزمة وتعمّقها أكثر مما تساهم في حلها. نحن لا نتحدث عن مجتمع واحد فيه كتلة طافية وأخرى غاطسة تتفاوت بينهما مستويات الثروة والحظوة كما كان الحال في الماضي، بل عن مجتمعات متوازية، لا تتلاقى في أغلب تفاصيل حياتها ولا تتفاعل ولا توحدها رواية مشتركة، بل صارت تغترب عن بعضها لغويًا.
وفي الوقت نفسه، هي عوالم غير معزولة بالكامل عن بعضها البعض، فهي تشاهد استعراضاتها المتبادلة على السوشيال ميديا.
ثانيًا: ليست السعادة في المال
وربما حتى بصوت يوسف وهبي الميلودرامي في الأفلام القديمة. فالمواقع الاجتماعية التي اعتادت أن تنال الاحترام والتقدير المعنوي والروحي، صارت تفقد رأسمالها الرمزي بمتوالية واضحة، ولا يتبقى لها إلا قدرة محدودة على الاستهلاك، راحت تتآكل هي الأخرى تحت وطأة أزمات اقتصادية عالمية ومحلية.
الضربات الاقتصادية والمعيشية الحالية ليست السبب في انهيار المكانة الاجتماعية لتلك الفئات، بل تآكل رأسمالها الرمزي هو ما أسس، ثم أفضى، إلى وقوع تلك الضربات من الأصل. وهو ما يمكن تسميته بمسار التفريط المدني في مكتسباته الوطنية التاريخية منذ يوليو/تموز 2013.
ثالثًا: لا نجاة فردية في وضع عالمي تتأزم مراكزه الاقتصادية قبل أطرافه
صحيح أنه قبل 12 سنة اندلعت في مصر ثورة شعبية حاولت طرح تصورات أكثر تقدمًا للعيش المشترك القائم على مبادئ أكثر عدالة ومواطنية، لكن هزيمة تلك الثورة، واضطهاد واجتثاث أغلب من انخرطوا فيها، دفع الكثيرين إلى الاعتقاد في وجود إمكانية للنجاة الفردية، سواء بالتطبيع مع الوضع القائم داخليًا، أو بمحاولة صنع بداية جديدة خارج البلاد.
الخبر السيئ هنا أن ذلك الخيار غير ممكن وضعيف الجدوى. فالأسباب المادية والموضوعية التي اندلعت من داخلها ثورة 2011 مازالت قائمة، بل وتتفاقم. بعض منها أسباب عالمية رافقت الإنهيار المالي الدولي عام 2008، والثورة المصرية قامت في الأصل تحت وطأة تلك الأسباب فكانت اضطرارًا وليست اختيارًا.
أسميته ذلك في كتابي تاريخ العصامية والجربعة بأزمة إعادة التأسيس الاجتماعي والسياسي، التي جاءت ثورة يناير كإعلان تاريخي عن انفجارها، مجرد إعلان، وما زالت الشروط والأسباب قائمة، بل ازدادت عمقًا وارتباكًا، وزاد عليها تأزم الوضع الاقتصادي العالمي من دون قدرة محلية على قراءته والتعامل معه.
رابعًا: على البرجوازية المصرية أن تتخلص من "جربعتها"
إن لم تتخلص البرجوازية المصرية من جربعتها سينالها من الاجتثاث ما نالها في أطوار سابقة في التاريخ الوطني الحديث، لأن الوعي الذي يتملكها تختلط فيه المظلومية بالاستحقاق إلى درجة العمى التام. فتظن أن حضورها ونشاطها في وسط مجتمع فقير ومتخلف مكرمة منها عليه. وهي غير مستعدة لتقديم تنازلات لذلك المجتمع الواسع، وترى فيه خطرًا. بل مستعدة طوال الوقت إلى تقديم كل التنازلات إلى السلطة التي تحميها من المجتمع الأوسع.
هذه الصيغة أفضت إلى تجريد البرجوازية المصرية من "لياقتها" الطبقية، ومن إمكانية ريادتها الكامنة. وحرمت الطبقات الوسطى من امتلاك أدوات التأثير والتطور في ظل استنكافها عن تقديم أشكال الدعم السياسي والفني والتقني والخطابي لحركتها ونشاطاتها. واعتبرت أن الربح والتراكم الرأسمالي وحدهما علة وغاية وجودها. ولا شك أن حصاد ذلك كان ولا يزال مريرًا وملموسًا ولا يحتاج إلى ضرب أمثلة.
خامسًا: على الدولة أن تتوقف عن الاستثمار في إضعاف المجتمع
على الدولة أن تتوقف عن تهشيم التنظيمات الاجتماعية باسم الحفاظ على النظام العام. لأن وضع المجتمع عدوّا للدولة ومجرمًا مشتبهًا فيه طوال الوقت، سيسيّد تلك العلاقة ويجعل منها وضعًا طبيعيًا. وهو ما سيفضي في النهاية إلى دمار الدولة فعلًا، فالدولة مهما سادت ستظل موضوع لمجتمعها ومرآة له، مهما امتلكت من بأس وشدة وقبضة.
والتنظيمات الاجتماعية عندما تتآكل وتتوقف عن التفاعل والتفاوض والبناء، فيما تعجز الدول في الوقت نفسه عن سد الفراغ الناتج عن ذلك، لن يبقى مع الوقت إلا القوة المحضة لأجهزة الدولة المسلحة، التي قد تتحول معها علاقة الدولة الوطنية بالمواطنين بالتدريج إلى ما يشبه العلاقة في ظل الاحتلال. الفارق في حالتنا أن العلاقة هي ارتهان متبادل، فالجميع مصريين لا مهرب لهم من بعضهم البعض، مما يزيد الوضع الملغوم إلغامًا ويشيع الخوف والقلق والشلل بين الجميع.
سادسًا: لا يمكن استمراء إشهار سيف السيادة في مواجهة الأسئلة الملحة
الطور الحالي من الدولة المصرية أدمن النظر إلى إثارة أي مسألة تتعلق بالإصلاحات الاجتماعية أو الحريات العامة على إنها أمر ماسٌّ بالسيادة الوطنية. وأمام كل صغيرة وكبيرة ستجد من يقول "إنهم يريدون تقسيم مصر إلى دويلات صغيرة".
وستفتح التليفزيون لتشاهد دراويش الخبرة الاستراتيجية وهم يشيرون إلى خرائط وهمية تقسم مصر إلى دول نوبية وقبطية وشمالية وجنوبية، وما إلى ذلك من اضطرابات ذهانية أو كذب أفاك، والاثنان سيّان على مستوى النتيجة.
إن اعتياد استخدام التخويف بضياع وحدة البلاد عند كل مسألة أو محطة قد يُفقد معنى السيادة الوطنية احترامه ودلالاته الأخلاقية عند عامة الناس، التي هي في الأصل سيادة على الموارد والثروات وإدراتها المعطوفة على سيادة القرار والمصير بالشكل الذي يجعل حياة الناس أكثر كرامة واحترامًا وسعادة وتقدمًا.
ختامًا
لا يمكن أبدًا غض البصر عن انخفاض أسقف التوقعات العامة، التي يرافقها حالة من القنوط والاستسلام للسقوط الحر. بدأت تلك الحالة تتجلى عيانًا منذ خريف 2019 مع ما سمي وقتها بـ"فتنة المقاول محمد علي"، التي أسست لطور جديد من تعامل الدولة مع المواطنين يفترض في كل مواطن يسير على قدميه في الشارع عدوًا محتملًا. وأصبحت الدولة لا تتورع عن انتهاك أدق خصوصياتهم في المجال العام محطمة الحدود الدنيا من اللياقة التي تربط الدول الوطنية، حتى الاستبدادية منها، بمواطنيها.
في ظل هذا الوضع العدائي زحف وباء كوفيد-19 على البلاد، وأطاح بالأرواح عابرًا للطبقات والحيثيات، من دون القدرة على التعامل مع تحديه الثقيل تعاملًا وطنيًا اجتماعيًا شاملًا. مما عزز الإحساس باليأس والضآلة وقلة الحيلة لدى القطاع الأوسع من الناس.
لا شك أن هناك تراكمات متتابعة من الشعور بالإخفاق وسيادة القمع وتسارع الانهيارات الاقتصادية والخوف من المردودات الاجتماعية لتلك الانهيارات. وهو الأمر الذي يُشعِر الكثيرين بعدم الجدوى، والرضاء بالأمر الواقع باعتباره أحسن مما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال تحريكها.
لكن التاريخ يعلمنا دائمًا أن أي استحقاق، أيًا كان، يجب وأن تتم مواجهته، وأن لكل استحقاق تكاليفه، وأن تجنب دفع تكاليفه في لحظات معينة سيعني دفعها أضعافًا مضاعفة في لحظات لاحقة. والكرة في ملعب من في يده السلاح على أية حال.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.