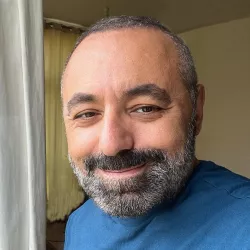الموقع الاجتماعي غير المحترم لحضرة الأفندي المحترم
عن الذين صعدوا إلى "الطبقة" والذين هبطوا منها
في أول مقالات هذه السلسة أشرت إلى مركزية مفهوم رأس المال الرمزي عند بيير بورديو وإسهامه فى تعيين المواقع الاجتماعية للأفراد والجماعات. لكن ماذا لو استخدمنا لفظًا أكثر عامية وشيوعًا في لغتنا اليومية؛ الاحترام؟ بأي قدر يساهم الاحترام في تحديد مواقعنا الاجتماعية، سواء بالتجاور أو التراكم، مع مستويات الدخول والنفاذ إلى السلطات وقوة الملكية؟
قبل أن يتهمني البعض بالتعميم الأخلاقوي بسبب استخدام لفظ "الاحترام"، الذي ربما يحمل مدلولات غامضة، علينا أولًا تَذَكُّر اللحظة التي يسألنا فيها ضابط شرطة في الشارع عن كينونتنا وبياناتنا، بنبره تحمل قدرًا لا بأس به من الغلظة والصرامة والاستهانة. في بعض الأحوال، وبعد تبادل عدد من الجمل معه، سيغير الضابط نبرة حديثه، مرددًا المقولة التصالحية المعتادة "واضح إنك إنسان محترم وابن ناس".
الأصل بين الناس إذن أنهم غير محترمين وليسوا من أبناء "الناس". تحتاج السلطة إلى عملية فرز سريع ولماح لتعيين أبناء الناس من بين أبناء "اللا ناس" كي تعطيهم صك "الاحترام". فنحن لدنيا في اللغة العربية لفظ اسمه "الحيثية"، ومنه يُشتق لفظ ذوي الحيثية، الذين يأتي منهم أولاد الناس.
المساواة في مصر لا تزال محل سؤال ونقاش وجدل من حيث المبدأ
وحين نستفسر عن مكانة شخص ما نسأل عن حيثيته. والحيثية هي الأسباب والعلل والاعتبارات، أي أن هناك بشرًا لا اعتبار أو علة لوجودهم من الأصل، وأن قلة فقط من الناس تستحق سببًا وقيمةً لوجودهم.
لا عجب في ذلك، والمساواة في مصر لا تزال محل سؤال ونقاش وجدل من حيث المبدأ، وليس على مستوى الممارسة. فهي ليست أمرًا بديهيًا محسومًا، بل ما زالت منحة ومكرمة من أصحاب القوة. ولو كانت المساواة مُقرَّة فهي على الأغلب مشروطة بشرط ما، سواء على مستوى علاقة الرجل بالمرأة، المسلم بالمسيحي، وقبلهم ذوي الحيثية من أبناء الناس بأبناء اللا ناس.
نعلم جيدًا، ومن البداية، أن أي مساواة مشروطة هي ليست بمساواة. لكنَّ نهر الإنكار يجري في مصر مجاورًا لنهر النيل. لذا حين اشتدت شمس الحقيقة فوق الرؤوس، طلَّ علينا أحد وزراء العدل في بداية الزمن العسكري ليقول إن ابن الزبال لا يمكن أن يصبح قاضيًا، ليعلن ضمنًا أن الجمهورية الجديدة ليست جمهورية.
صحيح أن الوزير استقال بعدها مما عدّه البعض انتصارًا لمفهوم "الشعب"، إلا أنه عوقب فيما يبدو على البوح بما لا يجب البوح به، لأن ما قاله صرنا نعيشه لاحقًا واقعًا يوميًا، لا كأبناء زبالين لكن كأفندية.
من أين تأتي بواعث الاحترام؟
يعي أفراد المجتمعات الأكثر تحديثًا إرادتهم المشتركة في العيش معًا. ينال قطاع من الناس احترامهم بقدر إدراك الآخرين لحيوية وظائفهم ومحورية إسهامهم على المستوى العام. صحيح أن اﻷسلحة والقوة والأموال والقداسة الدينية تظل هي الأساس في اكتساب الاحترام، القسري وغير الطوعي في الأغلب، إلا أن التحديث أسهم في بلورة التقدير للأدوار الوظيفية التي تُسهم في جعل المجتمع في المجمل أكثر تقدمًا ورخاءً وسعادة.
وبقدر أداء هذه الأدوار والوظائف على نحو منتظم وفعّال يحصل المؤدون لها على مكانتهم الاجتماعية. ولو كانت هذه الأدوار والوظائف نادرة أو لا يمكن الاستعاضة عنها بسهولة لأنها تحتاج إلى قدر متراكم من المعرفة المدققة أو التدريب المتميز، فإن أصحابها يرتقون إلى مقامات أرفع. لهذا احترمت مصر الحديثة الأطباء والمهندسين وأصحاب المعارف التقنية، وفي أطوار أكثر تقدمًا زاد تقديرها للفنون والآداب وللإنتاج الرمزي عمومًا.
ومع ترسخ هذا الوعي واعتياد العيش داخله، أصبح احترام المهن مرتبطًا بمستوى إجادتها أو الوفاء بمتطلباتها المجتمعية والعكس صحيح. تصبح المهن أو المؤسسات أقل احترامًا إذا كفت عن لعب الدور المنوط بيها أو تقديم الخدمة الواجبة عليها بشكل أقل كفاءة. يمكن للشرطة مثلًا أن تظل جهازًا قويًا ومهابًا بقوة تنظيمها المسلح، لكن لو شاعت الجريمة وسادت ستصبح غير ذات معنى، أو ربما أصبحت مع الوقت جزءًا من شبكات الجريمة نفسها فى نظر الناس.
إذا انحط مستوى الخدمات التعليمية سينخفض معها قيمة المعلم واحترام مكانته الاجتماعية
ينطبق هذا أيضًا على الجيش الوطني، سيفقد معنى وجوده إذا فقدت الدولة سيادتها على أراضيها أو مواردها أو استقلال قرارها وإرادتها. لم يحتمل الشعب المصرى وجيشه هزيمة 1967، وفى أول ظهور له خلال حرب 1973 استهل أنور السادات خطابه بأن الشعب استعاد اليوم ثقته فى قواته المسلحة. فالجيش حتى ولو احتفظ بكامل سلاحه وعتاده دون أن يكون قادرًا على حماية السيادة الوطنية، يصبح جيشا وكيلًا لاستعمار ما.
وبالمثل، إذا انحط مستوى الخدمات التعليمية ستنخفض معها قيمة المعلم، ليس أجره فقط أو دخله، بل احترام مكانته الاجتماعية أيضًا، وهذا ما يحدث بوتيرة ثابتة في العقود الأخيرة. وينطبق الأمر نفسه على مهنة المحاماة التى كانت مهنة مركزية وحيوية في النصف الأول من القرن العشرين وقتما كان القانون أكثر سيادة وجهاز العدالة أكثر فاعلية. وكانت كليات الحقوق مفرخة للساسة والقادة و"ذوي الحيثية" من المهنيين.
لذلك كانت كلية الحقوق من كليات القمة، يحتاج الطالب أن يكون متفوقًا كي يلتحق بها. بالتأكيد هذا ليس الوضع الآن. ولذا يكتسب جهاز العدالة مكانته الحالية من مواقع القوة والقدرة على البطش وليس من اسمه المفترض.
لكن الأمر لا يقتصر فقط على أداء الوظائف المادية بفاعلية، بل يمتد أيضًا لمدى اتساق سلوك صاحب الوظيفة مع المكانة المعنوية المرتبطة بوظيفته. يحترم المصريون رجال الدين ويهابونهم، لكن الثقافة الشعبية مليئة بمسميات مثل "الشيخ قرد" طالما وجد الناس سلوك رجال الدين بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب من الأخلاق والتقوى، مهما توعد هؤلاء المشايخ الناس وهددوهم بالقول أن لحوم العلماء مسمومة.
المثقف الذي يفقد اتساقه يتحول في نظر السلطة والناس على السواء إلى بوق دعاية ووسيلة استخدام، وما أكثر هذا الحضور الآن. فالمثقف الذي يتخلى عن حسه النقدي والحد الأدنى من الشجاعة والاستقلال ينحط إلى مصاف العوام ويبخس سعره في سوق الكلام والمعاني.
الأواني الاجتماعية المستطرقة
تصبح الأمور أكثر مأساوية إذا انحطت المكانة المادية والمعنوية للوظيفة في سياقات متزامنة. الأطباء هم درة الاحترام الوظيفي في مصر. مهنة الطبيب هي إجابة كثير من الأطفال عن سؤال كيف ترى نفسك فى المستقبل. وفى العشرة أعوام الماضية ناضل الأطباء من أجل تحسين أحوالهم المعيشية ورفع كفاءة النظام الصحي وتحسين خدماته. كل العناصر كانت وما زالت في غير صالحهم؛ الأجور والإمكانيات وقلة تقدير المجتمع الناتجة عن سوء الخدمات الطبية، والذى وصل إلى حد تكرار الاعتداء عليهم في المستشفيات جراء الإحباط المتزايد من سوء حالة المرافق الصحية.
كان ذلك هو المستوى المادي الفج لتدهور حال المهنة. لكن تزامنت معه أيضًا إشارة أخرى أكثر رمزية ومعنوية، تجلت فى إعلان القوات المسلحة عن ظهور جهاز علاج الإيدز والكبد الوبائي الشهير بجهاز الكفتة، لصاحبه فني المعامل اللواء مكلف إبراهيم عبد العاطي.
كان شعار البعض هو الحفاظ على مدنية الدولة فإذا بهم يهدمون أسس الحداثة المصرية
في هذه اللحظة بالذات تم وضع احترام مهنة الطب على المحك. خاصة أن بعض كبار الأطباء راحوا يبشرون بهذا الدجل الفج والكذب القراح، وهاجم بعضهم وبشراسة من يشكك فيه. والأنكى من ذلك أن قامات طبية كبيرة في مصر صمتت أمام حملة الدعاية لجهاز الكفتة المشؤم فصغرت قامتها وانخفضت هامتها بالصمت المخزي، على الرغم من أن بعضهم كانوا من مشاهير الشأن العام.
في رحلة جهاز الكفتة تم تخيير قطاعات واسعة من الأطباء، بين دعم قواتهم المسلحة بالصمت وعدم إحراجها باسم الجبهة الوطنية التي تحارب الإرهاب من جهة، والتضحية باحترام العلم في أبسط قواعده، ومن ثم احترام مهنة الطب نفسها من جهة أخرى.
كان شعار البعض هو الحفاظ على مدنية الدولة فإذا بهم يهدمون أسس الحداثة المصرية نفسها. بالطبع لم يكن جهاز عبد العاطي هو ما هشم مكانة الأطباء المصريين إلى الحدود التي جعلت نسبة معتبرة منهم تغادر مصر وتعمل خارج البلاد، بل كانت مجرد إثبات لصحة مكانة رأس المال الرمزي لهذه المهنة، الذى يتأسس في المقام الأول على احترام العلم والبحث العلمي.
ما حدث مع الأطباء في علاقته بجهاز الكفتة حدث بشكل أكثر رمزية مع ساسة مصريين ورموز من "ذوي الحيثية". منذ أسابيع وجدنا وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014 عمرو موسى، يقف في تجمع احتجاجي خجول في حي الزمالك يطالب بعدم دعس أشجار كورنيش النيل هناك.
كان التجمع خافتًا غير مهم، ولم يترتب على حضور موسى المهيب فيه أي شيء، وسار كل شيء كما خُطط له من قِبل الجهات الإدارية. تحول سكان الزمالك إلى أهالي الزمالك، لأنه عندما يصبح العبث بدستور كُتِب في سياق وأجواء غير دستورية بالمرة معتادًا، ستُدعس الأشجار الموجودة في محيط سكن رئيس اللجنة التي وضعته.
المعادلة بسيطة جدًا جدًا؛ الفئات الاجتماعية التي تفقد احترامها وفقًا للمعايير المصرية، تلك المعايير التي لا يحصل على الاحترام من داخلها إلا القلة القليلة، يمكن لها أن تفقد رساميلها ومدخراتها وملكياتها الخاصة أيضًا.
الأمر بسيط، بل أبسط مما يتخيل الكثيرون.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.