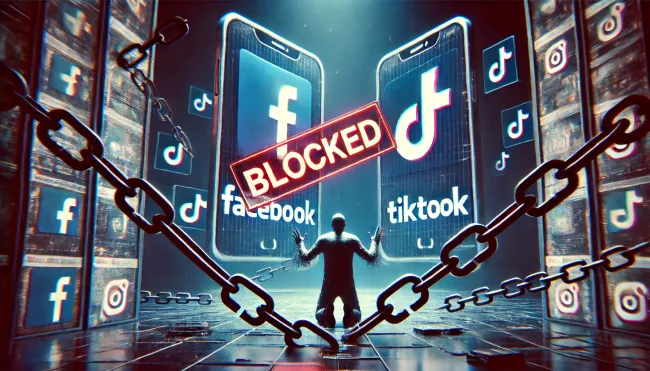اضرب التيكتوكر يخاف المشاهد.. دروس في ترويض الجماهير
على مدار أسبوعين، لم توقف وزارة الداخلية حملتها للقبض على صُنّاع محتوى تيك توك بتهم تتراوح ما بين نشر فيديوهات تحوي ألفاظًا ومشاهد خادشة للحياء، والتحريض على سلوكيات منافية لقيم الأسرة المصرية، وتحقيق أرباح غير مشروعة عبر البث المباشر.
كالنار في الهشيم، انتشرت صور التيك توكرز سريعًا على السوشيال ميديا، وتنافس التوك شو في إدانتهم، وتصدّرت "القيم المجتمعية" عناوين الصحف كأنها انتصرت في حرب ضروس.
التقط الإعلام الحدث، كعادته، وحوّله إلى "محكمة شعبية يومية"؛ لكنَّ أسئلةً لم تُطرح مثل هل هناك جريمة أصلًا؟ من يحدد حدود "القيم المجتمعية"؟ هل تستوجب مثل هذه الممارسات الحبس؟ وحل محلها سؤال واحد "إزاي الناس دي فلتت لحد دلوقتي؟".
وفقًا لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن هذه "العدالة" لا تُبنى على أساس قانوني صلب بل على اتهامات فضفاضة مثل "التعدي على قيم الأسرة"، التي جرى توظيفها ضد أكثر من 151 شخصًا في 5 سنوات، أغلبهم من النساء والطبقات الفقيرة.
الإعلام سُلطة تأديب أخلاقي
منذ سنوات، وفي ظل غياب الصحافة الحرة، وتلاشي مساحات النقد الجاد في الإعلام المصري، اتجهت الدولة لتوظيف المنصات الإعلامية في معركة من نوع آخر، وهي ضبط سلوك المواطن، لا مراقبة السلطة. لم تعد "الأخلاق" منظومة قيم اجتماعية، بل فُرّغت من محتواها وتحولت أداة سياسية وسلاحًا يُشهر في وجه كل من هو مختلف، أو هامشي، أو ضعيف.
لأن الحديث عن الفساد أو القمع السياسي "خط أحمر"، توجّب صنع أعداء آخرين؛ فتاة ترقص أو تتحدث بلغة بيئتها، شاب يصنع ثروة من تيك توك، حساب ساخر يتحدث بلهجة "شعبية".
هؤلاء هم الخطر الأكبر على البلاد وفقًا لخطاب إعلامي لا يتورع عن تصويرهم رموزًا للانهيار الأخلاقي، بينما يتجاهل انهيارات أعمق تطول الاقتصاد والقانون والعدالة. الإعلام هنا لا يفتح نقاشًا ولا ينقد، بل يتحوّل سُلطة تأديب تُصدر أحكامًا أخلاقية، وتطالب الدولة بتنفيذها فورًا.
الأكثر إيلامًا من القبض على صناع المحتوى والخطاب الإعلامي المصاحب له، رد فعل جمهور واسع يحتفل، ويصفّق، بل ويطالب بالمزيد تحت شعار "خليها تنضف"، ما يثير تساؤلات عن معنى الابتهاج بقمع حرية فردية في مقابل التعايش مع قمع سياسي واجتماعي يومي؟ وهل الذين يصفقون ضحايا فعلًا أم شركاء في الاستبداد؟
ما يُفزع في ردود الفعل الشعبية على هذه الحملات ليس فقط تماهي البعض مع خطاب الدولة، بل اقتناعهم التام بأن ما جرى هو "عدالة ناجزة". اكتفى بمشاهدة عابرة وانضم إلى القافلة؛ "يستاهلوا"، "ده انحلال"، "اللي بيتربى في بيت محترم مبيعملش كده" و"إفساد الذوق العام" و"تدمير الشباب". كأن مقدمي هذا المحتوى ليس من حقهم حتى الحصول على محاكمة عادلة لا تُبنى على اللقطات المجتزأة.
الجملة إن قالتها امرأة فقيرة على تيك توك صارت انحلالًا أخلاقيًا وإن قالها ممثل في عمل درامي أصبحت إفيه الموسم
عُومل استخدام سوزي الأردنية عبارة مثل "آه... الشارع اللي وراه" في مقطع ساخر تتحدث فيه مع والدها باعتباره "خروجًا عن الأدب"، و"إساءة إلى قيم الأسرة". لكن اللافت أن العبارة نفسها تحوّلت إلى ترند متكرر في الأعمال الدرامية المصرية، ظهرت في 5 مسلسلات على الأقل دون أي اعتراض. على العكس، قُدمت مادة للضحك الخفيف والتهكم الشعبي. في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، قالها العترة لمربوحة، وفي فراولة قالتها سامية لـحسن الشندويلي، أما في خالد نور وولده نور خالد، فرددها كريم محمود عبد العزيز في مشهد ساخر مع شيكو، وفي لانش بوكس كذلك، وفي العتاولة قالها ابن مي كساب لصديقه في أولى حلقات المسلسل.
ما الفرق إذًا؟ الجملة واحدة، لكن إن قالتها امرأة فقيرة على تيك توك صارت انحلالًا أخلاقيًا، وإن قالها ممثل في عمل درامي أصبحت "إفيه الموسم". هذه هي المفارقة التي تكشف ازدواجية المعايير في ما يُجرَّم، ومن يُحاسَب، ولماذا.
لماذا يفرح الناس؟
السؤال الجوهري هنا لا يتعلق فقط بالسلطة، بل بالجمهور؛ لماذا ينتشي مواطن مقهور، مسحوق اقتصاديًا وسياسيًا، باعتقال فتاة بسيطة أو شاب مختلف؟
المواطن المحروم من العدالة، والمكبوت في حريته، لا يستطيع التعبير عن غضبه تجاه الدولة، فيُحوّل هذا الغضب إلى إسقاط عدواني على من هم أضعف منه.
في مجتمعات محافظة، تخلو من التربية على التفكير النقدي، تبنى صورة الذات الأخلاقية من خلال مقارنة سلبية مع الآخرين "أنا أحسن من البنت اللي بتلبس كده"،"أنا راجل ما بطلعش على التيك توك"،"أنا محافظ وبصلي"، حتى لو كنت مغموسًا في الظلم والنفاق. هذه الحاجة للتمايز الأخلاقي تولّد فرحة مبطنة عند سقوط من يُعرّي الازدواج الأخلاقي، فيسهل على الناس أن يروا في فيديو تيك توك تهديدًا.
هذا التفسير لا يكتمل دون إدراك أن التوحش لم يسكن النفوس فجأة. لم يستيقظ الناس ذات صباح ليصفقوا لسجن فتاة ترقص على تيك توك. إنما هو نتيجة تراكم طويل من القمع والمهانة أعاد تشكيل الوجدان العام، ليرى البعض في القسوة خلاصًا، وفي الشماتة استعادةً "للنظام".
"التدهور والانحطاط والتوحش ليست لحظات درامية، بل عمليات ومسارات تتسيد ببطء لو لم تُقاوم بوعيٍّ ومشروعٍ مضاد"، وفق توصيف محمد نعيم فالجماهير التي تحتفي بحبس التيك توكرز هي نفسها التي تتعايش مع الإذلال اليومي في المواصلات والمستشفيات ومكاتب الحكومة، حتى تطبّعت مع العنف، وتورطت فيه باعتباره آلية دفاع نفسي. وزي ما بيقول المثل: "كل شيء يشبه شيء، حتى الحمار وقانيه".
لماذا يكرهون "تيك توكرز"؟
في معرض تبرير القبض على صناع محتوى تيك توك، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن بعض هؤلاء الفلوجرز يحققون أرباحًا طائلة، مشيرًا إلى أن أحد المتهمين يجني ما يصل إلى 70 ألف دولار شهريًا. هذا الرقم تداوله الخطاب العام رمزًا للاستفزاز المجتمعي؛ كيف لشاب أو فتاة، دون تعليم مرموق أو وظيفة تقليدية أن يحقق هذا الدخل، بينما يعاني الملايين من خريجي الجامعات من البطالة أو يتقاضون أجورًا زهيدة؟
يشيع في تعليقات كثير من المصريين على قضايا التيك توك اتهام هذه النماذج بأنها "أحبطت الشباب المتعلم"، لأنها تقدم مسارًا مختصرًا للحصول على الثروة بدون جهد، وأن التفاهة لا الكفاءة ربما تكون الأجدى.
لهذا الغضب ما يبرره في مجتمع يتألم اقتصاديًا، ويُحبط علميًا، ويعاني من تراجع شديد في مردود الجهد الحقيقي، لكن اللافت أن هذا الغضب ليس جديدًا، إذ دائمًا ما يوُجه نحو فئات مثل لاعبي الكرة أو الفنانين أو نجوم الغناء الذين يحققون شهرة وثروة دون شرط التفوق العلمي أو الحصول على شهادات عليا، لكن أحدًا لم يطلب محاكمتهم أو الزج بهم في السجون.
الفرق أن لاعبي الكرة والفنانين جزء من منظومة تخضع بشكل أو بآخر لرعاية الدولة، بينما التيك توكرز اليوم رموز فوضية، غير مروّضة، خارج المراقبة الرسمية، وخارج اللغة النمطية للنجاح.
بالتالي، حنق الدولة والمجتمع لا ينبع فقط من تجاوزات أخلاقية، كما يُروج، بل من تهديد نموذج النجاح التقليدي نفسه، ومن كونه يُظهر فشل الدولة في تكريم العلم والعمل، لا فشل الأفراد في الالتزام بالقيم.
الحقيقة المؤلمة أن الأزمة ليست في أن شابًا ربح من فيديو، بل في أن خريجًا يعاني، ومجتهدًا يُهمَل، ومعلمًا يُهان. ومع غياب العدالة الاقتصادية، ينكّل بمن كسر نموذج الفشل العام بوصفه وسيلة رمزية لاستعادة السيطرة.
الدين المُؤمم
الخطاب الديني في الإعلام والمساجد لا يقل خطورةً عن الإعلام في الغالب؛ يُركّز على اللباس، الطاعة، الضوابط، والحدود، ويُهمل العدل ورفض الظلم وامتهان كرامة الإنسان إلخ إلخ. فتاة بملابس غير تقليدية تصبح "فتنة"، بينما المسؤول الفاسد ليس موضوعًا للنقاش، ويصبح الجهر بالرأي "وقاحة"، بينما الصمت "حكمة".
الجمهور أداة في يد السلطة
لم يعد النظام في حاجة لتبرير ما يفعل بقدر ما يسعى لتوفير جمهور يُبرره له، حتى لو بكلمات مثل "خليها تنضف". ما يحدث أن الجمهور يُستخدم لتبرير القمع، فالدولة لا تحتاج تقديم رواية قانونية مُحكمة، ولا إلى دفاع واضح عن قراراتها، يكفيها موجة الرضا الزائف؛ أن تسمع من الجمهور ما يُشرعن أفعالها "ربنا ينتقم منهم"، "اللي مايحبش كده يبقى ضد الأخلاق"، "خليهم يتربوا".
يصوّت المواطن المقهور على سحب حريته الشخصية دون أن يدري أن المجتمعات التي تفرح بسجن المختلف، سرعان ما تكتشف أنها سجنت نفسها، فقط الدور لم يصلها بعد. قد تفرح اليوم بسقوط فتاة تيك توك لكن غدًا قد تُجر إلى السجن، لا لشيء سوى أنك اختلفت ولو للحظة.
دورك جاي نتيجة منطقية لنمط سلطوي مغلق يمثل شرائح طبقية محدودة، لكنه يبغي الهيمنة على المجتمع بأكمله؛ في الشكل والسلوك والرأي والمظهر، دون تشاركية، أو سماح بأي نشاط حر، سواء كان سياسيًا أو ثقافيًا أو فرديًا.
كل ما يخرج عن الصورة الرسمية للمواطن المؤدب والمطيع يُقابل بالقمع، لا بالحوار، لأن البنية السياسية لا تملك أدوات التمثيل الواسع، ولا تتحمل تعددية المجتمع الذي تحكمه، لهذا لا يُفاجَأ أحدٌ حين تتحوّل قضية تافهة على تيك توك إلى قضية أمن مجتمعي كبرى، لأن نمط الحكم يتعامل مع أي اختلاف أو تهديد مباشر لسلطته، حتى لو كان مجرد فيديو.
هذه القصة من ملف الرقص على حافة القانون.. الدولة والتيكتوكرز وتطهير الهامش المتمرد
من كفر السنابسة إلى تيك توك.. هيبة الدولة على أجساد الفقيرات
من الممكن دومًا تجنب المحتوى الذي لا يوافق أذواقنا أو قيمنا، لكن لا يمكن تجاهل أننا جميعًا ضحايا محتملون لقوانين غامضة ومطاطة تجرّم الفقر والأنوثة والتعبير بدلًا من أن تحمي الحقوق.
اضرب التيكتوكر يخاف المشاهد.. دروس في ترويض الجماهير
لأن الحديث عن الفساد أو القمع السياسي "خط أحمر"، توجّب صنع أعداء آخرين؛ فتاة ترقص أو تتحدث بلغة بيئتها، شاب يصنع ثروة من تيك توك، حساب ساخر يتحدث بلهجة "شعبية".
المثقفون والتيكتوكرز.. من يسائل السلطة؟
المثقف الحقيقي يفقد دوره وتأثيره عندما يختار أن يساير السائد لا أن يسائله. وما بين المسايرة والمساءلة تكمن الحكاية.
الحملة ضد التيكتوكرز.. كيلا يعلو صوت الهامش
هذه ليست حملة أمنية فقط ضد تيكتوكرز، بل صراع أعمق على الظهور، والتمثيل، والحق في النجاة داخل فضاء رقمي غير عادل. لم تعد المسألة من يُقبَض عليه فقط، بل من يُسمَح له بالظهور أصلًا.
تيك توك بين الخطيئة والجريمة.. الأخلاق أداةً لضبط المجتمع
في بلدٍ يعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي والقمع السياسي، يُحوّل انتباه الرأي العام نحو "الفساد الأخلاقي" باعتباره عدوًا مناسبًا، ويُصبح التيكتوكرز تجسيدًا للانحلال الأخلاقي.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.