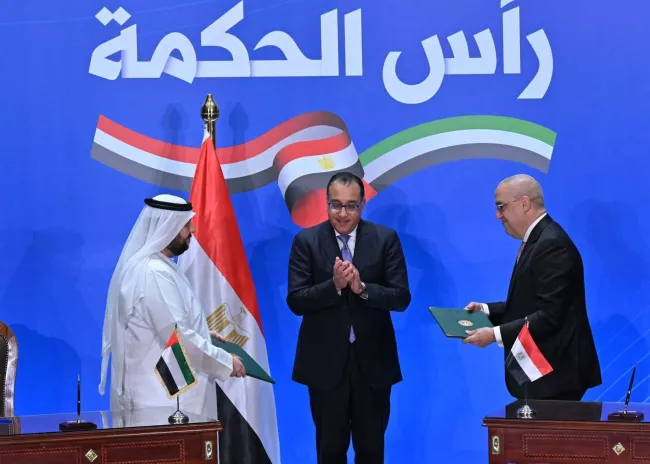اللجنة والتصفية والأصول.. والعودة إلى أخطاء الماضي
لماذا لا تتعلم الحكومة من دروس فشل لجنة تصفية الإقطاع؟
بمجرد أن قرأت في برنامج الحكومة الجديدة عن مشروع إنشاء لجنة "تصفية الأصول" قفزت أمامي ذكريات متفرقة عن لجان تصفية سابقة، نشأت في عهود سياسية مختلفة من بعد ثورة 23 يوليو التي تحل ذكراها الثانية والسبعون غدًا، وقد خلَّفت جميعها باقتدار نتائج سلبية خطيرة، وكان أبرزها بالطبع اللجنة العليا لتصفية الإقطاع التي نشأت قبيل نكسة 1967.
يبدو للوهلة الأولى أن لا أوجه للشبه بين لجنة تصفية الإقطاع ولجنة تصفية الأصول، إلا فعل "التصفية"، فالأولى هدفت بوضوح إلى تفكيك ما تبقى من طبقة كبار ملاك الأراضي والاستيلاء على أملاكهم لصالح الدولة للانتفاع بها أو لتوزيعها على صغار الفلاحين في سياق معاكس تمامًا للواقع الحالي، حيث تبدو الدولة حاليًا متعجلةً في طرح المزيد من الأملاك العامة وأملاكها الخاصة في قطاعات مختلفة للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص.
غير أن كلمة "التصفية" تبعث على التأمل في أوجه تشابه أخرى، وتثير الغضب بحق إذا اقترنت بـ"أصول" مملوكة للشعب، تنوب الحكومة عنه في إدارتها. فالمعنى اللغوي للكلمة ينحصر في الإنهاء والفناء، وإزالة وضع سابق تمهيدًا لإنشاء وضع جديد، أما سياسيًا فتعني القضاء على شخص أو جماعة أو مجموعة من الأشياء أو العناصر القائمة لتكريس حالة مغايرة.
بيان رسمي يثير تساؤلات أكثر
حاولت وزارة المالية امتصاص الجدل حول "تصفية الأصول" فأصدرت بيانًا لم تُذكر فيه كلمة التصفية، تؤكد فيه أنها لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية وأنها تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لها لتحقيق أعلى عائد، باعتبار أن "إدارة الأصول العقارية ليست من أدوار الدولة، لكنها تدخل في شراكات مع القطاع الخاص لمقتضيات الصالح العام".
عن أي أصول تتحدث الحكومة؟ وهل هي أصول يمكن تصفيتها بالفعل وفق الدستور؟
أثار هذا البيان تساؤلات إضافية زادت غموض اللجنة المزمع إنشاؤها، التي لا يمكن التعامل معها باستخفاف أو تجاهل، فهي مذكورة نصًا في متن برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب كاملًا الخميس 18 يوليو/تموز الجاري، على رأس آليات مقترحة في برنامج لخفض الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وبهدف تحقيق عوائد مالية تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه سنويًا للخزانة العامة.
فعن أي أصول تتحدث الحكومة؟ وهل هي أصول يمكن تصفيتها بالفعل وفق الدستور؟ وهل من المنطقي أن تتحقق هذه العوائد سنويًا من أصول عقارية مملوكة لوزارة المالية كما قالت؟ ثم ما هي معالم خريطة الطريق المقدمة من الحكومة للتعامل مع الأصول بشكل عام، وفي القلب منها هذه اللجنة؟
إن هذه التساؤلات منطقيةٌ وابتدائيةٌ للغاية سعيًا لإنهاء الارتباك الذي يشوب الحديث عن الأصول في برنامج الحكومة، خاصة إذا ما طبقناه على ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحت بشكل نهائي على مجتمع الأعمال نهاية عام 2022، وذلك على ضوء ملاحظات مهمة.
غموض طبيعة الأصول
يتحدث برنامج الحكومة عن إنشاء لجنة تصفية الأصول ضمن برنامج خفض الدين العام، بينما يوجد مشروع آخر لرفع كفاءة استغلال الإدارات المحلية للأصول المملوكة لها والمملوكة للدولة، التي تقع في أنطقتها الجغرافية، وهناك برنامج ثالث رئيسي للتعامل مع ملكية الدولة للأصول تستهدف به الدولة زيادة المنافسة في مجالات الصناعة والتجارة وجذب الاستثمارات، يقوم على تقليص حجم الاستثمارات العامة من خلال التخارج والطروحات، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة من خلال تطوير إطار تشريعي ورقابي.
يتطلب هذا الغموض توضيحًا لمدى الحاجة لتشكيل اللجنة ومدى ارتباطها بضغوط خارجية، وطبيعة الأصول المستهدفة بالطرح في كل برنامج، أسوة بإعلان رئيس الوزراء قائمة الشركات الحكومية التي مثّلت الدفعة الأولى من الطروحات في فبراير/شباط 2023، لا سيما وأن الأمر لن يقتصر على ما يبدو على الشركات بل سيمتد إلى أصول عقارية، على حد إعلان وزارة المالية، مما يعني إتمام التعاقد بصور مختلفة عن بيع الحصص لمستثمرين استراتيجيين أو الطرح في البورصة.
غموض معايير التقسيم
لم يرسم برنامج الحكومة حدودًا فاصلةً بين كل مجموعة من الأصول اندرجت تحت مشروع أو برنامج معين، ولم يذكر أي معايير للاختيار أو التقسيم، كما أن بيان وزارة المالية صدر محاولًا التهوين من قيمة وحجم الأصول المستهدفة بالطرح لتكون مجرد "أصول عقارية تابعة للوزارة".
واكتفى البرنامج بعبارات عامة مثل "تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا بما يحقق المصلحة العامة" و"المضي قدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة"، وكأن البرنامج يشرح أولويات وثيقة سياسة ملكية الدولة لمن لم يسمع عنها من قبل، لا لبرلمانيين ورجال أعمال ورأي عام وإعلام كان ينتظر من البرنامج تفاصيل أكثر، وعلى الأقل تحديد معايير اقتصادية واضحة تلعب دورًا في ترتيب أولوية الطروحات والصفقات المستهدفة.
غياب التكامل مع "سياسة ملكية الدولة"
تقول الحكومة في برنامجها إنها تنتوي المضي قدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول. وقبل تشكيل الحكومة بأيام معدودة صدر رسميًا قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذي يفتح الباب وباتساع غير مسبوق للاستثمار في القطاع الصحي وخصخصة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 15 عامًا. كما ينص برنامج الحكومة من بين أهدافه الخاصة بملف الصحة على "توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا".
وإذا عدنا لمطالعة وثيقة سياسة ملكية الدولة سنجد مفاجأة غريبة بعض الشيء، إذ أنها تضع القطاع الصحي ضمن القطاعات التي تخطط الدولة إلى "تثبيت أو زيادة" الاستثمارات الحكومية فيها مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع القانون الجديد، كما يختلف في صياغته ومقصده مع ما جاء في برنامج الحكومة، الذي قصد طمأنة الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
أيضًا كانت الوثيقة تنص على وضع قطاع التعليم في نفس الفئة التي ستزيد فيها الاستثمارات الحكومية، لكن وزير التعليم السابق رضا حجازي تحدث مرارًا عن أولوية جذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاع، لا سيما في ظل تنامي شراكة صندوق مصر السيادي مع القطاع الخاص في بعض المشروعات التعليمية.
كما لم تنعكس بيانات الوثيقة بوضوح تفصيلي على البرنامج، من حيث القطاعات التي من المقرر أن تشهد تخارج الدولة أو تخفيض الاستثمارات الحكومية، رغم ضرورة ذلك حتى يكون الشعب على بيّنة من تأثير التخارج على خدماته وحقوقه، وطريقة تدبير المرافق العامة على ضوء متغيرات الملكية أو الإدارة.
ولذلك؛ كان يجب أن يتضمن برنامج الحكومة تفصيلًا للاتجاه الحالي، تكاملًا مع الوثيقة وتفسيرًا للتحولات، إن وجدت، وتفنيدًا للمفارقات، لكنه اكتفى بعبارات إنشائية ومُربكة.
ولا يمكن قبول الادعاء بأن برنامج الحكومة لا يجب أن يخوض في تفاصيل تنفيذية، فأوجه النقص المذكورة ليست تفاصيل بل تدخل في صلب السياسات العامة، كما أن البرنامج قد توسع في ذكر تفاصيل تنفيذية غير مهمة في العديد من الملفات، ربما لأنها ليست إشكالية ولا حاجة إلى فرض سياج من السرية حولها.
التصفية وسؤال المشروعية والرقابة
لا تخلو كلمة "تصفية" في السياق المصري من التسرع والخروج عن المألوف، وكثيرًا ما تتطلب "التصفية" إجراءات استثنائية من نوع خاص تأتي من خارج المقررات الدستورية والتشريعية.
يتحدث برنامج الحكومة باقتضاب عن "تطوير إطار تشريعي ورقابي يضمن استخدام الأصول بطريقة مستدامة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول المملوكة للدولة". ويبدو أن هذه العبارة مقتصرة على مراقبة الإدارة والتشغيل بعد التصرف، وليس إحكام الرقابة على معايير اختيار القطاع محل الطروحات ثم اختيار الأصل ذاته والإجراءات وحوكمتها.
كل ذلك لا ينال من رسوخ حرمة الملكية العامة أو حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
من جهته ينص الدستور على أن "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون"، ويلزم الدولة في المادة 218 بمكافحة الفساد كما يلزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها لـ"تعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام...". وبالطبع تدخل جميع أصول الدولة بمختلف أشكالها ضمن الملكية العامة والمال العام، طالما لم تُنقل لتصبح مملوكةً للصندوق السيادي أو لجهة أخرى كملكية خاصة تمكّن من التصرف فيها بشكل أسرع.
نعم.. شهدت السنوات الأخيرة مستجدات عدة نحو تحرير السوق وتشجيع الاستثمار وتسريع بيع الأصول، على رأسها إنشاء الصندوق السيادي ومنع العامة من الطعن على القرارات المتصلة به ونقل العديد من الأصول العقارية إليه، خاصة ما تمتلكه شركة مصر القابضة للتأمين، وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتأييد قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذي يسمح للكافة بالطعن لحماية المال العام في حالة واحدة فقط هي صدور حكم قضائي بات يدين إجراءً فاسدًا، ثم إجراء العديد من الصفقات الكبرى في مختلف القطاعات دون كشف التفاصيل.
لكن كل ذلك لا ينال من رسوخ حرمة الملكية العامة أو حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وقد نص عليهما الدستور.
سيقول البعض إن تعقيد الإجراءات الإدارية وتسليط سيف القضاء على التعاقدات في عهود سابقة أديا إلى إهدار الصفقات الناجحة و"تطفيش" المستثمرين من مصر. لكن الحقيقة أن قليلًا من الجهد المخلص لوضع تنظيم شفاف وواضح للتعامل مع الأصول توخيًا للصالح العام، سوف يكون من عوامل جذب المستثمرين الجادين وفي الوقت ذاته طمأنة المواطنين على حقوقهم في الخدمات والمرافق وحماية ملكيتهم العامة.
وإذا كنا بصدد التوسع في "تصفية الأصول" وتنفيذ برنامج طويل الأمد للتخارج والشراكة مع القطاع الخاص، فلا يستقيم أن تدخل مصر الكبيرة هذه المرحلة الجديدة دون آلية رقابية حقيقية تحافظ على مقدراتها، وتحمي حقوق الأجيال القادمة، وأيضًا.. تقي المؤسسات والمستثمرين، معًا، أخطارًا قد تحدث في المستقبل القريب، إذا تغيرت سياسات الدولة وتوجهاتها.
عندما تسقط الحماية السيادية
هنا.. تصبح العودة واجبة إلى ملفات اللجنة العليا لتصفية الإقطاع ولجانها الفرعية لتروي آلاف الوقائع التي أثبتت أن تسرع السلطة التنفيذية وتعسفها في فرض آليات مشكوك في دستوريتها، ربما يؤديان لاحقًا إلى خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني تربك الأوضاع المالية والاستثمارات والملكيات الخاصة، كما تضعف هيبة الدولة.
فقد ولدت تلك اللجنة في مايو/أيار 1966 برئاسة المشير عبد الحكيم عامر وبسطت سيطرتها أولًا على إجراءات مصادرة الأملاك الزراعية والعقارية لأكثر من 330 عائلة، ثم توسعت لتتحكم في استبعاد أفراد منتمين لتلك العائلات وأقاربهم من الوظائف العامة، وكل ذلك "بالتليفون" أو بمكاتبات خاصة.
وبعد نكسة 1967 توالت الأحكام القضائية لضرب مشروعية تلك الممارسات، مما اعتبره بعض سدنة الاتحاد الاشتراكي في ذلك الوقت مساهمة من القضاء لإذكاء "الثورة المضادة"، بينما نرى القيادي بالاتحاد فريد عبد الكريم يقول للرئيس جمال عبد الناصر في اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد 5 فبراير/شباط 1969 إن "الناس الذين وضعوا تحت الحراسة يتخذون إجراءات قضائية ويبدو أن القانون في جانبهم إلى حد ما"، داعيًا إلى التدخل التشريعي "الواضح والقاطع" لمنع رد الأراضي لملاكها، ولحماية الفلاحين البسطاء من الطرد.
وبعد رحيل عبد الناصر وتبدُّل السياسات ثم ميلاد دستور 1971 أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا عديدةً بإعادة أملاك لأصحابها وإعادة مواطنين إلى وظائفهم، وسقطت الحماية "السيادية" عن قرارات لجنة تصفية الإقطاع، لتعتبرها المحكمة محض أعمال إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة.
بل إن وزير الزراعة في عهد تصفية الإقطاع سيد مرعي وصف في مذكراته التي نشرها بجريدة الأهرام في سبتمبر/أيلول 1978 أعمال اللجنة بأنها "جرائم.. وحكم إرهاب" ونقل على لسان عبد الناصر نفسه قوله إن تلك اللجنة "كانت غلطة"!!
ليس حتميًا أن تتشابه تبعات تصفية الإقطاع مع الآثار طويلة الأمد لتصفية الأصول، فنجد أنفسنا أمام قرارات غير مشروعة وصفقات محصّنة لا نستطيع التعامل مع تبعاتها، أو تدخلات قضائية عنيفة فيضطرب الاقتصاد الوطني. ولكن من الضروري أن نتعلّم من التاريخ فلا نعيد اختراع نفس الأخطاء.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.