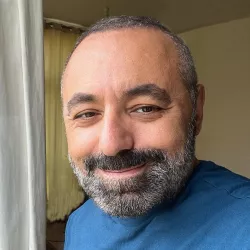أزمة "نصف الجمهورية" الإيرانية
أُعلن قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979 في أعقاب ثورة شعبية عظيمة، سالت على طريق تأسيسها دماء كثيرة، كثيرة جدًا، تخضبت بها شوارع طهران في ملحمة شجاعة استمرت أكثر من عامين، حتى سقطت دولة الطاغية المتغطرس محمد رضا بهلوي.
لكنَّ أكثر الدماء التي جرت في شلال الثورة كانت من أجل تثبيت سلطة زعيمها آية الله الخميني فوق جثث من عارضوه، بمنتهى القسوة والوحشية. ضحاياها الأبرز كانوا ممن هم داخل معسكر الثورة بالذات، فالثورة الإيرانية مثلها مثل أي ثورة كبرى في التاريخ، أكلت من أبنائها أضعاف ما أكلت من أعدائها.
انهارت دولة الشاه تحت وطأة الانتفاضة الشعبية الجارفة، سقطت سقوطًا تامًا بلا عودة، انتهت كطبقة حاكمة مترفة تحتقر الشعب، وقوات مسلحة ولاؤها للعرش لا للشعب، وجهاز أمني استثنائي الشراسة اسمه السافاك، تمنى الشعب الإيراني الانتقام منه أكثر من أي شيء آخر، وكان له ما أراد.
خلق الانهيار التام لدولة الشاه فراغًا موحشًا طوال سنتي الثورة بين 1977 و1979، وترتب عليه إدراك عواقب غياب الدولة والفوضى التي تنتج عنه. ومن داخل الفوضى والخوف؛ بزغت شرعية آية الله الخميني لتعلو فوق أي شرعية أخرى، ليرث الدين دولة الأعيان من أجل الحفاظ عليها، ولتسد الشرعية الدينية ثغرات ضعف هيمنة الطبقة الحاكمة، حفاظًا على النظام العام والملكيات الخاصة.
في المقابل، كانت نظرة الخميني للحكم صريحة في استبداديتها، بل فخورة بها، بدعوى أنها تجسيد للحكم القوي، فلم تعتذر أبدًا عن تصورات طغيانها بسلطتها المستندة في جوهرها على إحياء تقاليد الحكم الإسلامي ابن القرون الوسطى إحياءً شرعيًا معاصرًا، يعترف بوجود الشعب وبمكانته.
عبَّر الخميني عن تصوراته تلك من خلال كتابه المهم الحكومة الإسلامية الذي ألَّفه عام 1969 في صورة سلسلة طويلة من المحاضرات، ألقاها في النجف الأشرف، وتلا خطوطه العريضه أمام الشعب في خطابه الجماهيري الأول بعد عودته إلى طهران أمام مقابر جنة الزهراء حيث ترقد جثامين شهداء الثورة.
الشاه ذو العمامة
لكن في الوقت نفسه كانت الثورة الإيرانية ثورة شعبية منتصرة، سعت للإطاحة بحكم ملكي متغطرس لتؤسس مكانه جمهورية مكتملة، لم يعرف الشعب سبيلًا إليها من قبل، لذا لم يكن من الممكن استبدال عمامة الملالي السوداء بتاج ملك الملوك المرصع بالماس بين عشية وضحاها.
كان لا بد أن تجد السلطة الجديدة لنفسها صيغة وسط، تتحرك من خلالها بإيران الشاهنشاهية وسط برزخ انتقالي طويل، لا تزال تسير في ظلماته حتى الآن، اسمه "الجمهورية الإسلامية"، أو نصف الجمهورية كما أحب أن أسميها، وهي لا تختلف جوهريًا في ظني عن نصف الجمهورية المصرية ذات الملمح العسكرى اليوليوي، حيث الجمهورية معلنة، والشعب موجود، سيدٌ وممجدٌ لكنه مؤجل، وإرادة سلطته الكاملة في حالة إرجاء مستمر إلى حين.
تلاقت السلطوية الإسلامية ذات اليقين الإلهي مع الثورة الشعبية الجارفة، فأنتجتا معًا نظامًا هجينًا جديدًا بمعايير النظم السياسية، حيث الشعب مصدر السلطة والشرعية، ولكن في الإطار الذي يحدده رجال الدين ودولتهم.
كل الهيئات في إيران منتخبة، بما في ذلك مجلس الخبراء الذي يختار المرشد الأعلى للثورة، ولكنَّ هذه الهيئات منعت غير الإسلاميين من الترشح لها، بدأت بالشيوعيين والقوميين والليبراليين، وفي وقت لاحق منعت اليسار الإسلامي المؤيد لصيغة الجمهورية الإسلامية، وفي النهاية استدارت لتقصي كل من لا ترضى عنه، أو بمعنى أصح؛ كل من لا يرضى عنه علي خامنئي، فمجلس صيانة الدستور، ومنذ لحظة تأسيسه، هو الذي يحدد مَن له حق الترشح للبرلمان أو الرئاسة أو مجلس الخبراء.
تأسست الجمهورية الإسلامية كحالة استثناء امتدت حتى لحظتنا الحالية، ورفضت الخضوع لعمليات التغيير والإصلاح اللازمة التي حاول بعض الإصلاحيين تمريرها، لأنها كانت ستمس حتمًا سلطة رجال الدين المطلقة، وسلطة الحرس الثوري الواقعية.
في البداية كان آية الله الخميني مرشدًا للثورة دون صلاحيات واضحة، فالخميني كان زعيمًا يرتقي إلى مصاف الأولياء. لم يكن يُسأل فيما يفعل بل كان كلامه يُوحي وصمته يُفسّر، كان أكبر من أي صلاحية أو دستور. وحين توفي عام 1989، خلفه آية الله علي أحمد خامنئي في لحظة خاطفة، متخطيًا طابورًا طويلًا من آيات الله المؤهلين دينيًا للمنصب، وأهمهم آية الله حسين منتظري.
استولى خامنئي على موقع الخميني ولكن بصلاحيات أكثر وضوحًا، فخامنئي ليس الخميني حتى وإن كان من الأركان المؤسسة للدولة الجديدة. ومع مرور الزمن وترسيخ النظام لقوة سلطانه، وتحول الثورة إلى دولة بترولية ريعية غنية تهِب وتمنَح وتحرم، صار خامنئي في موقع الشاه ذي العمامة. ومع تزايد المعارضة له، لم يعد الإيرانيون يخافون مكانته أو مقامه المدرع دينيًا، ولم يعد موقع رئيس الجمهورية الذي اعتاد استخدامه كحائط صد بينه وبين الجماهير موقعًا مهمًا، أصبح الناس يهتفون ضده هو صراحة "الموت للديكتاتور".
ما بعد خامنئي
يشيخ الولي الفقيه الديكتاتور، فكلُّ من عليها فانٍ. ومع اقتراب دنو الأجل، تقترب الأسئلة الأكثر مركزية من استحقاقات إجاباتها؛ من سيخلف خامنئي، وهل بالإمكان أن يخلفه أحد؟
إجابة السؤال صعبة، لأنه لا يوجد من يستطيع حيازة كل هذه الصلاحيات المطلقة في اللحظة الراهنة، فلماذا يسمح العسكر سواء في الجيش أو الحرس الثوري بذلك؟ الخميني هو قائد الثورة، وخامنئي هو مؤسس الدولة مع هاشمي رفسنجاني، أما أغلب العمائم فأصبحت مكروهة ومحتقرة من قطاعات واسعة من الشعب الإيراني، فلماذا يُصعَّد أحد مومياوات قُم لمنصب وكيل صاحب الأزمان؟
في ظني لن يكون هناك مرشد أعلى جديد في إيران بنفس صلاحيات الخميني وخامنئي، لأنها سلطات وصلاحيات استثنائية ناتجة عن تفاعلات تجربة الثورة واستحقاقات قيادتها. لم يكن المنصب أبدًا لأصحاب الأيادي الناعمة أو ورثة الأقدمية، لذا فصلاحياته لا يمكن لها الاستدامة إلا لمن يملك القوة والشرعية المادية الفعلية. وإذا زُج بأحد الملالي في هذا المنصب، فسينظر له الشعب كدمية في يد مجموعة ما، ووقتها ستوضع البنية العنكبوتية والأخطبوطية لنظام ولاية الفقيه في اختبار حقيقي.
منذ أيام سقطت طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، مات وبصحبته أمير عبد اللهيان وزير الخارجية المدلل من مؤسسات الحرس الثوري. لم يكن إبراهيم رئيسي محافظًا ولا إصلاحيًا، بل جزار قضائي لمعارضي النظام، يديه ملطختان بدماء آلاف المعتقلين الذين تم تصفيتهم في سجن إيفين عام 1988 بلا جريرة.
أُتي برئيسي إلى السلطة لأن هذا النظام في هذه المرحلة يحتاج إلى هذا النوع من الرجال الذين تشبه نهاياتهم بداياتهم، فنظام ولاية الفقيه تعقدت أزماته في السنوات الخمس الأخيرة حتى جعلت من ثنائية الإصلاحيين والمحافظين، التي كانت تشكل المشهد السياسي الإيراني لعقدين من الزمان، جزءًا من التاريخ المُسلي للسياسة في "نصف جمهورية الإسلاميين".
قمع نظام ولاية الفقيه وبمنتهى العنف والإجرام أربع انتفاضات شعبية كبيرة منذ عام 2019، واستباح دماء الإيرانيين بدعوى أن هناك دائمًا ما هو أسوأ، مستخدمًا وفوراته المالية النفطية التي ينسى البعض أنها سر استمراره من البداية، فإيران في النهاية دولة ريعية مثلها مثل دول الخليج، ولكن مع سكان أكثر وعدالة أقل في توزيع الثروة. ولا يزال السؤال المركزي حتى الآن في علاقة المواطن الإيراني بدولته هو: أين تنفقون عوائد البترول وأموال النفط وما هي أولويات الإنفاق؟
جمهور الانتفاضات الشعبية الحقيقية التي قمعها النظام الإيراني في السنوات الأخيرة هو نفس جمهور الثورة الإسلامية عام 1979، هؤلاء الذين طالبوا بالخبز والعدالة والحرية. لم تكن انتفاضات لشباب الطبقة الوسطى المدينية الذين يسعون إلى توسيع هامش الحريات، بل كانت انتفاضات المدن الصغيرة، وفي القلب منها نساؤها. ومن سخرية التاريخ أن دولة ولاية الفقيه التي وُلدت من رحم ثورة شعبية وكانت ابنة تجربة ثورية، لم يبقَ من وجه ثوريتها تلك إلا ملامح الإجرام القاسي للثورات المظفرة.
قد تبدو قصة الثورة الإيرانية ومآلاتها مخيفةً للبعض، وربما يظن بعض القراء في مصر أننا بمنأى عنها، ظنًا بأننا لم نختبر أبدًا حكمًا استبداديًا عسكريًا دينيًا غاشمًا. لكن مهلًا قليلًا، فربما علينا معرفة أن لا الخميني ولا خامنئي قال يومًا إن الله أتاه المُلك لأنه سبحانه يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، ولا أعتقد أن أحدًا منهما تجرأ وقال إنه سيحاسب شعبه أمام الله يوم القيامة.
لذا وجب التنويه، لأنَّ بإمكاننا الانتقال إلى حيث انتهت إيران دون دراما ومَشهديات إسلامية سياسية كبرى، وبلا ملالٍ أو ولاية فقيه أو حوزة قُم.
الأمر بسيط جدًا؛ إما الشعب، أو السلطان.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.