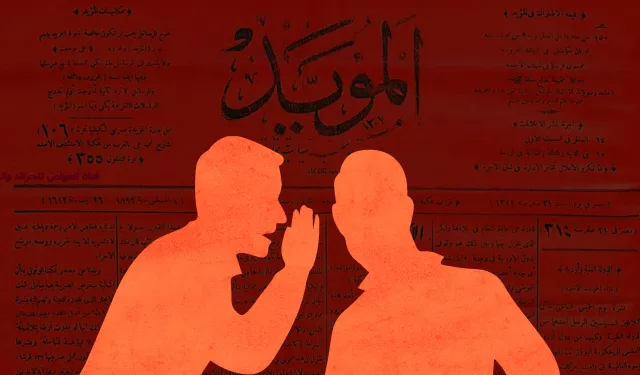
هل ذكرتم توفيق كيرلس؟
"الصوت العميق" الذي أزعج القيادات البريطانية
ظللت حتى وفاة أمي في منتصف السنة السادسة من سجني ملتزمًا بما عاهدت نفسي عليه؛ ألا يرى أحد دموعي في السجن. فأمّا السجّانة والمرشدون فلن ينقلوا ما قد يرونه إلا على أنه دليل ضعف أو حسرة، أو حتى انكسار. وأما السجناء الجنائيون، بل وأغلب السياسيين، فلن يفهموا سبب بكائي إلا إذا بيّنتُه لهم. وغالبًا لم يكونوا ليسألوا، وغالبًا لم أكن لأبادر بالبيان. اتخذت هذا العهد على نفسي بعدما أدركت أن ما أبكاني لم يكن من المتوقع أن يكون سبب بكاء السجناء المظلومين.
نزلت أول دفقة من دموعي الحارة تحت البطانية الميري في ليلة شديدة البرودة خلال أسابيعي الأولى في سجن مزرعة طرة، وكانت السبب في اتخاذي هذا القرار. لم تكن بكاءً على حالي، ولا خوفًا من مآلي. بل يشهد الله، كانت لأني تذكرت مصادري الصحفية والبحثية من أهل سيناء، ومنهم من فقد مزرعته، أو خسر بيته، أو أصيب في جسده، أو كانت مصيبته أكبر من ذلك كله؛ في أولاده.
فأين ما أصابني مما قد أصابهم؟ وأين معرفة الناس بهم من معرفتهم بي؟!
كنت عرفت بعضًا من مظاهر التضامن الواسع معي من كثير من الزملاء والأساتذة، صحفيًا وأكاديميًا وحقوقيًا، محليًا وإقليميًا ودوليًا. فرأيت نفسي وقد وقعتُ، عن غير قصد، فيما كنت أناضل ضده. فمكاننا، كصحفيين وحقوقيين، ينبغي أن يظل خارج الصورة، لا نزاحم أبطال القصة الحقيقيين صدارة "الكادر"، بل لا ينبغي لنا أن ندخله أساسًا إذا كنا صادقين في ادّعائنا السعي إلى تمكين المهمشين من إبلاغ صوتهم.
حين نكون نحن القصة، لا هم، فإن خللًا جسيمًا قد وقع، ويجب أن يُصحّح. وأول العلاج أن نحسن تشخيص المشكلة بعد الاعتراف بها. فإذا كانت نصرة المستضعفين والمهمشين سبيلًا لشهرة "النشطاء" ولفت الأنظار والأضواء إليهم، فإن جريمة التهميش هنا لا تنفرد بها السلطة، بل تشاركها مجموعات النشطاء والمناضلين، الذين يكونون، إذن، جزءًا من الأزمة، لا جزءًا من الحل. وإن قبلت هذا الخلل فإني سأكون، بالتواطؤ، مجرمًا في يقين ضميري، حتى وإن رآني العالم كله ضحية بريئة تستحق التضامن!
ساقت لي الأقدار فرصة الاطلاع من داخل مكتبة السجن على كتاب يؤرخ للصحافة اليومية المصرية في القرن التاسع عشر، فإذا بي أجد هذه المشكلة متجذرة في تاريخنا الحديث.
الريادة المصرية في الصحافة والتهميش!
قبل 73 سنة كاملة من ملحمة الصحافة الأمريكية مع السلطة التنفيذية في ساحة القضاء من أجل انتزاع الاعتراف بحقها في ممارسة الرقابة على الحكومة والرؤساء المنتخبين، الذين داوم أربعة منهم على الكذب على الجماهير بخصوص حرب فيتنام منذ 1961، كانت الصحافة المصرية سبّاقة إلى نشر وثائق عسكرية بالغة السرية والحساسية تكشف أكاذيب السلطة بخصوص حملة الجيش المصري في السودان تحت قيادة سلطات الاحتلال البريطاني.
وقبل أن يعرف التاريخ بطلًا اسمه بن برادلي، كان رئيسًا لتحرير جريدة واشنطن بوست، وبطلة اسمها كاثرين جراهام، كانت مالكة للصحيفة نفسها، واستأنفت نشر الوثائق المسربة بعد أن أجبر القضاء صحيفة نيويورك تايمز على وقف النشر، كان في مصر بطل اسمه الشيخ علي يوسف، مؤسس جريدة المؤيد ورئيس تحريرها، ذلك الذي نشر ما اهتزت له أركان القيادة العسكرية البريطانية في مصر والسودان، ومعها أذناب الاحتلال في مصر.
حين تُذكر قضية "أوراق البنتاجون"، وهو الاسم الجماهيري للدراسة التي أمر بإعدادها وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا ونفّذتها مؤسسة "راند" بغرض تقييم قرارات الجيش الأمريكي في الحرب وجدوى استمراره فيها، فإن أبطال القصة الصحفية الذين تقفز أسماؤهم إلى الصدارة هم فريق واشنطن بوست، كما جُسّد ذلك في الفيلم الشهير The Post إنتاج عام 2017، حيث كانت البطولة لكل من توم هانكس/بن برادلي وميريل ستريب/كاثرين جراهام.
لكنَّ أحدًا لا يذكر دانيال إلسبرج، الباحث الذي سرّب الدراسة إلى الصحافة مخاطرًا بمحاكمته وفق قانون مكافحة التجسس، وقام بدوره في الفيلم الممثل البريطاني الأصل ماثيو ريس.
حوكم إلسبرج في يناير/ كانون الثاني 1973، وحُكم عليه بمجموع أحكام بلغ 115 سنة، وفق قانون التجسس لعام 1917، لكن التهم أسقطت عنه لاحقًا في مايو/أيار من العام نفسه. وحظي بشيء من الشهرة لعدة أسباب أخرى؛ فهو من علماء جامعة هارفارد، وله إسهامات مسجلة باسمه في نظرية القرار، وشغل عدة مناصب مرموقة بعد تسريحه من البحرية الأمريكية برتبة ملازم أول.
كما كانت له أدوار نشطة وعلنية في دعم وتشجيع تسريب الوثائق الحكومية الكاشفة لكذب الحكومات، ونشط ضد الغزو الأمريكي للعراق، حتى إنه اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 لمخالفته قانونًا محليًا أثناء تظاهره ضد ممارسات جورج بوش الابن بسبب حرب العراق. ولا يزال حيًا يرزق، بارك الله في عمره، وقت كتابة هذه السطور.
أما في مصر، وقبل إثارة قضية أوراق البنتاجون عام 1971، فكان السبق لما عُرف لدينا بـ "قضية التلغرافات" عام 1896. اشتهرت القضية بمفجّرها صاحب "المؤيد"، الشيخ علي يوسف، وانزوى من ذكرها تمامًا بطلها المغمور: توفيق كيرلس!
خلفية عن قضية التلغرافات الحربية
بدأت قضية التلغرافات، كما يقول صلاح قبضايا في كتابه الصحف اليومية المصرية في القرن التاسع عشر، بمنافسة شديدة تفوقت فيها جريدة المقطم الموالية والمدعومة من سلطات الاحتلال البريطاني على سائر الصحف الأخرى في تقديمها التفاصيل الدقيقة لمعارك الحملة العسكرية في السودان، وقيامها بالتغطية الصحفية الكاملة لأخبار الحملة وأنباء تحركها.
بدأت "المؤيد" في نشر ما يصل إليها من أسرار الحملة حتى أنها نشرت نص المنشور الذي وزعه السردار على الدراويش في السودان يدعوهم إلى الهدوء والسكينة
غير أن "المقطم" بكل ما كانت تعرضه من تفاصيل وتنفرد بنشره من أنباء، كانت تحرص على حجب ما تعتبره السلطات البريطانية من أسرار الحملة، وألا تنشر ما قد يسيء إلى الاحتلال ورجاله. وأدى ذلك إلى استمرار تعاون الدوائر الاستعمارية في مصر مع هذه الجريدة وتزويدها بكل ما يمكن أن ينشر من أخبار الحملة التي تهافت الشعب المصري على متابعتها بشغف مع حرمان باقي الصحف، وبصفة خاصة "المؤيد"، من هذه الأنباء، حتى يتجرد الشيخ على يوسف من كل سلاح قد يشهره أو يستعين به في حملته على الاحتلال البريطاني.
وفي إطار هذه الخطة أصدرت نظارة الحربية في مايو 1896 أمرًا مباشرًا بحرمان "المؤيد" من أنباء الحملة على دنقلة، بل شمل هذا الأمر المصالح الحكومية جميعها وسائر الأخبار الرسمية.
غير أن الشيخ علي يوسف لم يقف مكتوف الأيدي، فحرص على أن يتنسّم الأخبار ويستقيها من شتى مصادرها، مستفيدًا في ذلك بما حصل عليه من تشجيع الخديوي عباس نفسه، ولاجئًا إلى الحيلة للوصول إلى أنباء الحملة، خاصة تلك التي حرصت سلطات الاحتلال على إبقائها في طي الكتمان.
وبدأت "المؤيد" في نشر ما يصل إليها من أسرار الحملة، حتى أنها نشرت نص المنشور الذي وزعه السردار على الدراويش في السودان يدعوهم إلى الهدوء والسكينة، رغم حرصه على ألا يتسرب هذا المنشور إلى غير السودانيين حتى لا يُفسَّر كمحاولة استرضاء للدراويش.
كما عهدت "المؤيد" إلى نشر كشوف بأسماء وعناوين القتلى من رجال الحملة، مما تعتبره نظارة الحربية من الأسرار ويعد نشره عملًا عدائيًا ضد السلطات البريطانية، غير أن قانون العقوبات لم يسعف هذه السلطات بنصوص تُدين الشيخ علي يوسف.
وخلال صيف 1896 واجهت حملة دنقلة الكثير من المشكلات والمصاعب الإدارية، وهذا ما كان ينقله السردار إلى كرومر وإلى نظارة الحربية في تقاريره وبرقياته السرية، التي وصل بعضها إلى الشيخ علي يوسف فلم يتردد في نشرها على صفحات "المؤيد".
وكانت أبرزها البرقية التي أرسلها السردار إلى ناظر الحربية يوم 26 يوليو 1896، ونشرتها "المؤيد" في عدد 28 يوليو، وفيها يعتذر السردار عن تأخره في مخاطبة الناظر، وأن الكوليرا التي تفشت في الجيش كانت شغله الشاغل، ذاكرًا عدد الإصابات وعدد الوفيات، ونعى إليه بعض ضباط الجيش، وتحدث عن تأخر السكة الحديد لسوء حال الوابورات التي تنقلها والتي مضى عليها أكثر من إحدى عشرة سنة، وأن انخفاض النيل عاق سير السفن في الشلالات.
ونشر نص التلغراف تحت عنوان "أحوال الجيش المصري في الحدود". فهاج ناظر الحربية لنشر هذا التلغراف السري، وهاجت معه السلطات الإنجليزية في نظارة الحربية. لكن صاحب "المؤيد" حرص على أن يكرر المعنى نفسه ونوعية المعلومات ذاتها، بمزيد من التفاصيل، على مدى عدة أيام.
صعّدت جريدة المؤيد في محتوى ما تنشره حتى تحول موقفها الرافض للحملة العسكرية في السودان من متابعة صحفية إلى حملة شاملة. وكما هاجمت سلطات الاحتلال مستخدمة ما تحت يدها من معلومات وأسرار، حرصت على أن تشهر ذلك أيضًا في وجه جريدة المقطم، وأن تسجل ما أكدته الأيام من صحة المعلومات التي نشرتها عن سوء حالة الجنود.
وحرصت الجريدة في الوقت نفسه على عدم المساس بكرامة وشجاعة الجندي المصري لتتجنب ردود الفعل، وتحتفظ بتعاطف القراء، ملقية كل التبعات على عاتق القيادة البريطانية وأصحاب قرار إرسال الحملة، فذكرت:
"كتبنا جملة فصول عما يقاسيه جيشنا المصري المسوق برغبة الإنكليز ولفائدتهم إلى ميدان الحرب في صحراء السودان المحرقة من العناء والبؤس، لا بسبب الضرب والطعان الذي فيه الجيش الشجاع في الميدان على أنه صاحب ذلك الفخار المشهور من قديم الزمان، ولكن من هجمات الحر والوباء، واللذين صارا أشد وطأة عليه من الزؤام.
وفضلاً عن ذلك فإن صعوبة النقل جعلته يحتاج للزاد والمؤونة، وهو الشيء الذي إذا ذكره المصريون ازدادت مرارتهم على إخوانهم وفلذات أكبادهم. ولكن بينما كنا نذكر هذه المحزنات ونتألم منها ونلوم القواد الإنكليز على هذه المخاطرة المريعة، كانت الجرائد المأجورة تطعن علينا وتتهمنا بالغلو والمبالغة والتحامل على أولئك القواد.
ونحن لم نعجب من وجود الفرق العظيم والفرق الشاسع بين شعورنا وشعور أولئك المأجورين، حيث لا ينتظر منهم أن يألموا. وويل للشجيّ من الخليّ! وإنما يسرنا الآن أن جريدة ’المقطم‘ قد رجعت فكتبت فقرة في محلياتها أمس تقول فيه ما نصه: "يشق علينا أن نسمع أخبار ما يقاسيه جنودنا المظفرة من المشاق في مغاور السودان".
وتحت عنوان "حالة الجيش المصري في السودان" تستطرد جريدة المؤيد قائلة:
"فليت شعري هل كان لنا حاجة لأن يؤدي الجيش الخدمة في أصعب الأحوال على غير الاضطرار؟ وهل كانت ضرورة ما لركوب هذا المركب الخشن وسوق الجيش إلى الصحراء، لا يستنشقون فيها الهواء إلا حاميًا كأنه يهب من الأتون، ولا يشربون الماء إلا سخنًا يكاد يحرق الأفواه، ولا يأكلون طعامًا إلا غليظًا متبلًا بالتراب والغبار؟ ومع ذلك لا تنفق عليهم الحكومة الكفاف من العيش في مثل هذه المعيشة النكداء، فلم تنصفهم على الإطلاق. وهي مع ذلك تحملهم من ضروب العناء ما لا يطاق.
وهل قال "المؤيد" في جميع ما ذكره إلا أن الوقت لم يكن مناسبًا لسوق الجنود إلى صحراء السودان؟ وإن حالة المالية المصرية لا تساعد على مثل هذه الحروب الهجومية حيث لم ترغمنا عليها إلا المصلحة الإنكليزية؟
لا شك أن الحكومتين البريطانية والمصرية قد جنتا أعظم جناية على جيشنا البئيس الذي يقاسي الآن العذاب ألوانًا؛ الأولى لتقريرها الحملة السودانية في فصل غير مناسب وعلى غير استعداد، والثانية لمتابعتها لها في هذا الأمر بلا حساب عاقبة. والله يصلح المغبة ويحسن المآل".
لم يكن في استطاعة السلطات البريطانية وجريدة المقطم الاستمرار في الجدل مع المؤيد حول سوء حال الحملة وجنودها، فحوّلوا معركتهم ضدها إلى معركة حول الأخلاقيات الصحفية وعدم مشروعية نشر التلغرافات السرية. وحركت الحكومة دعوى جنائية ضد صاحب "المؤيد".
تابعت المقطم نشر تطورات القضية، ذاكرة عزم النيابة على المجيء إلى مكتب تلغراف الأزبكية لتحقيق قضية التلغرافات "المسروقة" التي نشرتها المؤيد
ولكن نظارة الحربية أكدت صحة المعلومات التي ساقتها "المؤيد" عندما اعترفت بأن ما نشر كان برقية مرسلة من السردار إلى ناظر الحربية في مصر، وهذا ما اعتمدت عليه في تحريك الدعوى ضد صاحب "المؤيد"، وهو ما حرصت "المقطم" على إبرازه ومتابعته حتى أنها انفردت دون سائر الصحف المصرية بنشر التفاصيل على النحو التالي:
"علمنا من تفاصيل المحادثة، التي نسمع عنها كل يوم نبأً جديدًا، أن مكتب تلغرافات الأزبكية اكتشفها على هذه 'الصورة'. أرسل سعادة ناظر الحربية موظفًا في نظارته إلى مكتب تلغراف الأزبكية يقول إن سعادة السردار أرسل إليه تلغرافًا طويلًا استلمه بيده ثم أبقاه في منزله ولم يُطلع عليه أحد غيره في ذلك اليوم.
ثم صدر ’المؤيد‘ وفيه ترجمة للتلغراف.. واتفق أن شخصًا آخر مستقلًا من الحكومة ولا علاقة له بها قابل حضرة مدير مكتب التلغراف أيضًا وشكا إليه أن تلغرافًا جاءه قرأه منشورًا في المؤيد كلمة فكلمة بين تلغرافاته الخصوصية، وقد ادّعى أن مكاتبه أرسله إليه.
فلما سمع مدير التلغراف كلامه راجع صور التلغرافات التي وردت في ذلك اليوم فوجد أن التلغراف الذي نشر في ’المؤيد‘ لم يرد عليه من أحد وإنما ورد على الشاكي فأيقن حينئذ أن التلغرافين المذكورين قد سُرقا من مكتبه".
وبعد أسبوع، تابعت "المقطم" نشر تطورات القضية، ذاكرة عزم النيابة على المجيء إلى مكتب تلغراف الأزبكية لتحقيق قضية التلغرافات "المسروقة" التي نشرتها "المؤيد". وأن مجلس إدارة سكة الحديد والتلغراف طلب محاكمة السارق وشريكه، والحكم على الفريقين بحسب مقتضى المادة 145 من قانون الجنايات، التي تنص على الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، على كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريتها أو فتح مكتوبًا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره، وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريتهما تلغرافًا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة وأفشاه أو سهل ذلك لغيره.
وتحت عنوان "سرقة التلغرافات" عاودت "المقطم" نشر أنباء القضية، حريصة على إبقائها حية مثارة، وسردت تفاصيل البلاغ المقدم من نظارة الحربية إلى النيابة العمومية بخصوص تلغراف السردار "الذي سرق من مكتب تلغراف الأزبكية ونشر في ’المؤيد'".
وبينما حرصت "المؤيد" على نفي التهم الموجهة إليها، نشرت المقطم اتهامًا جديًا لموظف مكتب التلغراف توفيق كيرلس أفندي، والشيخ علي يوسف صاحب "المؤيد" بسرقة برقية مرسلة من مكاتب المقطم في ببا، ونشرها.
البطل المعروف مقابل الجندي المجهول
استمرت المعركة الصحفية بين الجريدتين. وحرصت "المؤيد" على تأكيد إصرارها وعزمها مواصلة تقصي أنباء حملة دنقلة ونشرها، واستمرت أيضًا في إنكار تهمة سرقة التلغرافات، مؤكده براءة موظف مكتب الأزبكية، من دون ذكر اسمه:
"يظهر أن ’المقطم‘ قد أصيب بدوار شديد من الحمى فصار يهذي أشد الهذيان فيما يكتبه عما يسميه سرقة التلغرافات ويدعو مصلحة التلغرافات أو السكة الحديد لطلب محاكمة ’المؤيد‘ الذي نشر منشور السردار أو تلغرافه عن أحوال الجيش مما لم يعلم به أحد سواه.
كأن جلب الأخبار التي تبالغ نظارة الحربية في كتمانها لإفادة الأمة المصرية بمجريات الأحوال التي يهمها الاطلاع عليها يعد من قبيل سرقة النقود بوسائل النصب والاحتيال حتى تطلب محاكمة صاحب 'المؤيد' كما تطلب محاكمة النصابين.
وسيرى أصحاب ’المقطم‘ وشعبيتهم في نظارة الحربية أن ’المؤيد‘ مقتفٍ آثار الحملة وأخبارها ليفيد الأمة بكل ما يهمها من خفايا الأمور وخبيئات الأعمال خدمة للوطن العزيز ولو حاكموا كل موظف في الحربية ومصلحة التلغرافات وليقل ’المقطم‘ ما يقوله صياحًا وولولة وعويلًا".
احتفت الجماهير ببراءة الشيخ علي يوسف في مظاهرة وطنية حاشدة على باب المحكمة، في وقت كان توفيق كيرلس يعاني فيه من النوم على البرش راسفًا في أصفاده وأغلاله لمدة ثلاثة شهور
اشتعلت الحرب بين الجريدتين؛ فالمقطم تنشر عبارات تدين بها "سرقة" التلغرافات، و"المؤيد" تسوق أثناء ردها تلميحات حول تقاضي المقطم أموالًا من السلطات البريطانية. بل اتهمت "المؤيد" نظارة الحربية وجريدة المقطم بتخصيص موظف رسمي لتزويد الأخيرة بأنباء الحملة، فقالت:
"هل يمكن للمقطم، إذا استحلفناه بذمة أصحابه وشرفهم ونزاهتهم، أن ينشروا لنا اسم مكاتبه المرافق للجملة حتى يعلم القراء إذا كان موظفًا بمرتب من إدارة الجريدة أو من مستخدمي الحربية الذين يُنقدون مرتباتهم من أموال الرعية ليؤدوا فيها وظائفهم بالأمانة، لا أن يكونوا عمال جرائد سرًا وموظفين في الحربية جهرًا...‘‘.
أثارت هذه القضية الرأي العام في مصر، حتى إن قاعة المحكمة ضاقت بمن فيها بينما حشود الجماهير التي أحاطت مبنى المحكمة متلهفة إلى معرفة ما يدور داخل القاعة. وتجنبت جريدة المؤيد نشر نص الحكم الذي يبرئ الشيخ علي يوسف ويدين توفيق كيرلس، موظف مكتب التلغراف، بينما نشرته "المقطم" وضمنته تعليقه الذي يوحي فيه باستئناف النيابة لهذا الحكم:
"حكم قاضي محكمة عابدين الجزئية أمس بالحبس ثلاثة أشهر وبالحرمان من وظائف الحكومة خمس سنين على توفيق كيرلس، مستخدم التلغراف، لأنه أفشى تلغراف السردار، وبرأه من سرقة تلغراف المقطم. وحكم ببراءة سماحة علي يوسف صاحب ’المؤيد‘ من المشاركة في تلك السرقة. وبقي الحكم الأخير في هذه القضية لمحكمة الاستئناف الأهلية؛ لأن النيابة لا يمكن أن تقبل هذا الحكم، بل لا بد لها من الاستئناف".
غير أن الحكم الصادر من الاستئناف الأهلي صدر مؤيدًا لحكم محكمة عابدين الجزئية، "واستقبلته الجموع التي احتشدت حول مبنى المحكمة بمظاهرة وطنية شعبية وصفقت وهللت للشيخ (المقصود الشيخ علي يوسف) وأقبلت عليه تهنئه"، بحسب ما ورد في جريدة مصر بتاريخ 21/12/1896.
أحدثت هذه القضية أثرها في الرأي العام المصري كما كان لها رد فعل قوي في الدوائر الرسمية، إلى حد جعل القائد البريطاني الشهير كتشنر، سردار الجيش المصري، وهو وسط مسؤولياته الجسيمة خلال قيادته للجيش الزاحف نحو الجنوب، يضع في اعتباره موقف الصحف المصرية من الحملة، وبصفة خاصة موقف "المؤيد" وصاحبها الشيخ علي يوسف.
فبعد تجريدة دنقلة، حرص أن يرد على الشيخ علي يوسف خلال حفل تكريمه الذي أقامه له اللورد كرومر في القاهرة. وذكر صلاح قبضايا في كتابه اقتباسًا من كلمة كتشنر التي يشكر فيها اللورد كرومر ما يؤكد ذلك.
وهكذا قفز اسم الشيخ علي يوسف إلى الصدارة، وحُفر في ذاكرة التاريخ، وهو صاحب معارك سياسية واجتماعية أخرى هزّت الأوساط الثقافية والسياسية في مصر في الربع الأول من القرن العشرين. لكن البطولة المركزية التي اقترنت باسم الشيخ في قضية التلغرافات لازمها تهميش وإقصاء لاسم الجندي المجهول في هذه المعركة، وهو توفيق كيرلس أفندي، مستخدم التلغرافات بمكتب الأزبكية.
احتفت الجماهير ببراءة الشيخ علي يوسف في مظاهرة وطنية حاشدة على باب المحكمة، في وقت كان توفيق كيرلس يعاني فيه من النوم على البرش راسفًا في أصفاده وأغلاله لمدة ثلاثة شهور، خرج بعدها محرومًا من الوظائف الحكومية لمدة خمس سنوات. ولم نقرأ أن الشيخ علي يوسف استوظفه في جريدته أو كتب عنه شيئًا أثناء حبسه، أو حتى بعد خروجه.
سؤال الضمير المعاصر
السؤال هنا، كم من توفيق كيرلس في سيناء؟ وكم من توفيق كيرلس في تركيا وفي الصين وفي إيران؟ كم من توفيق كيرلس أمدّ الصحفيين في مناطق الخطر والأحداث الحرجة بما اشتهروا به، ثم نالهم من الضرر ما يفوق الأذى الذي أصاب الصحفيين والحقوقيين، فإذا بمن يُفترض أن يكونوا خارج إطار الصورة قد دخلوها، أو نُقلت العدسة وغُيّرت الزاوية ليكونوا هم في صدارة الصورة على حساب انزواء أصحاب القصة من المشهد؟
هل نقبل أن تتحول شبكات التضامن المهني والحقوقي إلى "شِلل" تمارس التهميش ضد الضحايا المغمورين، فإذا بالشهرة تكون من نصيب من أراد تسليط الضوء على القضايا، لا على القضايا ذاتها؟
وهل ينبغي لمن هم في مثل موقفي أن يصدقوا أن مكانهم في مركز القصة؟ وعلى حساب مَن؟ فإذا قبلنا بذلك، فما وجه اختلافنا عن السلطة الديكتاتورية؟ وما البديل الاجتماعي السياسي الذي يشغل خيالنا إذن ليحل محل سياسات الأنظمة التي نعارض سياساتها، أو حتى وجودها؟
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.
