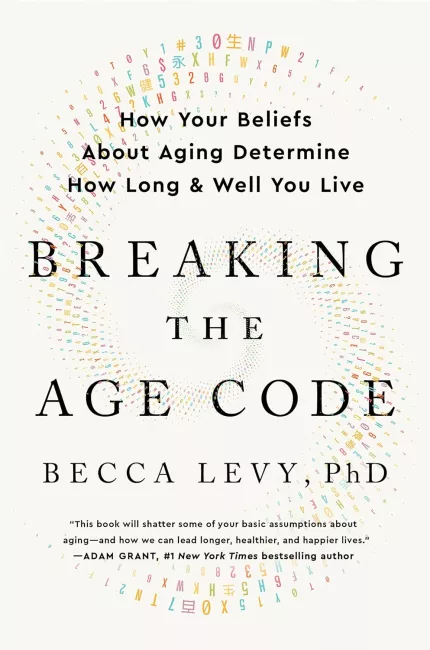عمرو دياب وأوهامنا عن الشيخوخة
لم أستغرب تعمُّد استخدام صورة عمرو دياب في تقبيح التقدم في العمر، فهو للأسف أمر راسخ في ثقافتنا. لكن ما أذهلني هو الغفلة العامة عن أن هذا لون من التمييز، لم ينتبه الكثيرون إلى ما يضمره الكلام المتداول من تمييز على أساس العمر، فلعلها فرصة لدعوة مجتمعنا إلى مراجعة قناعاته والمسارعة للحاق بالأمم المتقدمة، والعمل جديًا على تضييق الخناق على تلك الممارسات التمييزية.
ليس الحال وحسب أن المعلقين تعاملوا بأريحية مع أمر يسبب الأذى النفسي والحرمان والتهميش لفئة معتبرة من المجتمع المصري تشكل 6.6% من مجموعه، بل أيضًا أمر يحرم مجتمعنا من مورد مهم وقدرات بشرية معتبرة.
هذا الكم من ميمز السخرية من الآباء ومَن هُم أكبر، تمر وكأنها سخرية لطيفة، ومثلها ما نجده في الصياغة المتفاكهة التي ترميها في وجوهنا إعلانات كريمات إزالة التجاعيد وأمارات التقدم في العمر. كذلك تبرز إيفيهات الأفلام عن "تصابي" الكبار من النساء والذكور، والسخرية من بطء العجائز وخرفهم!
قد تبدو جميعها أحاديث عادية، لكنها تضمر في الحقيقة قدرًا هائلًا من ركام الصور النمطية غير الدقيقة عن معنى التقدم في السن وصولًا إلى ما نسميه بالشيخوخة والعجز. وقبل أن يقول قائل إن التمييز لا يقتصر على الكبار في السن، وإنما هناك مبادلة للصور السلبية حيث يعمد الكبار لترويج صور تهمش الشباب وتصم المراهقين، أقول إنه صحيح، لكن ما يهمني في هذا المقام هو تلك الصور الذهنية عن الكبار سنًا، وتحويلهم لهدف للإيذاء والتنميط السلبي، على نحو ما جرى لفنان معروف مثل عمرو دياب.
جملة من الصور الكاذبة
تؤكد الدراسات الأثر المدمر لتنميط صورة الكبير في السن، وتزيد بأن توضح لنا بجلاء كيف نروج لأكاذيب محضة عن فئة اجتماعية كاملة. منذ عقود، تُولي علوم النفس والاجتماع والإعلام اهتمامها لتلك الظواهر السلبية، وقطعت خطىً واسعةً في مواجهتها، عبر تقديم بيانات ومعلومات حقيقية عن الشيخوخة وماهيتها وسبل التعامل معها. وتطور من هنا مفهوم جديد عن ظاهرة التمييز على أساس السن، وأدرجت ضمن مفهوم التنوع الذي تحرص الحركات الحقوقية على إبرازه كقيمة اجتماعية، وأساس لفهم الحقوق والحريات.
المعتقدات المتفشية عن الشيخوخة تتناقض مع العلم وتغفل عناصر الامتياز التي تصاحبها
تبرهن هذه الدراسات على أن أثر التمييز استنادًا إلى التقدم في العمر لا ينعكس سلبًا فقط على من يتعرضون له بل على المجتمع كله. وكون هذا النوع من التمييز متجذرًا ومتأصلًا في معاييرنا للتصنيف الاجتماعي، التي تقوم على وصم من يتقدم في العمر بتدهور صحته الجسدية والعقلية، حتى قبل أن يظهر ذلك عليه، وأحيانًا في أوقات يكونون فيها في حال مُثلى نسبة لأعمارهم.
ولا ينطلق المنطق الحقوقي هنا من تراثنا الأخلاقي المتوارث الذي يحض على توقير الكبار والاعتراف بفضلهم بعد أن "فات قطار العمر"، بل هو في جزءٍ منه يتحدى هذه النظرة الراسخة ويبين أنها لا تعكس الحقيقة دائمًا، بل توظَّف في كثير من الأحيان كستار تمييزي، دون أن يهدر القيمة التي تنطوي على هذا الإرث الأخلاقي بالطبع.
هنا، يجب التنبيه لنتائج الأبحاث التي تشير إلى أن المعتقدات المتفشية عن الشيخوخة وكبر السن تتناقض مع الحقائق العلمية، وتغفل عناصر الامتياز التي تصاحب التقدم في السن. تشدد الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وهي إحدى الجهات الرائدة، في تقرير نشرته العام الماضي، على أن التركيز على تراجع القوة الجسمانية يهيل ظلالًا كاذبة على قدرة الأكبر سنًا على الإبداع، حتى بات الناس عند سن معينة يصدقون أنهم كذلك فعلًا.
عمرو دياب، المولود في خريف 1961 ويبلغ عمره اليوم 62 عامًا، دليل حقيقي وجيد على خواء هذه النظرة السلبية وما يترتب عليها من تمييز. الحقيقة أن الفنان الستيني، بما يُبرزه من نشاط واضح ودأب واستمرار في العطاء، لا يمثل طفرة. ففي مثل سنه بلغت أم كلثوم الكمال والنشاط المكثف في الستينيات، ومثلها أيضًا تألق عبد الوهاب لذروته. وحتى أقرانه من نفس الجيل يُظهرون تألقًا لافتًا، يجعلنا نراهم في ذروة تجربتهم الإبداعية، مثل مدحت صالح الذي يكبره بعام، وعلي الحجار الذي يطرق باب عامه السبعين، وماجدة الرومي وقد تخطت عامها السابع والستين.
كسر شفرة العمر
في كتاب يحمل عنوانًا لافتًا هو كسر شفرة العمر: كيف تحدد معتقداتك عن الشيخوخة مدة حياتك وكيفية عيشها، تكشف الكاتبة الدكتورة بيكا ليفي عن "دستة" من التصورات الخاطئة الشائعة عن التقدم في السن.
تبرهن ليفي على التناقض بين ما نحمله من معلومات ترتسم بموجبها الصورة النمطية السلبية عن الكبار وبين حقائق العلم. الكتاب لا يعلِّمنا فقط عن خطأ التصورات، بل يسلط الضوء كذلك على مكامن التميز التي يحملها التقدم في السن".
يشدد الكتاب كذلك على أهمية تمييز "الهِرَم" وفترة الاقتراب من خط النهاية، وهي لحظة قَدَرية يجب الاستعداد لها على كل حال، عن النقاط السِنيَّة المحدَّدة التي وُضعت بتعسف تام، وبصيغة تحكمية تمامًا، لترسيخ التمييز ضد من بلغها باعتباره عالة.
قد يندهش بعضنا أن كثيرين ممن بلغوا أقصى نقطة في "منحنى السعادة"، وهذه ليست عبارة أدبية وإنما مفهوم علمي، كانوا في سن اقتراب الشيخوخة وفق تصنيفنا التقليدي!
ويُلمِّح العالم كارل بيليمر، الأستاذ المتخصص في علم نفس الشيخوخة بجامعة كورنيل، إلى ما نعته بـ"مفارقة الشيخوخة"، مبرهنًا على أن نقطة الوصول للسعادة تقع في عمر متقدم، وفق ما يُظهره كبار السن من السعادة والرضا عن الحياة مقارنة بحالهم وهم أصغر سنًا، ومقارنة بفئات عمرية أخرى.
الأمر ليس نتاج يأس أو رضا بالقليل، على ما قد يتصوره البعض، بل هو قياس علمي مقارن ومقدر بقياسات تجريبية. ويشدد على أن ثمة نضجًا نفسيًا وتصاعدًا للقدرات العقلية ومدركات تعكس الخبرة والتجربة، ومزيدًا من الفهم والاستيعاب.
تركز السخرية من عمرو دياب المهتم بصحته، على أنه "يجري عمليات تجميل وشد للوجه"، وهو ما يتناقض مع أن اهتمام الأكبر سنًا بصحتهم أمر طالما حث عليه العلماء. كل خطاب يصور ذلك باعتباره أمرًا سلبيًا خطاب تمييزي وسيئ. لا يجب أن يكون النشاط البدني والاهتمام بالصحة سببًا لوصم كبار السن أو السخرية منهم على الإطلاق.
ومن بين طيات هذه الصور السخيفة ينتج الضرر. ربما عمرو دياب في حال أفضل من الكثير من كبار السن، فغالبهم يعانون في مجتمعنا من تصورهم وكأنهم عبء. كذلك فإن الأذى النفسي يصاحبه في العادة حصار يعوق قدرتهم على الإسهام في نماء وتقدم المجتمع، وهي قدرة لم تنضب بعد.
أصحاب الخبرات مورد مهم، واستيعابهم ليس رفاهية أو مجاملة لأي نظام اقتصادي، بل إن التسرع بإحالتهم إلى التقاعد لمجرد "بلوغ السن القانونية للتقاعد" يهدر الكثير من القدرات. من هنا تجدُّ المجتمعات المتقدمة في إيجاد السبل لتوظيف هذه الطاقة الإبداعية والتنفيذية، بدءًا من نظم التطوع لسياسات الدمج في أنشطة خدمة المجتمع، لتوجيه جهود الأكبر سنًا لمجالات العمل والخدمة التي تحتاج لقدراتهم.
في بلادنا، نجد أن النظم متساهلة مع التمييز ضد كبار السن، رغم الهالة الخارجية لرعايتهم. هذه النظم تدفع على سبيل المثال العاملين في الخدمات لتجنب التعامل مع تلك الفئة، ولدينا دلائل على أن الثقافة السائدة تعرقل وصولهم إلى خدمات العديد من الأقسام الطبية، بل ونجد تجنبًا من مقدمي الرعاية الصحية للعمل في بعض الوحدات لمجرد أن المتعاملين فيها من الأكبر سنًا. وهناك تساهل في تقديم علاجات أقل ملاءمة للحالة الفعلية للمريض إن كانت سنه متقدمة.
على صعيد التثقيف الاجتماعي والاتصال الجماهيري، لا تزال الرسائل الاجتماعية التي نبثها في كل وسيلة تواصلية عن الأكبر سنًا والموصوفين بالشيخوخة مثقلة بقدر كبير من الأذى. تبرهن الدراسات على أن الذين تحاصرهم هذه الصور السلبية يكونون أكثر عرضة للإحباط، وأنهم ينسحبون ويرضون بالإقصاء، والعكس صحيح تمامًا.
تنبهنا دراسة نشرتها مجلة Nature العلمية الشهيرة قبل عامين، إلى ورطتنا في اجتزاء الحقيقة جراء تلك الصورة الشهيرة عن تباطؤ أداء الكبار، وهو أمر صحيح على المستوى الجسدي، لكن سحبه على القدرات الأخرى يظل من قبيل ترسيخ الصور الكاذبة. فعقليًا الحال ليس واحدًا إذ ثبت أن مفهومنا السائد عن تراجع التركيز والانتباه مع كبر السن مغلوط.
يتحول التركيز الشديد لميزة واضحة مع السن وفق نتائج الدراسة التي أجراها العلماء جواو فيرسيمو وبول ويرهيجن وآخرون، التي تؤكد بوضوح أن من هم في سن عمرو دياب، بل والأكبر منه، يقل تعرضهم للتشتت قياسًا بمن هم في منتصف العمر والأصغر سنًا. وأن الكثير من القدرات المعرفية تتحسن مع الخبرة وتنضج لمستويات إبداع فائق، وتنعكس على الوظائف التنفيذية. بل حتى تلك الوظائف التي قد تتراجع نتيجة للتقدم في العمر ظهر أن بالإمكان تحسينها إذا توافرت عوامل مجتمعية مساعدة.
تنبهنا طفرة هذه الأبحاث إلى قناعات جديدة من الواجب أن تغير نظرتنا، منها نظرية بوسنر وبيترسن عن العوامل المؤثرة في الانتباه، وهي دراسة أجريت على من يراوحون بين سن 58 و98 سنة، وبينت أمرين مهمين: أن انخفاض كفاءة الانتباه مع التقدم في العمر يوازنها بشدة الارتفاع الملحوظ في كفاءة التوجيه والتنفيذ، ذلك على الأقل حتى منتصف السبعينيات وإلى أواخرها. وأن هناك تباينًا كبيرًا في تلك التغيرات المرتبطة بالعمر، سواء وظائف الانتباه والتركيز أو غيرها، فقد يتراجع بعضها فيما يتطور بعضها الآخر.
نضال ضروري
ظني، كحقوقي، أن هناك تقصيرًا منَّا نحن الحقوقيين، إذ يجدر بنا البدء في رصد تلك الممارسات التمييزية المستندة إلى السن، بخاصة الموجهة ضد الكبار، والتنبيه للصور التنميطية التي تنتجها والسياسات التمييزية التي تنتهجها.
ومحل النضال الكبير في مجال النظم والسياسات بات ضروريًا؛ في الممارسة قد يسود ظن بأن هذا النوع من التمييز قاصر على تفاعلات الأفراد التي تقوم على الصور الذهنية السلبية التي قد تنتهي بأن يتبنى الشخص تصورات مغلوطة عن نفسه. لكن الكثير من قناعاتنا وقناعات الأجيال الأسبق سكنت في النظم والتشريعات والإجراءات.
من هنا تنشأ مهمة على الحقوقيين، تبدأ أولًا بالوعي وإثارة الانتباه المجتمعي لهذا الشكل من التمييز، ويتبع ذلك العمل مع المجموعات الاجتماعية والمؤسسات الأهلية والعامة على إصلاح الأنظمة التمييزية. السن بات قضية تنوع مهمة، حين ننبه لها الناس سيتمكنون من رؤيتها والانتباه لآثار التمييز الذي نتورط فيه جميعًا أفرادًا ونظمًا.
ولكي ينفتح السبيل أمام مواجهة مع جذور التمييز الممنهج فإننا بحاجة لأن نسمع صوت علماء الشيخوخة في الطب وعلمي النفس والاجتماع، ونتعلم مفاهيم جديدة مثل مفهوم انتقال الأدوار بما ينطوي عليه من تحدٍّ لافتراضاتنا الأساسية نحو "الشيخوخة" وحالة "العَجَز"، وهي مفاهيم تبرر إحالة قطاع معتبر من المجتمع إلى "المعاش".
التقدم في العمر هو انتقال للأدوار، لا يستوجب معاملةً مختلفةً تنطلق من تصورات تلاشي القدرات الذهنية والجسدية، ولا يقتضي تكوين لغة مهينة تعكس تمكن الصور الخاطئة عن هؤلاء. ويجب الانتباه لنوعية المشاعر التي تحويها تلك الانتقالات العمرية، وفهم كيفية التعامل معها، واستيعابها على النحو الذي نفعله مع كل مراحل السن الأخرى.
محاربة المفاهيم الخاطئة والمعتقدات السلبية ستفتح الباب لتغييرات في النظم، بما يستوعب الحقائق الجديدة، وبما يفسح مجالًا واسعًا لتحقيق عدالة اجتماعية للكبار ومنع تهميشهم وإقصائهم.
وإذ نقول هذا فإن السؤال سيحلق من فوقنا عن فجوة البحوث بيننا وبين العالم المتقدم؛ يجب أن نعترف أن قطاع البحوث لدينا متأخر في تعامله مع مساحة باتت تشهد طفرات ملموسة، انعكست بجلاء على الأنظمة الصحية في البلدان الغربية، وتراكمت فيها منذ ثلاثة عقود على الأقل البحوث والنظريات التي غيرت الكثير من وجهات النظر. وحتى الطفرة هذه بات ينظر إليها، خصوصًا بعد الجائحة، بأنها ليست كافية، وأن التمييز ضد كبار السن ما زال قائمًا. فترى ما حالنا ولم نبلغ بعد حدًا أدنى منها؟
أي طفرة ترأب الفجوة العلمية في مجالات طب الشيخوخة وعلم نفس الكبار ستفتح السبيل واسعًا أمام الأبحاث الاجتماعية الجدية التي يمكنها بيان مواضع الانحياز بدقة، واستشعار الأثر من هذه الرؤى والمفاهيم المغلوطة وما يترتب عنها من الممارسات. وبالطبع التعليم والتثقيف ساحة مهمة جدًا لمناهضة هذا اللون من التمييز. والبدء من المدرسة أولوية؛ فلا يجب أن تحمل الأجيال القادمة هذه الانحيازات، بل أن تتطور معتقداتهم إزاء السن والشيخوخة، ليعملوا على توسيع الفرص أمام الجميع، الكبار قبل الصغار.
أما النظم التشريعية ونظم العمل فهي ساحتنا لإثبات إمكانية التطور صوب مجتمع أكثر عدالة؛ وهي المجال لترجمة وعي المجتمع وعمله على إصحاح الصورة. سيكون من الضروري العمل على كل ما يحرر كبار السن من غوائل الإقصاء الاجتماعي في مجالات العمل والرعاية، وأن تستفيد من نواتج البحوث في تبين سبل بناء مجتمع مستوعب لكبار السن ولا يلفظهم ويضمن فاعليتهم الاجتماعية.
أخيرًا، هل علينا أن نقول إن الأمر بحاجة لحركة اجتماعية حقيقية، تلغي هذا التمييز وتعيد المجتمع لعدالة باتت مفقودة؟