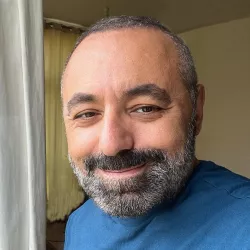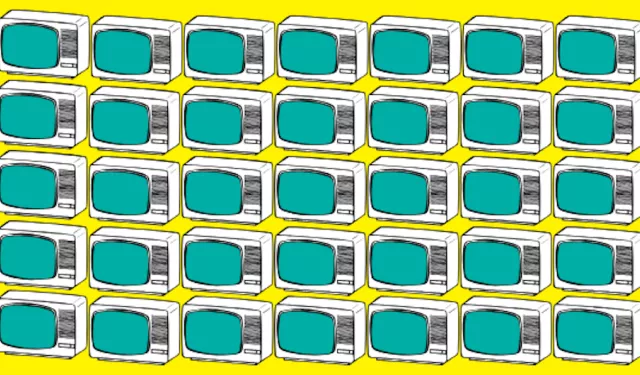
إخراج الدراما من قولون العالم
والزفت أقوله يا زفت فى عيونه
بعض أصدقائي يعشقون الدراما التليفزيونية إلى حدِّ التفرغ لمشاهدة كل مسلسلات رمضان، في عملية لاهثة تبدأ أول أيام الشهر، يقررون بعدها المسلسلات الأَوْلى بالمتابعة، وبعضهم تنتهي عنده التصفية النهائية باختيار خمسة أو ستة مسلسلات، يتابعونها على مدار اليوم الواحد.
حين أسألهم من أين أوتيتم القدرة على متابعة عشرات الأعمال في وقت واحد؟ يأتي الرد بأنَّ مشاهدة الحلقات الأُولى أشبه بـ"المسح الأوَّلي" الذي تعقبه عملية اتخاذ القرار. في هذا المسح يُقيِّمون بشكل سريع جاذبية العمل البصرية، وسرعة إيقاعه وكثافة حواره، وكذلك جماهيريته، فالمشاهدة في الأخير أصبحت ممارسةً اجتماعيةً تُشاركنا فيها السوشيال ميديا.
وهنا أقاطعهم بسؤال آخر عن مدى سعادتهم خلال تلك العملية الآلية، ليأتي رد بعضهم يحمل خليطًا من الضجر والسخرية من سؤالي نفسه، باعتباره نوعًا من الحذلقة.
أدرك وقتها أننى بصدد كابوس ممتد، يفسر إحجامي عن متابعة الأعمال الرمضانية منذ زمن طويل، فأصدقائي هؤلاء لم يعودوا مُتلقِّين، بل "عمال مشاهدة" يكابدون مشقة المتعة المرجوة التي لا تأتي أبدًا، لم يعودوا هم المستهلِك، بل السلعة التي يتم استهلاكها.
لا نحتاج للكثير من التأمل لندرك أننا في زمن تتزايد فيه معدلات ما يسمى بـ short attention span أو الانتباه قصير المدى، نظرًا لامتلاك الإنسان المعاصر عددًا من وسائط التشتت البصري وأهمها الموبايل، بما فيه من تطبيقات للصور الثابتة والمتحركة، بحيث أصبح الصراع الشرس والمحموم على انتباه المستهلك/السلعة عملية منزوعة الرحمة والحب والقبول.
لقد أصبحت عملية إخضاع وسيطرة بالأساس.
لست استثناءً من العملية بالتأكيد، ففضولي الشخصي دفعني لمشاهدة عدد من مسلسلات محمد رمضان واسعة الانتشار، عبر بعض الفيديوهات المكثفة لملخص لمسات حبيشة ورفاعي الدسوقي ورضوان البرنس وجعفر العمدة.
شاهدت كيف أشبع الخصوم ضربًا، وسَبَى النساء وحده، وهزم الذكور من المشاهدين بتذكيرهم الدائم والمستمر بأنه ذكر الشاشة المتحقق في واقع لبس فيه جميع الرجال "الطرحة"، باستثناء حكامهم المسلحين بالجهل والدبابة.
لستَ حرًا.. بل أسير شاشتي أنا
في زمن الشريط السينمائي الجماهيري، كانت الخلطة المحبوكة هي المكون الرئيسي في صناعة وتسويق الفيلم التجاري. يذهب المشاهد بإرادته الحرة ويدفع ثمن تذكرة السينما من أجل مشاهدة نجومه المفضلين وهم يقدمون له ما يريد؛ بداية ودراما وعنف وجنس وضحك ثم نهاية سعيدة.
كانت هذه العملية حرة ورضائية، الجمهور فيها صاحب القرار والإرادة، وكان يحطم صالات السينما غضبًا إذا لم يقدم له فريد شوقي وجبة المعارك الطويلة التي ينتصر فيها وحده على الأشرار، فيما يتعالى هتاف "سيما أونطة هاتوا فلوسنا".
اختلف الأمر كثيرًا مع دخول التليفزيون، فالإعلام الوطني ظل لعقود طويلة يقرر ما سيشاهده الناس وفقًا لأجندته وأولوياته ومعاييره، وعلى المبدعين التكيف مع هذه الاشتراطات والعمل داخل خطوطها المرسومة. وما على المتلقي إلا القبول الراضي أو الانصياع الصاغر أو الرفض العصبي، على طريقة تحريم مشاهدة التليفزيون لأسباب دينية وعقائدية.
كان هذا في زمن البرنامج الإعلامي الموحد للدولة الوطنية التي تحتكر المؤسسات الإعلامية من خلال عدد محدد من القنوات، تبث برامجها في ساعات بعينها خلال اليوم.
لكن في ظل انفتاح الأسواق والسماوات مع نهاية التسعينيات، زاد عدد المنتجات إلى حدودٍ يصعب حصرها، وبدا أنَّ للمشاهد قدرةً على الاختيار والمفاضلة بين المعروض الوفير، وفقًا لاهتماماته وأولوياته. وبالطبع كانت هذه فترة قصيرة ومؤقتة مثلها مثل زمن الإنترنت الحر المتاحة مادته بدون حقوق ملكية فكرية.
يقف ليبراليو العالم وحدهم الآن داخل أسوار سجن المربع الواهم بشأن المنافسة الحرة الممتدة، فالمنافسة الحرة المبدعة تشتد في بدايات دورة المنتجات الجديدة، لكن سرعان ما تدخل الرساميل الكبرى لتدك الأسوار والحصون وتحتكر المشهد، إما بضخامة الإنتاج أو بالاستيلاء الكامل على أدواته، وأخيرًا عبر إعادة خلق المستهلك نفسه على شاكلة المنتج التي تقدمه.
وفي الزمن الجديد، حيث المنافسة على انتباه المستهلك/السلعة من داخل المنصات الاحتكارية، أضحى معيارُ نجاح الحبكة التليفزيونية قدرتَها على سلب انتباه المشاهد لساعات طويلة، في منافسة شرسة مع عشرات الأعمال المتشابهة التي يملك المشاهد قدرةً على التحكم في توقيت مشاهدتها وإيقافها واسترجاع مشاهد منها.
بين الاحتكار الأمني والاحتقار الذهني أصبح ما يُسمَّى "منتجًا فنيًا" في مصر تجسيدًا كابوسيًا لمخرجات القولون الملتهب
هذه العملية تصبح فيها سيطرة "الصُنَّاع" على المُشاهِد أولوية قصوى، فمن يمكنه هجر منتجي الدرامي بالتشتت أو الملل، عليَّ الاحتفاظ به بكل الوسائل وبأشدها تطرفًا وبدون أيِّ رضائية منه، عبر مداعبة غروره وخيالاته وضعفه ومخاوفه في أعمق مكامنها، للاحتفاظ به أسيرًا أمام شاشتي أنا.
لنعد إلى وادينا الطيب
مصر بالطبع ليست استثناءً في هذا العالم، لكنها في مؤخرة قولونه الملتهب، حيث يجتمع الاحتكار مع السلطوية مع استمراء الرداءة مع معاداة الفن وكل ما هو رمزي ومُركَّب، باعتباره إرثًا لثورة يناير التي نغَّصت على الجميع حياتهم.
وبين الاحتكار الأمني والاحتقار الذهني، أصبح ما يُسمَّى "منتجًا فنيًا" في مصر تجسيدًا كابوسيًا لمخرجات القولون الملتهب؛ رداءة مكتملة الأركان، وارتكان تام إلى حتمية استمرار تلك الرداءة، لأنه ليس في الإمكان أكثر مما هو موجود في ظل الشرط السياسي الحالي.
إحدى الحجج التي تستخدم في تبرير الرداءة هي أنها "متعوب عليها"، بمعنى أن هناك العشرات والمئات من العاملين الذين بذلوا جهدًا وسهروا الليالي وتقاضوا أجورًا من أجل "إنجاز" هذا المنجز و"إخراجه". والحقيقة أنَّ هذه الحجة يمكن استخدامها في معرض حديثي عن تنظيف مرحاض بيتي إذا اشتكى الجيران من رائحته، خاصة وأنَّ عملية الإخراج نفسها، بالمعنى الفسيولوجي هذه المرة، عملية "متعوب" عليها أيضًا، لو كان صاحبها مصابًا بالإمساك أو بمرضٍ في جهازه الهضمي.
هذه اللغة سميكة الجلد والوجدان، نُحتَت من وعي استمرأ مواجهة النقد الفني والجمالي لأي "محتوى" باعتباره جزءًا من صناعة، وكلمة "صناعة" هنا مهمتها إخراس كل الأصوات، فالصناعة تعني عملًا وعمالًا ورأس مال وماكينة، ولا يمكن لأحد الاستعلاء على كسب الأرزاق وإلا أصبح "نخبويًا متعاليًا".
يحدث ذلك فيما تسيَّد مصطلح "صناعة المحتوى" على لغة الإبداع المعاصر، وهو اللفظ الذي طالما أصابني بالكرب الشديد، مرة لكونه "صناعة" ومرة لأنه "محتوى"، فالصناعة كما قلنا علة استمرار كل رديء باسم تقديس الإنتاج في ذاته، كعملية تدويرٍ للرساميل وارتزاقٍ للعمال ودرٍّ لدموعٍ تنهمر باسم الحاجة، أما المحتوى، فهو ما تعبأ به الحاوية.
اجترحت العامية المعاصرة وصفًا أكثر صراحةً وصدقًا وهو "ملو"، من ملء، في توصيف بليغ يدرك أنها "عملية صناعية" غرضها تعبئة الفراغات في الداخل بأيِّ شيء، لتُوزن لاحقًا باللتر أو بالرطل. أحيانًا أتخيل محمد رمضان وهو يقول من موقعه كنامبر وَن "أديك في الحاوية محتوى.. أديك في الحاوية تحتوى"، في أحد انتصاراته صغيرة.
أكتب هذا المقال الغاضب، لا لشيء إلا لأؤكد لنفسي أنَّي لا أزال أملك القدرة على التذوق والبوح برأيي فيما أشاهد من حين لآخر، وأن أقول للزفت يا زفت في عيونه، ألَّا أنبهر بألوان مسلسل الحشاشين وأتغاضى عن ألمي وأنا أشاهد "ممثلين" يتفتفون اللغة من أفواههم، وأن أواجه الصامتين بصمتهم.
فلتعلنوا العصيان وأغلقوا التليفزيون، فياله من فعل ثوري هذه الأيام.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.