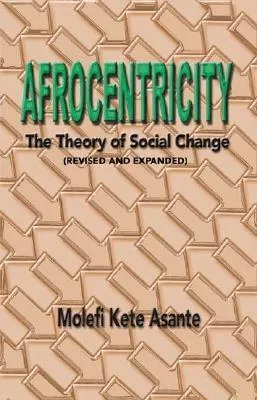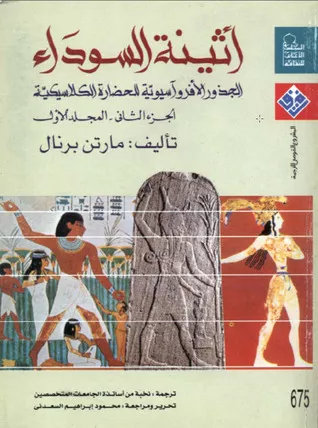في نقد "المركزية المصرية".. كيف نرى الأفروسنتريك؟
لماذا تخيفنا هوامش المركزية الإفريقية؟
في نهاية الشهر الماضي، جاء الإعلان عن إلغاء عرض للكوميديان الأمريكي الشهير كيڤن هارت في القاهرة لـ"أسباب لوچستية"، وكأنه استجابة لمطالب حملة كانت تدعو لمقاطعة العرض أو إلغائه. قوبل الخبر بحفاوة واسعة النطاق على السوشيال ميديا، بسبب ما نُسِب لصاحبه من تصريحات تتعلق بقضية المركزية الإفريقية.
يفترض أن هارت قال في وقت ما "يجب أن نعلِّم أبناءنا حقيقة تاريخ الأفارقة السود عندما كانوا ملوكًا في مصر وليس فقط حقبة العبودية التي يكرسها النظام التعليمي الأمريكي. هل تذكرون وقتما كنا ملوكًا؟". ورغم عدم وجود دليل على أن كيڤن هارت أدلى فعلًا بهذه التصريحات في أي وقت، فإن حملة مقاطعته لاقت صدىً واسعًا في الصفحات والمجموعات والدوائر المصرية المشغولة بمحاربة ما أصبح يعرف في هذه الدوائر بالأفروسنتريك (المركزية الإفريقية).
لا يُعدُّ ذلك الحدث الأول من نوعه، إذ شُنَّت في العام الماضي حملة عدائية مشابهة ضد جولة سياحية لمدة أسبوع لمعالم مدينة أسوان تصحبها بعض المحاضرات الثقافية تحت عنوان "إفريقيا واحدة: العودة للمنبع"، كان مفترضًا أن تنظمها شركة سياحية أمريكية. ادعى معادو تلك الفعالية من المصريين أنها مؤتمر ينظمه أنصار حركة الأفروسنتريك، ولاذوا بالسوشيال ميديا للهجوم على من نظموه وشاركوا فيه وشتمهم بأقذع الشتائم واتهامهم بالعنصرية والسرقة التاريخية وما إلى ذلك، مما أدى ببعض المشاركين في "المؤتمر" للاشتباك معهم.
ما لفت انتباهي في تلك المناوشات؛ المفاهيم المختزلة التي تبناها معظم المعادين من المصريين للمركزية الإفريقية أو ما يسمونه بالأفروسنتريك، وما يصاحب ذلك من مشاعر عنصرية معادية للسود وشوفينية قائمة على قناعات التفوق العرقي والحضاري والتأكيد على أن المصريين القدماء كانوا من ذوي البشرة "القمحية" وليسوا ذوي بشرة داكنة. وأننا، كمصريين معاصرين، نعتبر "الأحفاد المباشرين" للقدماء وامتدادهم الحضاري المباشر.
هذا المقال يمثل محاولة تقديم عرض تاريخي مختصر للمركزية الإفريقية ودعوة لتبني مواقف أقل مغالاة إزاء تلك القضية، بشكل يأخذ في الاعتبار كلًا من التحليلات التاريخية ذات الصلة والانحيازات السياسية التقدمية والمعادية للعنصرية.
جذور المركزية الإفريقية
تعود جذور المركزية الإفريقية إلى بدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة مع الإرهاصات المبكرة للحركات القومية للسود الأمريكيين. وفي أوائل ستينيات القرن الماضي، كان عالم الاجتماع والتاريخ الأمريكي الأسود الشهير دو بويز، يصك مصطلح Afro-centric للمرة الأولى كوصف للمشروع الذي أراد بدءه باسم "دائرة المعارف الإفريقية" Encyclopedia Africana على غرار "دائرة المعارف البريطانية" Encyclopedia Britannica.
كان مأمولًا أن تصبح دائرة المعارف الإفريقية موسوعة علمية شاملة عن إفريقيا والشتات الإفريقي، تدحض أفكار المركزية الأوروبية Eurocentrism التي ترى في السود شعوبًا غير متحضرة، أو في أحسن الأحوال شعوبًا ظلت على أطراف الركب الحضاري ولم تسهم فيه بشكل فعّال.
ورغم أن ذلك المشروع لم ينجح في حينه بسبب عدم توافر مصادر للتمويل ووفاة دو بويز نفسه عام 1963، فإن مفهوم المركزية الإفريقية ألهم العديد من المفكرين والباحثين والناشطين السود الذين استخدموا المصطلح في أواخر الستينيات، وهم يخوضون معاركهم بشأن الدراسات الإفريقية والدراسات حول السود، ويدعون لأهمية تبني منهج قائم على المركزية الإفريقية (في مواجهة المركزية الأوروبية) في تلك الحقول الدراسية.
وبينما تميز عقد السبعينيات بظهور ثقافة القوة السوداء (Black Power) وسط الناشطين السود في الولايات المتحدة، التي قامت على إعلاء قيم الفخر بثقافة السود، جاء أول تنظير حقيقي لمفهوم المركزية الإفريقية في الثمانينيات، على يد الفيلسوف الأمريكي ذي الأصول الإفريقية موليفي كيتي أسانتي، أستاذ الفلسفة بجامعة تيمبل الأمريكية، في كتابه "المركزية الإفريقية: نظرية التغيير الاجتماعي".
يقوم هذا المفهوم على إدراك القمع التاريخي الذي تعرض له الأفارقة من خلال العبودية والاستعمار على يد الأوروبيين، وكيف أدى ذلك إلى تهميش المنجزات الحضارية الإفريقية، ويدعو بدوره إلى تثمين تلك المنجزات والاحتفاء بها وتشجيع الأفارقة وكل من لهم أصول إفريقية على إعادة صياغة تاريخهم وأنساقهم القيمية، بشكل يضعهم فاعلين رئيسيين في مركز ذلك التاريخ وتلك الأنساق، لا كيانات هامشية في سرديات تاريخية كتبها لهم مستعبدوهم التاريخيون.
أهمية المركزية الإفريقية في الثقافة الأمريكية
يعكس ظهور وانتشار أفكار المركزية الإفريقية في الولايات المتحدة على نحو خاص، محاولة من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية لامتلاك سرديتهم للتاريخ والثقافة الأمريكية والعالمية في مواجهة هيمنة سرديات المركزية الأوروبية التي انتشرت وتجذرت عن طريق الاستعمار وغيره من أشكال الإمبريالية الثقافية.
في حوار مع نيويورك تايمز عام 1991، تقول كليوثا چوردان، وهي معلمة وإدارية سوداء عملت في المدارس الحكومية بمدينة ديترويت الأمريكية "سألني أحدهم لماذا لا أستخدم كتاب التاريخ المقرر على الصف الحادي عشر [الثالث الثانوي]. الإجابة هي لأنني أول مرة ألتقي فيها بنفسي في هذا الكتاب هي كمستعبدة، ثم ككاريكاتير، ثم كثلاثة أخماس شخص [في إشارة إلى اعتبار الدستور الأمريكي سابقًا المستعبد الواحد ثلاثة أخماس شخص] (...) لا يتحدث هذا الكتاب إطلاقًا عن موطني [إفريقيا]. (…) المركزية الإفريقية تلفت انتباه التلاميذ إلى أنه 'ينبغي عليَّ أن أتعرف على نفسي أولًا وبعدها ستكون لدي القدرة على التعرف على أي شيء'".
وبالطبع فإن چوردان هنا تقصد المناهج الدراسية الرسمية المصممة وفق سرديات المركزية الأوروبية، التي تُعرِّض التلاميذ السود لأشكال من العنف الرمزي، بعرضهم في التاريخ كضحايا سلبيين للاستعمار الأوروبي وتجارة العبيد التي جاءت بهم إلى ما يُعرف بالعالم الجديد، وتتحدث عنهم ضمنيًا بوصفهم أقل شأنًا ممن جاؤوا إلى ذلك العالم من أوروبا، وقلما تتناول تاريخ الأفارقة والثقافة الإفريقية بعدّهما جديرين بالدراسة والتحليل والاحتفاء.
لذا، ذهب كثير من التربويين الأمريكيين على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية لمحتويات تاريخية مختلفة، تثمِّن الحضارات الإفريقية وحضارات السكان الأصليين وغيرهم من الأقليات العرقية، بشكل يتجاوز الصور النمطية التي تحفل بها المناهج الدراسية الأمريكية لدى تناولها للثقافات المختلفة، ككائنات غريبة مثيرة للانتباه أو قبائل تحضرت على أيدي البيض، وأكدوا أهمية ذلك الاتجاه التربوي لكل التلاميذ، سواءً كانوا من البيض أو من غير البيض.
ويعبّر أسانتي عن ذلك الاتجاه بقوله إن المركزية الإفريقية "لا تعني تبنّي رؤية معينة للعالم باعتبارها كونية (كما فعلت المركزية الأوروبية) ولكنها تعني أن يعامل الأفارقة كفاعلين وليس مفعولًا بهم، وأن يتم وضعهم في مركز سياقهم التاريخي باعتبارهم فاعلين إنسانيين نشطين".
"أثينة السوداء"
وبينما كان مفهوم المركزية الإفريقية يتصاعد في الثمانينيات، أصدر مارتن برنال، أستاذ التاريخ السابق بجامعة كورنل الأمريكية، الجزء الأول من كتابه "أثينة السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية"، وهو كتاب أكاديمي من ثلاثة أجزاء صدرت بالإنجليزية بين 1987 و2006 وتُرجِم جُزءاه الأول والثاني إلى العربية عن طريق المشروع القومي للترجمة.
في هذا الكتاب يحاجج برنال، وهو مؤرخ إنجليزي أبيض، بأن التأثير العميق للحضارة المصرية القديمة في نظيرتها الإغريقية أُغفل تاريخيًا بسبب عنصرية المؤرخين الأوروبيين في القرن التاسع عشر. ويوضح برنال أن السبب في إغفال تأثير الحضارة المصرية القديمة في نظيرتها الإغريقية هو تعارض تلك الحقيقة التاريخية مع السردية التي تقول بأن الحضارتين اليونانية والرومانية هما أصل الحضارة الأوروبية الحديثة التي تراها تلك السردية حضارة بيضاء.
اختلف المؤرخون في تقييمهم لتحليل برنال في كتابه، ومدى جواز مد مفاهيم العرق بشكل يتجاوز الحقب التاريخية. فتبني تصوّر موحّد عابر للحقب التاريخية عن العرق الأسود على سبيل المثال، لا يختلف كثيرًا عن رؤية أوروبا كوحدة واحدة عابرة للحقب التاريخية، على نحو يسمح باعتبار الحضارة اليونانية القديمة المنبع الأساسي للفكر الأوروبي الغربي الحديث، وما يترتب على ذلك من إعادة صياغة الجغرافيا التاريخية بشكل يلائم المركزية الأوروبية.
ورغم بعض المآخذ المنهجية على كتاب برنال، فإنه يبقى واحدًا من أول وأهم الإسهامات التأريخية التي حاولت وضع المركزية الأوروبية في سياقها التاريخي وتسليط الضوء على إسهامات الحضارات الإفريقية والآسيوية القديمة فيها، التي يراها المؤرخون الأوروبيون مصدر التفوق المزعوم للحضارة الأوروبية والرجل الأبيض.
"الأعراق" في مصر القديمة
بالطبع هناك عدد من الزوايا التي يمكن من خلالها انتقاد بعض أفكار المركزية الإفريقية، بالنظر على سبيل المثال إلى مفهوم أسانتي لوجود "منظومة ثقاقية إفريقية" يفترض أن ينتمي إليها الأفارقة أو أن يعيدوا استكشافها، وما يتضمنه ذلك من اختزال لتنوع الثقافات الإفريقية داخل إفريقيا وخارجها وحقيقة تغيرها على مدى العصور، وهو مفهوم قد يفضي في النهاية إلى تصورات جوهرانية (essentialist) ترى أن هناك جوهرًا ثابتًا ما لما يسمى بالثقافة الإفريقية.
أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن المصريين القدماء كانوا متنوعين عرقيًا بشكل كبير
وبالإضافة إلى ذلك، فمفهوم المركزية الإفريقية حُمِّل بالعديد من النزعات على مدى الثلاثين سنة الماضية، منها نزعات قد تنحرف عن الأهداف الفكرية والسياسية لمنظري الحركة الفكرية وقد تناقضها في بعض الأحيان. مثلًا، اعتبر البعض أثناء بحثهم عن السرديات التاريخية الإفريقية، أن حقيقةَ بداية الحياة الإنسانية في إفريقيا بحدِّ ذاتها مصدرٌ للفخر ودليلٌ على "التفوق العرقي".
وفي هذا السياق أيضًا، يأتي التشبث بشكل اختزالي بالحضارة المصرية القديمة، باعتبارها واحدة من أهم الحضارات الإفريقية أو على الأقل واحدة من الحضارات المحتفى بها بشدة في العالم الحديث، واختصار الحضارات الإفريقية فيها واعتبارها ممثلةً للحضارات الإفريقية ومصدرًا للفخر الإفريقي.
وعادة ما يتبنى هؤلاء أفكارًا يمينية محافظة أو معادية لليهود، ويسخر منهم أحيانًا غيرهم من السود الأمريكيين بتسميتهم "حُتِب" (hotep)، وهي كلمة مصرية قديمة تعني أن يكون المرء راضيًا أو في سلام، واستخدمها ذلك الفريق من مناصري المركزية الإفريقية كتحية بينهم. ومن الجدير بالذكر هنا أن ذلك الفريق الذي يختزل معاني المركزية الإفريقية يعد تيارًا هامشيًا غير ذي أهمية في المجتمع الأمريكي أو بين الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية.
ويمكن القول بأن المشكلة في ذلك الفريق من أنصار المركزية الإفريقية أنهم يتبنون رؤىً قد تكون مختزلة للتاريخ، تعتبر أن مؤسسي الحضارة المصرية كانوا من سود البشرة كسبيل للفخر، في حين أن الأدلة التاريخية تشير إلى التنوع العرقي في مصر القديمة. كما أنهم بإغفالهم لحضارات إفريقية أخرى، وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء، يؤيدون بشكل غير مباشر وجهة النظر الأوروبية العنصرية التي لا ترى منتجًا حضاريًا في إفريقيا سوى ما وصلنا من الحضارة المصرية القديمة.
وواقع الأمر أن الحقيقة التاريخية أكثر تعقيدًا من سطحية اشتباك المغالين من الأفروسنتريك المعاصرين مع من ينبري من المصريين للرد عليهم؛ فقد حاولت الأبحاث الحديثة في علوم المصريات وفي التاريخ القديم الإجابة عن السؤال التاريخي بشأن تبني المصريين القدماء مفهومًا للعرق بحسب لون البشرة أو الملامح*، وانتهت إلى وجود جذور للتفرقة على أساس اللون، وإن اختلفت دلالات اللون والعرق عبر الزمن، ليصبح من غير المجدي محاولة تطبيق الأفكار الحديثة عن العرق على الرؤى التي سادت من آلاف السنين.
في هذا الإطار، أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن المصريين القدماء كانوا متنوعين عرقيًا بشكل كبير، وأنهم رأوا أنفسهم يشبهون، من حيث اللون، سكان شرق إفريقيا وغرب الجزيرة العربية، بدليل أن الكثير من البرديات كانت ترسم سكان بلاد بنط، وأغلب الظن أنها كانت تشمل جنوب عمان ومملكة حضرموت، بنفس ألوان المصريين.
وتفرّق الجداريات والبرديات المصرية بين ذلك التكوين العرقي وغيره من ألوان البشرة؛ الأغمق في النوبة وغرب إفريقيا والأصفر في الشام والأصفر الأميل للبياض في ليبيا. إلا أن معظم علماء المصريات يرون أن هذه التفرقة اللونية في الرسوم لا تعني أن العرق كان يمثل جزءًا هامًا من الهوية، فالبنطيون والإيجيون (سكان اليونان في العصر البرونزي) كان يُرسَمون عادة في البرديات والجداريات المصرية بنفس ألوان المصريين.
وبعد ذلك يظهر المصريون في العديد من الكتابات الإغريقية والرومانية داكني البشرة يشبهون سكان شرق ووسط إفريقيا. ومع أن هذه الرؤى تكشف عن الصور النمطية التي أنتجها الفكر الإغريقي والروماني أكثر مما تكشف عن رؤية المصريين لأنفسهم، فإنه لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبته تلك الصور النمطية نفسها في تكوين القوانين البطلمية والرومانية التي خضع لها سكان وادي النيل لقرون، وساهمت في تشكيل وعيهم بذواتهم.
التضامن الإفريقي حديثًا
ينبغي هنا أيضًا أن نذكر أن الفخر الإفريقي بالحضارة المصرية القديمة يعد جزءًا هامًا في مشروع التضامن الإفريقي وحركات الوحدة الإفريقية (Pan-Africanism)، التي لعبت مصر دورًا هامًا في تَشكُّلِها السياسي تاريخيًا خلال القرن العشرين منذ مؤتمر الشعوب الإفريقية عام 1958، ثم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وصعود العديد من القادة الأفارقة الذين دعوا إلى الاحتفاء بالقيم والمفاهيم الإفريقية عن المجتمع والثقافة والتعاون الإفريقي في مواجهة الإمبريالية والاستعمار.
وفي هذا الإطار يعد الفخر بالحضارة المصرية القديمة كواحدة من أشهر الحضارات القديمة حول العالم والتعريف بغيرها من الحضارات الإفريقية جزءًا هامًا في هذا المشروع الثقافي: من حضارة قرطاج في تونس والحضارة النوميدية في شمال إفريقيا والجرمنتيين في ليبيا إلى حضارة كوش في النوبة والحضارة الأكسومية في الحبشة وسلطنة سونغاي في غرب الساحل الإفريقي ومملكة داغبون وإمبراطوريات غانا ومملكة الكونغو وإمبراطورية بنين وإمبراطورية مالي ومملكة زيمبابوي وغيرها من الحضارات التي دامت قرونًا طويلةً وقدمت إسهامات هامة في تاريخ البشرية.
فتعاملنا المتعالي مع الأفارقة السود باعتبارهم كتلة عرقية مصمتة والتأكيد على اختلاف الملامح "المصرية" عن الملامح "الإفريقية" أو "الزنجية" هو أمر اختزالي وينم من ناحية عن تناسي التنوع الهائل بين ملامح وألوان بشرة المصريين، ومن ناحية أخرى عن جهل كبير بالتنوع والثراء العرقي في إفريقيا.
فالعرق ليس فئة بيولوجية، بل اجتماعية وثقافية، وأكدت العديد من الدراسات أن الاختلافات الجينية بين قاطني الشرق والغرب في إفريقيا أكبر من تلك التي بين الأفارقة واليوروآسيويين.
وإن كان معظمنا يجهل هذا التنوع العرقي وهذه الحضارات الإفريقية وإسهاماتها فإن ذلك يرجع من ناحية إلى تقوقعنا السياسي والثقافي حول أنفسنا طوال القرن الماضي، ومن أخرى إلى انسحاقنا الثقافي والتعليمي أمام السرديات العنصرية وسرديات المركزية الأوروبية للتاريخ، التي لم ترغب أن ترى في القارة السوداء تاريخيًا إلا مرتعًا للاستعمار لا تسكنه غير شعوب وقبائل متخلفة، أخذ الاستعمار على نفسه مسؤولية قمعها والسيطرة عليها أو تهذيبها وتحضيرها لخدمة مصالحه.
لماذا أصابنا الذعر؟
هنا تستوقفني ردود الفعل العنيفة والعنصرية من بعض المصريين وتدفعني لطرح تساؤل حول مصدر الإحساس بانعدام الأمان الذي يحركهم تجاه تاريخهم ويدفعهم للذود عنه بشكل شوفيني يرون فيه أنفسهم أحفادًا مباشرين لأحمس ورمسيس، غافلين عن التعقيد العرقي للمجتمع المصري الحديث نتيجة قرون طويلة من كل من الاستعمار والسفر والتبادل الثقافي والتجاري وغيره، فجغرافيا وتاريخ مصر القديمة أبعد ما يكونان عن الثبات.
ويكفي أن نتذكر أن عصر بناة الأهرام سبق عصر رمسيس الثاني بحوالي 1500 عام، وهي تقريبًا المدة الزمنية نفسها التي تفصل بين بعثة الرسول ولحظة كتابة هذا المقال. قرون تغير فيها التكوين الحضاري والثقافي والعرقي وكذلك الحدود الجغرافية والذاكرة التاريخية لسكان شمال وادي النيل.
هذا الإحساس بانعدام الأمان عادة ما يتجلى في شعور بعض المصريين بالتهديد من قبل المركزية الإفريقية، باعتبارها "محاولة لاختطاف التاريخ المصري". والحقيقة أن التاريخ المصري القديم من أكثر الحقب المدروسة حول العالم ولا يوجد مجال حقيقي "لاختطافه"، بالإضافة إلى أن الأفكار حول أن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة سوداء تعود جذورها إلى القرن الثامن عشر٬ أي أنها ليست أمرًا جديدًا ولا تمثل تهديدًا عاجلًا للحضارة المصرية٬ فما السر وراء هذا الذعر الهوياتي الذي ينتاب المصريين بشكل دوري تجاه تلك الخطابات؟ لماذا تصيبنا بالذعر وتجعلنا نشعر أننا مهددون؟
هذا الاشتباك السطحي مع المركزية الإفريقية ما هو إلا تجلٍّ من تجليات "المركزية المصرية" التي ترى مصر مركزًا للمنطقة والقارة بل والعالم بأسره
في رأيي أن هذا الذعر الهوياتي يرتبط بتاريخ طويل من العنصرية في مصر وبما أسميه أحيانًا القلق اللوني (colorist anxiety) الذي ينتاب المصريين نتيجة اعتبار أنفسهم مختلفين عرقيًا عن شعوب إفريقيا جنوب الصحراء، ما يدفعنا لمحاكاة البياض ومحاولة التقرب إليه والبعد عما يقربنا من كل ما هو أسود.
وهنا يصبح الولع الأوروبي بالحضارة المصرية القديمة، وهو الولع الذي أسس علم المصريات في إطار استعماري وحاول ربط مصر بحضارات المتوسط وفصلها عن إفريقيا السوداء، محل ترحيب، أما احتفاء الأفارقة بها، وهم الأقرب إليها من الأوروبيين، بات مصدرًا للاشمئزاز والتعالي والعداء. يتمثل ذلك في العنصرية الفجة التي ميّزت ردود فعل العديد من المصريين تجاه السود بشكل عام وهم يطالبون بإلغاء حفل كيڤين هارت، وإصرارهم على تفوق المصريين، ليس الحضاري فحسب ولكن العرقي أيضًا، على أبناء إفريقيا جنوب الصحراء وكل من هم من نسلهم، بل ونعتهم البعض بالزنوج، في محاولة للتأكيد على اختلافنا "النوعي" عنهم.
ربما لا يخفى على الكثيرين أن العنصرية في مصر تجاه السود لها تاريخ طويل، ولعب الاستعمار دورًا في تجذيرها وفي تجذير ثقافة اللونية (colorism) القائمة على تثمين البياض وما يقاربه وربط القيمة الاجتماعية للأفراد بلون بشرتهم، بحيث تزداد قيمة المرء كلما فتح لون بشرته.
وربما تعد مذبحة اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود على يد الشرطة عام 2005، التي بدأت بمناوشات مع مواطنين مصريين وانتهت بمقتل 25 لاجئًا معظمهم من الأطفال وإصابة العشرات على يد الشرطة، من تجليات هذا الاستعلاء العرقي ضد الأفارقة السود، الذي لا يستثني النوبيين المصريين أيضًا، وهو أمر يتطلب في النهاية مواجهة اجتماعية وثقافية نطرح فيها على أنفسنا أسئلة العنصرية الأصعب.
في رأيي، لا يمكن قراءة التعالي على الشعوب الإفريقية والجهل بحضاراتها المختلفة وتجاهل تنوع ثقافاتها بمعزل عن تاريخ العنصرية الطويل في مصر وتقوقعنا السياسي والثقافي حول ذاتنا. غير أن هذه الهبَّات الدورية التي صرنا نراها مؤخرًا في مواجهة المركزية الإفريقية ترجع بالأساس إلى الدور الذي لعبته السوشيال ميديا في تسهيل الاتصال بين أفراد وجماعات من مجتمعات مختلفة.
ولكن تسهيل الاتصال لا يعني دائمًا التمكين من التواصل، إذ إن معظم هذه الاتصالات تحدث في إطار من الضجيج الإنترنتي الذي لا يسمح بفتح حوارات حقيقية بقدر ما ينتج أفكارًا مختزلة وردود فعل متسرعة، فيتحول لقاء المصريين مع المركزية الإفريقية -وكعادتنا في رؤية العالم من زوايا ضيقة ناجمة عن تمحورنا حول ذواتنا- إلى صدام مع رؤى يراها هؤلاء المصريون محاولات من السود للسطو على حضارتنا ونسبتها لأنفسهم، دون إبداء أي فضول حقيقي لفهم ماهية المركزية الإفريقية وكيف نشأت وكيف يمكن أن نراها بشكل أوسع من كونها محاولة "عنصرية" لخطف تاريخنا.
ما أود توضيحه هنا أن هذا الاشتباك السطحي مع المركزية الإفريقية ما هو إلا تجلٍّ من تجليات "المركزية المصرية" (Egyptocentrism) التي ترى مصر مركزًا للمنطقة والقارة بل والعالم بأسره، وتبالغ في إضفاء دور فريد على الحضارة المصرية.
وفي هذا السياق، يعكس اتهام "الأفروسنتريك" بالعنصرية -بوصفها حركة قائمة على مركزية العرق (ethnocentrism)- تصورات سطحية عن العنصرية، لا تأخذ في اعتبارها موازين القوى التاريخية والحالية. فلا يمكن وصم السود في الولايات المتحدة، الهدف الأساسي للحملات العدائية، بالعنصرية وإن عبّر بعضهم عن مشاعر معادية للبيض، لأنهم ببساطة لا يملكون سلطة تسمح لهم بممارسة التمييز ضد البيض أو بإقصائهم، لأن كل البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما زالت قائمة على سيادة البيض وذوي البشرة الفاتحة.
وبالتالي فالأدعى هنا أن نستدعي التاريخ الطويل لمعاداة السود في ثقافتنا وأن نفكر في سبل تسمح لنا بإعادة تقييم مواقفنا الاستعلائية من الأفارقة وغيرهم من السود.
تساؤلاتي الأخيرة هي: لماذا يزعجنا أن يحتفي غيرنا من الأفارقة بحضارتنا المصرية التي تنتمي في النهاية إلى القارة الإفريقية أو لماذا نشعر بالتهديد من قلة غير مؤثرة تدّعي بأن أجدادهم كانوا ملوكًا لمصر؟ ولماذا نشعر بالحاجة للهجوم على المركزية الإفريقية كمشروع فكري كامل بناءً على ذلك؟ وما هو المشروع السياسي البديل الذي ندعمه في مواجهتها؟ الشوفينية الفاشية أم الجري في ركاب المركزية الأوروبية التي طالما قمعتنا وقمعت غيرنا من شعوب هذه القارة؟ هل لنا أن نطمح في شكل من أشكال التضامن ما بعد الكولونيالي، يسمح لنا بالفخر بحضارتنا وتثمينها في سياقها التاريخي إلى جانب الحضارات الأخرى التي واكبتها، تجنبًا للوقوع في شرك الاستعلاء القومي؟
هي في النهاية طموحات لا أدري إن كان الواقع السياسي الحالي يسمح بتحققها، ولكنها تظل السبيل التقدمي للنظر لتاريخنا والتفكير في مستقبل لا يصاب فيه مجتمعنا بالذعر من جولة فنية لكوميديان أمريكي.
* ساعد الدكتور أحمد رجب، أستاذ تاريخ الطب بجامعة چونز هوبكنز الأمريكية، في صياغة نقد المؤرخين لكتاب "أثينة السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية"، وتحليل المؤرخين لقضية إدراك المصريين القدماء للفروق المبنية على اللون والعرق.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.