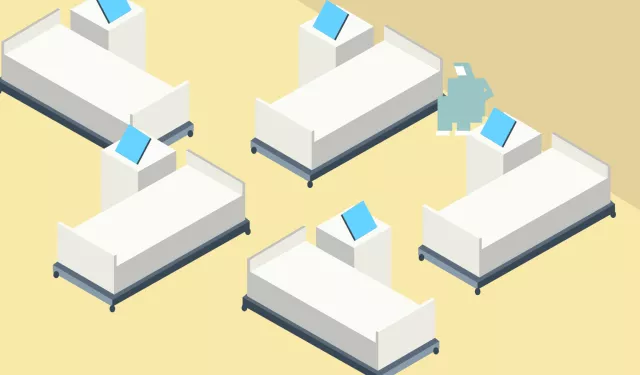
الجندي كورونا والنظام الطبي
أغلب الظن أن جائحة كورونا ولَّت، فمنظمة الصحة العالمية نفسها أصبحت أكثر تفاؤلًا عن أي وقت مضي بقرب نهاية الجائحة، بل أنها أثنت على ميل الصين لتخفيف القيود الاجتماعية الصارمة التي اتبعتها في إطار ما يعرف بسياسة صفر- كوفيد، ومن هنا أرى أن الوقت أصبح مناسبًا لرصد بعض النقاط المتعلقة بالأزمة.
مع بداية كورونا، انتشر على مواقع السوشيال ميديا، مجموعة من الفيديوهات لأحد الدعاة، حمل أحدها عنوان "كورونا.. الفايروس الذي هزم العالم"، تحدث فيه عن واحد من "أصغر جنود الله" يهزم أقوى جيوش الأرض، تضمن هذا الفيديو قدرًا هائلًا من التشفي في الحضارة الحديثة، يصل حد الشماتة وربما السرور الذي كان واضحًا على محياه، وظن الرجل الذي أسقط أمانيه كامله على الواقع، أن العلم فشل وانكشفت هشاشة الحضارة.
بصرف النظر عن رسالة مديح الجهل هذه، فالذي يعنينا هنا اللغة التي تشابهت إلى حد ما مع المراكز الرأسمالية العالمية، كـ"الهزيمة" و"الجيوش" ومناعة "القطيع" و"عاصفة" السيتوكاين، وكأن العالم، تحت وطأة الأزمة قد ارتد إلى لغة أكثر بدائية وفجاجة.
هذه الروح البدائية نفسها دفعت معظم الدول لاتخاذ تدابير جبارة، مثل الإغلاق الذي طال حتى المطارات والنوادي، ومن ناحية أخرى ظهر الاحترام الكبير للقطاع الحكومي العام في تغطية احتياجات المواطنين الأساسية، لا سيما مجال الصحة.
هذه الاستراتيجية أعطت قبلة الحياة ولو معنويًا، لقطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة بمستشفياته العامة والمركزية
هنا في مصر، تشكلت "اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا" وضمت وزارات عدّة إضافة لهيئة الشراء الموحد وجهاز التنظيم والإدارة، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولعبت فيها وزارتا الصحة والتعليم العالي، كذلك المستشار العلمي لرئيس الجمهورية أدوارًا رئيسية، وقامت استراتيجية مواجهه الجائحة على التكامل والتعاون التام بين جناحي النظام الطبي الحكومي، وهي قطاع المستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي، والقطاعات الطبية التابعة لوزارة الصحة.
تناغم استثنائي
من الواضح، بالنظر إلى النتائج وقياسًا على أداء البلدان الأخرى، أن خطة التكامل بين أجنحة النظام الطبي الحكومي هذه نجحت نجاحًا كبيرًا في مواجهة الجائحة، في الحقيقة كانت معجزة حقيقية أن تستطيع المنظومة المتنافرة العمل كجسد واحد ذي مكونات متعددة لكنها متناغمة، فمن المؤكد أن هذا التناغم الذي حدث ولو مؤقتًا هو الاستثناء، ففي العادة لا توجد أي علاقات بين هذه الأجنحة التابعة لوزارات مختلفة على الإطلاق.
يبدو لي، في الحقيقة، أن هذه الاستراتيجية أعطت قبلة الحياة ولو معنويًا، لقطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة بمستشفياته العامة والمركزية، الذي عُرف تاريخيًا بكونه عماد العلاج الحكومي المجاني، لكنه، بحجة أو بأخرى، أصبح يعاني إهمالًا متزايدًا في العشرين سنة الأخيرة.
إهمال طال نواحي التطوير والتجديد والصيانة، ناهيك عن التوسع، الحجة دائمًا نقص الإمكانيات، وفشل القطاع في تنفيذ سياسة استعادة التكاليف، لكن تحت وطأة الجائحة لم يكن هناك بُد من العودة إليه، بسبب ميزة وحيدة؛ أن وحداته تغطي فعليًا ربوع مصر كلها.
في المقابل، وعلى مدى الخمسين سنة الأخيرة، كان الاهتمام متزايدًا بقطاع المستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي، من حيث الصيانة والتطوير وإنشاء أقسام جديدة لملاحقة أحدث التقنيات، حتى أتت التوسعات على معظم الأفنية والحدائق المحيطة بالعديد منها.
يعود الاختلاف في المسار إلى كون المستشفيات الجامعية مكان امتياز فئة الأطباء أساتذة الجامعة، الذين يشكلون حوالي خُمس عدد الأطباء في مصر، لكنهم كفئة اجتماعية شديدة التميز، ومثل أي من تلك الفئات، تعرف بالسليقة كيف تحافظ على مصالحها.
هنا تقوم المستشفيات الجامعية بدور ورشة التعليم والتدريب بالذات للقادمين الجدد التابعين لنفس الفئة، ومن هنا وكخبراء حقيقيين ينتشرون ويسيطرون على أماكن العمل في المستشفيات الخاصة، وطبعًا العيادات الخاصة الأكثر شهرة، وحتى على كل قطاعات وزارة الصحة التي تعمل بنظام التعاقد.
هذه الوضعية التي يتخذها أساتذة الجامعات هي ما تشكل خللًا هيكليًا داخل بنية هذا النظام، وأظن أنها ستكون العقبة الكؤود التي ستتحطم عليها كل رغبات الإصلاح. ازداد الطين بلة بميل هذه الفئة المتزايد لاحتكار الشهادات الطبية الأعلى من الدبلوم، وحصرها في نطاق فئتهم بحجة أنها شهادات أكاديمية، وليس لها مردود مباشر على الممارسة الفعلية، وبالتالي يُحرم كل الأطباء من خارج هذه الفئة من العمل بالمستشفيات الخاصة، وحتى جميع هيئات وزارة الصحة العاملة بنظام التعاقد، إذ يتطلب هذا الحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير على الأقل.
أرى أن هذه الفئة من الأطباء من أساتذة الجامعة هي الأكثر استفادة من استمرار الوضع القائم، بالتالي الأكثر تبريرًا لتكريسه، الذي من مظاهره إصدار القانون الأخير لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الذي ألغى أي علاقة لهذا المستشفيات بوزارة الصحة والإدارات المحلية، كذلك لم يوضح مجانية الخدمة، هذا غير تأخير مهمة علاج المرضى لتأتي بعد التعليم والتدريب والبحث، على عكس القانون القديم.
لماذا لا يستمر التكامل؟
بالعودة إلى خبرة كورونا الاستثنائية، أي قدره جناحي النظام الطبي الحكومي، المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي ومستشفيات وزارة الصحة، على العمل كمنظومة واحدة متناغمة، ونجاحها بصورة مبهرة في مواجه الجائحة.
ففي بداية الأزمة كان لوزارة الصحة دور أساسي عن طريق مستشفيات العزل، وعندما تخطت الأزمة حدودها، تحول كل قطاع الطب العلاجي لمستشفيات عزل، وصدرت قرارات صارمة بمد هذا القطاع بالكوادر اللازمة من قطاع المستشفيات الجامعية، إضافة إلى الأجهزة اللازمة، وأظن أن مستشفيات وزارة الصحة ما كان لها أن تنجح إلا بتلك الطريقة.
إنما المشكلة الأساسية تتعلق بتكلفة هذه الخدمة، إضافة لانهيار جودتها كلما قلت التكلفة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، بناء على هذا النجاح الذي حققته هذه الاستراتيجية في مواجهة جائحة كورونا، لماذا لا يستمر التكامل بين الأجنحة الطبية في العمل اليومي؟ لماذا لا يتولى كل مستشفى جامعي قطاعًا جغرافيًا من مستشفيات وزارة الصحة، فيشرف على تطويره ورفع كفاءته؟
صحيح، ليست هناك مشكلة حادة على مستوى الخدمة الطبية في مصر، فالجميع يُعالَج بصورة أو بأخرى، إنّما المشكلة الأساسية تتعلق بتكلفة الخدمة، إضافة لانهيار جودتها كلما قلت التكلفة.
تكامل المنظومة الطبية هو ما يناسب تمامًا ظروف بلد محدود الدخل، ولا عوض عنه إذا أردنا تلافي سلبيات هذه المنظومة، خاصة أنه نجح بشدة كما تفيدنا خبرة كورونا. ففي سياق كهذا سيكون لزيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة معنى، ويمكن رفع كفاءة هذه المنظومة ووقف هدر إمكانيات وزارة الصحة، ويمكن التصدي لسلبية هذه المنظومة الأساسية، وهي الارتباط التام بين الجودة والتكلفة، الذي يعمل مباشرة لصالح الأغنى.
الشرط الأساسي لعمل ذلك بطريقة مستدامة هو منع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص، بالذات في حالة أساتذة الجامعة، وإلا ستندفع هذه الفئة للاستئثار المتزايد بكل أوراق اللعبة، إذ تملك الورش اللازمة للتعليم والتدريب الطبي المستمر كذلك تجريب أحدث التقنيات، المنقولة من الخارج عن طريق المؤتمرات والدورات التعليمية المدعومة من الدولة، ليتم احتكارها في أبنية حكومية ويعاد توظيفها أساسًا داخل المستشفيات الخاصة، ولهذا، يُفرض التأخر على بقية الأطباء، لإضعاف قدرتهم على المنافسة.
في إطار حروب المنافسة الشرسة هذه، لا يمكن انتظار أي خير من وراء هذا الكهنوت المسمى الأكاديمية، ولا يمكن أن يكون هناك بحث علمي أو شبه علمي، ناهيك عن الإبداع وابتكار الحلول أو المشاركة في تطوير الطب كعلم، فلا وقت هنا للتفكير الحر أو إطلاق الخيال، فالوقت المتاح لا يوظَّف إلا في حروب التمكُّن والاستحواذ؛ حروب تجريد الغالبية العظمى من الأطباء من كل سبل العيش، ولا يتبقى أمامهم غير العمل تحت شروط مهينة أو سفر طويل للخارج، و نقاش حامي الوطيس حول هل يستمر صرف معاش نقابة الأطباء مجمعًا كل ثلاثة أشهر أم نجمع التوقيعات ونرفع العرائض من أجل صرفه شهرًا بشهر؟
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.