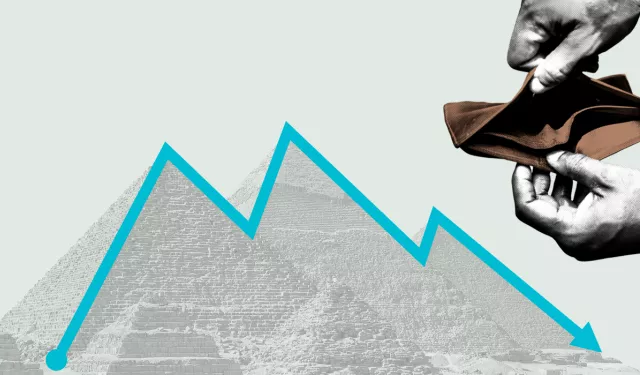
خطورة التلاعب في الجينات الاجتماعية للمصريين
على مدار قرون طويلة اعتاد المصريون تسيير أمورهم، على قدر الاستطاعة والحاجة، دون تعويل قوي ومستمر على السلطة الحاكمة، حتى لو نادوها وناشدوها وانتقدوها على عدم قيامها بما يجب أن يقع على عاتقها من مهام، وما هو منوط بها من أدوار.
منذ خمسة آلاف سنة، ومصر تحكمها قوىً من خارجها، ولذا اعتاد المصريون أن تكون هناك مسافة بينهم وبين السلطة التي تدير وتتحكم، متقلبين معها بين عدل قصير، وظلم طويل، واجهوه بالتمرد حينًا، وبالتحايل أحيانًا، وخضعوا له غالبًا، مقدرين جيدًا ما يراد منهم، وما يريدونه ممن يحكمون.
هذه الغربة الطويلة علمت المجتمع أن يصنع سياجات يحمي بها نفسه، ويخترع حيلًا يمرر بها أزماته، ويقضي بها أوقاته العصيبة، ويعرف متى يكر، ومتى يفر، وهو ينظر إلى السلطة في ارتياب، لا يثق فيها كثيرًا، خاصة أنه سمع ورأى وعرك وعانى الفجوة المتواصلة بين "الخطاب" و"الممارسة"، وبين "القول" و"الفعل"، حتى بعد أن حمل الاستعمار عصاه ورحل، وحكم مصر أبناء منها.
رأى المصريون، على مدار العقود الأخيرة، كيف انفكت عرى المبادئ الست لثورة يوليو، عروة تلو أخرى، وكيف أعيدوا مرة أخرى يرسفون في أغلال غليظة، وكيف تواصل الفساد وتوحش، حتى طاول النهب الاستعماري أو فاقه أحيانًا.
خارج هذا السياج تقف السلطة مستريحة، فهي تأخذ دون أن تكون ملتزمة بالعطاء، لأن الشعب لا يُراقِب كيف يُنفق ماله، ولا يستطيع أن يوقف التلاعب بالقوانين التي تم سنها باسمه، ولا يمنع السلطة إن أرادت اختراق هذا السياج/ لتخيف وترعب، وتحاسب وتعاقب، وتفرض ما يحلو لها، وتهضم حقوقًا، لتحقق هدفها الأول والأساسي، وهو ليس خدمة الشعب في المقام الأول، إنما الحفاظ على حكمها أطول فترة ممكنة، وبقاء منافعها جارية إلى أقصى حد ممكن، تحت شعار يتم تأويله وفق مصلحتها وهو "الاستقرار والاستمرار".
لا يعني هذا أن السلطة ظلت متخففة طول الوقت من مطالبة الناس بحقوقهم، ومنازعتهم في سبيل أداء ما عليها من واجب، ولا يعني أيضًا أن كل السلطات المتعاقبة مصابة بتبلد إدراكي حيال الالتزامات، إنما يعني أن السلطة لا تفعل وحدها كل ما يجعل مصر مستمرة على قيد الحياة، بل لا يمكنها، لطول فسادها واستبدادها، أن تنهض بهذا الفرض التاريخي، وهي تحتاج في كل الأحوال، سواء اعترفت بهذا أو تنكرت له، إلى مشاركة المجتمع، وأحيانًا يكون الغرم الواقع عليه أقوى وأنكى.
ووفق مبدأ "ما لا يقتلني يقويني"، صار المجتمع المصري يتمتع بمرونة عجيبة، يحسبها المتعجل ليونةً وخضوعًا، وما هي إلا حيلة معتقة يحافظ بها على نفسه، وبذا تبقى مصر. إذ لا يمكن لها أن تكون وتقوم وتمضي دون انهيار تام طالما أصاب دولًا كثيرة عبر التاريخ، ودون وجود قاعدة عريضة من الناس تنزع تصرفاتهم البسيطة، والقيم الراسخة التي يؤمنون بها، والتاريخ المديد الذي يحملونه فوق ظهورهم، إلى ما يحقق التماسك أو الترابط.
وجزء من هذه المرونة، وهذا التماسك، مستمد من القدرة على تجنب بعض الآثار السيئة للاستبداد وسوء الإدارة، عبر إطلاق القوى الحية والفاعلة للمجتمع، تبني وتنتج وتحدب على بعضها البعض، وتعطي بقدر ما تأخذ.
يتم هذا طول الوقت دون إعلان ولا ضجيج، بعد أن صار سلوكًا أصيلًا، وجزءًا من مقومات الشخصية المصرية عبر التاريخ، ولذا ليس من المستغرب أن تكون في مصر أكثر من عشرين ألف جمعية، بعضها يعمل في الخير، وأن ينشغل المصريون العاملون بالخارج بذويهم في الداخل على هذا النحو المفرط الظاهر.
وهنا تتوالى الإجراءات الاجتماعية التي تطبب العوز، وتسد الفُرج، وتجبر ما انكسر، إما وفق تصورات دينية تتمثل في "صلة الرحم" و"الإحسان" و"الحق المعلوم للسائل والمحروم" من زكوات وصدقات، ولا يختلف في هذا المسلمون عن المسيحيين، أو وفق تقاليد وعادات سارية تساهم، إلى جانب ما يفرضه الدين أيضًا، في تدفق جزء من المال من مسلمين إلى مسيحيين والعكس.
الأخطر هو جعل كل أموال المصريين تمر عبر السلطة، وهذا لا غبار عليه إن كانت هناك رقابة. أما دفعها إلى مشروعات طويلة الأجل، فإن قدرة المصريين على مواصلة هذا الدور ستتأثر
فأهل القرية الواحدة، والحارة الواحدة في المدينة، يطرق كل منهم باب الآخر، خصوصا في الأعياد والأفراح والأحزان، والنكبات والملمات والأزمات. وأبدع المصريون طرقا لهذا التساند الاقتصادي، منه ما يمكن أن نجده في مجتمعات أخرى، ومنه ما يخص المصريين، ويثير العجب.
فهناك مثلا ظاهرة "الجمعيات" التي تعني اتفاق مجموعة من الناس، خصوصا الموظفين، على اقتطاع جزء من دخولهم شهريًا، دون أوراق ثبوتية ولا رهان مقبوضة، ليحصل عليها واحد منهم كل شهر، ويبدأون عادة بمن يكون في حاجة ماسة إلى المبلغ. وهذا الإجراء طالما فرّج كربات، وسد حاجات، وساعد البعض على عبور أزمات.
وأبدع المصريون مسألة أخرى يسمونها "الفرح"، يقيمه من يكون في حاجة ماسة إلى مال، ليعبر به أزمة أو يفك ضائقة، فرحًا بلا مناسبة طبيعية كالزواج أو الابتهاج بنجاة من مرض أو حادث، ويقوم الآخرون بتقديم "النقطة" إلى صاحب الفرح، ويكون عليه ردها حين يقيم غيره فرحًا مماثلًا، وهكذا.
وفي شهر رمضان تتوزع موائد الرحمن في كل مكان، ويقبل عليها الفقراء دون حرج، وصارت بعض شرائح الطبقة الوسطى تشاركهم الإقبال مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وكذلك بعض فقراء المسيحيين. وفي هذا المضمار يوزع البعض علب الأطعمة على المارة أو الجيران، دون نصب موائد.
وفي عيد الأضحى توزع لحوم الذبائح على من يستحق. وهناك ما توزعه المساجد والكنائس دون انقطاع. ويوجد الذين هم على استعداد دائم لتسليف غيرهم ما يحتاجونه دون فوائد. وهناك موسرون في عائلات أو أسر ممتدة يمدون ايديهم إلى فقراء أو مساكين من العائلة نفسها. وهناك الإكراميات التي تدفع في كل مكان، المطاعم والمقاهي ومحلات الملابس ومحطات النقل، وهناك رشى تدفع للموظفين، صارت جزءًا من التقاليد الإدارية، إلى درجة أن البعض طالب بتحديدها وتقنينها، نظرا لأن رواتب صغار الموظفين لا يمكن أن تكفي حاجات من يعولون.
يمد البعض أيديهم إلى جيوبهم ليعطوا كثيرين، كتعبير عن الكرم أو الإحساس بالمسؤولية حيال من يخدمونهم أو يقتربون منهم، كأن يساعد سكان بناية من يحرسونها من رجال الأمن، ومن ينظفونها من العمالة غير المنتظمة، وهي أعطيات تكون فوق الأجور والرواتب المحددة، ويمد البعض أيديهم إلى كناسي الشوارع، ومنظفي المراحيض العامة، وراكني السيارات.
ويوجد من يطيب له ألا يرد الباعة الجائلين كاسفي البال، وهناك من يعطي متسولين. ولا ينقطع من يقبلون على التبرع بالدم، والتصدق بما يفيض عنهم من طعام أو ملابس، ومن يتدخلون لفض شجار محتدم، ومن يفضون نزاعات ملتهبة، ومن ينقلون مصابين في حادثة مرورية، ومن يطاردون لصًا في شارع بمدينة، أو سارقي البهائم والقوت في القرى.
حافظ المصريون على هذا السلوك قرونًا طويلة، للأسباب التي سبق شرحها، لكن استمراره بقوة الدفع نفسها يتوقف على أن يبقى مالٌ جارٍ في إيديهم، وهي مسألة تهددها الضرائب المتزايدة بلا هوادة، وارتفاع الأسعار والتضخم، ناهيك عن الفساد.
لكن الأخطر هو إن تم تنفيذ ما تعتزم السلطة فعله من جعل كل أموال المصريين تمر عبرها، وهذا لا غبار عليه إن كانت هناك رقابة على حركة الأموال، واحترام للملكية الخاصة، ودفع المال للاستثمار في مشروعات منتجة. أما إن تم جمع النقود، ودفعها كلها أو جلها إلى مشروعات طويلة الأجل، فإن قدرة المصريين على مواصلة هذا الدور الاجتماعي التاريخي لهم، على النحو الذي شرحناه تفصيلًا، ستتأثر بشكل جارح وبارح، وهذا يحدث الآن بالفعل، للأسف الشديد.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.
