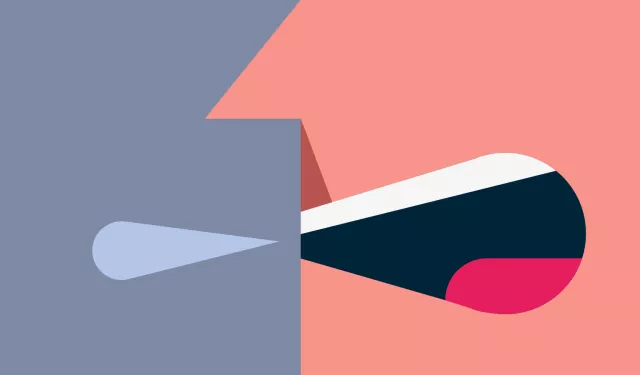
الفيروس الملحد: الإيمان لا يصلح لقاحا ضد كورونا
تقول أمي، وهي تودعني "لا إله إلا الله". فأقول لها "محمد رسول الله". تعني هذه الطريقة في الوداع الكثير بالنسبة لأمي، كما لأمهات كثيرات. ولا أعرف إن كان لدى أمهات أصدقائي المسيحيين عبارة ذات حمولة دينية، كتلك، يودعن بها أبناءهن، لكن أكبر ظني أنهن يفعلن بالمثل. وربما تفعل أمهات اليهود، وأمهات بقية الأديان، الأمر نفسه، لأن الأمومة ليس لها دين، وليست لها لغة، إذ أن الأمومة لغة في ذاتها. تقول لي أمي ذلك قبل إنهاء مكالمة تليفونية معي، أو عندما أخرج للقاء أصدقائي على المقهى، أو قبل أن أغلق باب الأسانسير، وهي واقفة على باب الشقة تلقي عليّ نظرة، في طريقي المتكرر منذ سنوات إلى المطار. وظني أن اقتسام الشهادتين بهذه الطريقة يمنح أمي إحساسا بأننا سنلتقي مرة أخرى، يمنحها إحساسا ما بالطمأنينة والسلام. ألم توجد الأديان لتفعل ذلك؟ ظني أن غاية كل الأديان، على تنوعها واختلافها، هي أن تمنح الفرد الطمأنينة والسلام، وأن تساعد الإنسان على الحياة، لا أن تقوده إلى الموت. أليس كذلك؟
أضحكتني أمي، في مكالمة هاتفية، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، عندما قالت لي باللغة الفصحى "جعلني الله فداء لكم". وضعنا الفيروس، مباشرة، في مواجهة فكرة الموت، ولكن الموت بهذا الشكل العبثي، بسبب فيروس غير معروف، هو أمر لا يمكن أن تستوعبه عقول بعضنا. ولكي نستوعبه، علينا أن نمنح موتنا قيمة ما، كالفداء، مثلا، في دعاء أمي الفصيح. "لا بد أن نتخلى عن حياتنا راضين، من أجل أن يعيش من نحب"، هذا ما تعتقده أمي، ربما، وهو اعتقاد لا يمكن أن يقنع فيروسا طائشا لا يفرق بين البشر وفقا لأي تصنيف. أضحكني استخدام أمي الفصحى، لكنني أجبتها بالعامية طبعا "لا يا ستي، عايزينك حية، ربنا يخليك لنا". عشنا أسبوعًا من القلق إلى أن تبين أن نتيجة تحليلها سلبية، هي وأخي وأختي. وعندما اتصلت بها لتهنئتها لم تنس أن تنهي المكالمة بقولها "لا إله إلا الله".
على النقيض من أمي التي أرادت، بلغة الأمومة، أن تفدينا بحياتها، يقف هؤلاء الذين طالما كرههم أبي، وطالما حذرني منهم: المتطرفين دينيًا. بطبيعة الأمور في مجتمع صعيدي، كان أبي متدينًا ذلك التدين الذي نسميه وسطيًا، فهو حريص على أداء الفروض، لكنه حريص أيضًا على عدم التباهي بذلك. ولم يكن أبي يحب السياسة، لكنه كان يكره الجماعات الإسلامية المتطرفة، التي أخذت تتنامى في بلدتنا وتنتشر وتكسب أرضا بين شبابها وفي مساجدها. ولم أفهم، وقتها، لماذا يحذرني الرجل الذي يصلي من هؤلاء الذين يصلون. فهمت ذلك لاحقًا عندما دارت آلة الدم، وتحول المصلون إلى مسلحين يقتلون مصلين آخرين من الديانة نفسها، ومن ديانات أخرى.
في بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، قال مسلمون متطرفون إن الفيروس عقاب إلهي للصين على قتلها مسلمي الأويجور. بدا لي الأمر كما لو أنني أمام فيروس مسلم مهمته قتل الآخرين غير المسلمين، وخاصة الذين يقتلون الأقليات المسلمة. وتخيلت للحظة أن فيروسًا مسيحيًا قد يظهر، ذات يوم، لينتقم للأقليات المسيحية في البلاد التي تتعرض فيها لاضطهاد، أو لينقذها على أقل تقدير. ولكن الفيروس سرعان ما انتقل إلى الولايات التي تسكنها الملايين من الأقليات المسلمة في الصين، وأصاب نسبة كبيرة من سكانها، فهل كفر الفيروس، وتحول فجأة إلى الديانة البوذية؟ لكنه استمر في قتل البوذيين والمسلمين معا، واستدار بعد ذلك ليقتل المسيحيين واليهود، فهل يعني هذا أننا أمام فيروس ملحد؟
البصقة كسلاح بيولوجي
في بداية ظهور فيروس كورونا في هولندا، حيث أقيم الآن، حدثت مشاجرة في مدينة روتردام، تبادل أطرافها السباب، قبل أن يتبادلوا اللكمات، وبصق أحد المتشاجرين على آخر. في الأحوال العادية، وقبل ظهور كورونا، لم يكن لتلك البصقة أن تحتل تلك المكانة التي احتلتها في التحقيق، فهي مجرد إهانة في الأعراف الثقافية والقانونية لكثير من البلدان. ولكن شيئًا تغير في التكييف القانوني لهذه البصقة، إذ اعتبرتها النيابة سلاحا، واعتبرت الفعل شروعا في القتل، ولم ينج فاعلها إلا بعدأن ثبت عدم إصابته بكورونا. الأمر نفسه حدث في السعودية عندما ضُبط عامل في مركز تجاري يبصق على عربات المتسوقين لينقل لهم عدوى كورونا. تغيرت التكييفات القانونية سريعا، وبشكل مرن، لكي تحافظ على حياة البشر، وتحفظ للمجتمعات سلامها، ولكن الأمر لم يحدث على المستوى الأقرب للبشر، وهو المستوى الديني.
في مصر، ظهرت دعوات لغلق الجوامع والكنائس ووقف صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وقداس الأحد، كإجراء وقائي ضد العدوى، ولكن الجمعة الأولى بعد ظهور هذه الدعوات شهدت نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة في التليفزيون المصري الحكومي، وخرج وزير الأوقاف بتصريحات يمكن فهمها بمنطق أن "الإيمان"، الذي يعني بالنسبة له، ربما، أداء العبادات كما هي في الأحوال الطبيعية، هو اللقاح ضد الفيروس. ولم يقتصر هذا الخطاب الساذج على وزير الأوقاف، فقد لاقى هوى عند الكثير ممن أفزعهم الفيروس. وفي خط مواز لوزير الأوقاف، كان الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط يتحدث في الاجتماع الأسبوعي، الذي يحضره مئات الأقباط، في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، عندما قال "إذا صلينا من قلبنا، الفيروس مش هيقرب مننا". ليس الغريب أن الكاتدرائية كانت مزدحمة، فهذا طبيعي في الأحوال العادية، ولكن الغريب هو أن الأنبا يؤانس تخرج في كلية الطب، قبل أن يصبح راهبا، أي أن معلوماته الطبية أفضل من وزير الأوقاف، ولكن الرجلين اتفقا على وضع ما يعتبرانه إيمانا في مواجهة العلم ومنطق التفكير العلمي.
كان ذلك في أواخر مارس الماضي تقريبا، واشتد الجدل حول منع صلاة الجمعة وقداس الأحد، وكل نشاط جماعي من المحتمل أن يؤدي إلى انتشار العدوى. وجدت الفكرة مقاومة قوية من المتشددين في كل الأديان: كان المسلمون يتصورون أن الدين مهدد إذا أغلقت المساجد، ومُنعت صلاة الجمعة، والمسيحيون يتصورون أن الدين مهدد إذا أغلقت الكنائس، ولم يقم قداس الأحد، أو إذا تغيرت طريقة أداء طقس التناول. بالإمكان فهم عدم قدرة العامة من الناس على استيعاب ما لم يتخيلوا يوما أن يحدث، لكن من الصعب فهم ذلك من رجال دين يفترض أن لديهم قدرا معقولا من العلم والثقافة. ماذا يضير الدين المسيحي إذا لم يتم التناول بملعقة واحدة منعا للعدوى؟ وماذا يضير الدين الإسلامي إذا صلى كل رب أسرة بأسرته؟ ما نفع صلاة تؤدي إلى نشر وباء؟
.. الله والرسول وأولي الأمر منكم
استمر أداء سر التناول إلى أن أغلقت الكنائس، واستمرت صلاة الجمعة وصلوات الجماعة إلى أن أغلقت المساجد، لكن شيئا لم يتغير في تفكير العامة، لأن شيئا لم يتغير في تفكير رجال الدين، إذ كان القرار سياسيا وملزما. قد يصطدم رجال الدين بالعلم والمنطق العلمي، لكنهم يعتبرون طاعة ولي الأمر واجبة في كل الأحوال، ظاهريا على الأقل. ونتيجة ذلك كانت واضحة على المستوى الشعبي، فالبسطاء الذين شاهدوا المساجد مغلقة لأول مرة في حياتهم تعرضوا لنوع من الصدمة التي أضيفت إلى صدمة فزعهم من الوباء. وفي ظل نقص المعلومات، بشكل عام، حول طبيعة الفيروس، لم يكن أمام هؤلاء سوى الدعاء برفع البلاء والقضاء على الوباء. ظهرت دعوات الدعاء من البلكونات في الإسكندرية بعد بداية الحظر الجزئي للتجول، تقليدًا، ربما، لغناء الإيطاليين والإسبان والفرنسيين في البلكونات. ولكن الدعوة تطورت إلى مظاهرات في الشوارع ضد الوباء. وتكررت المظاهرة نفسها، في الإسكندرية أيضًا، عندما حمل مواطنون نموذجا للكعبة طائفين به الشوارع، داعين الله أن يزيل الوباء. وهاتان مسيرتان تعيدان إلى الذاكرة مسيرة رصدها الجبرتي في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار. حل الوباء بمصر فدعا شيوخ في الأزهر إلى مسيرة نحو سفح المقطم للصلاة والدعاء في مواجهة الوباء، وكانت النتيجة- بالطبع- هي زيادة الوباء انتشارا وحصده المزيد من الموتى.
يريد الناس من رجال الدين أن يساعدوهم على الوصول إلى الطمأنينة والسلام، لا إلى اليقين، لأنهم يعرفون، ربما بشكل فطري، أن بإمكان الأوبئة أن تهز أي يقين. ويريد رجال الدين ألا تبور تجارتهم، وألا تتراجع سلطتهم الاجتماعية إذا شعر الناس بأنهم عاجزون عن إنقاذهم من الموت الجماعي. في إسرائيل، مثلا، يعتبر يهود متطرفون أن الوباء أمر جيد، لأنه يعجل بنهاية العالم، ووصول المخلّص. ينتشر هذا الاعتقاد بشكل أكبر عند المتطرفين من اليهود الحريديم الذين واجهوا فيروس كورونا بإنكاره، وواجهوا محاولات الحكومة الإسرائيلية احتواءه بالرفض. لا يؤمن هؤلاء بالعلم، حتى أن كثيرا منهم يرفضون فكرة العلاج من الأمراض، بوصفها اعتداء على المشيئة. وعندما حاولت الحكومة الإسرائيلية الوصول إليهم لتوعيتهم بالوباء لم تفلح، بل وجدت مقاومة شديدة، حتى أن أطفالهم وقفوا على نواصي الشوارع، وأخذوا يبصقون على الشرطة ليمنعوهم بسلاح البصقة البيولوجي من اقتحام أحيائهم.
لم يقصد الشاب الذي تشاجر في مدينة روتردام أن يستخدم البصقة سلاحًا، لكن القائمين على تطبيق القانون كانوا مرنين بحيث يمكنهم تقدير خطورة الفعل النسبية في سياقه الاجتماعي، واعتبروا البصق سلاحا يرقى استخدامه إلى حد "الشروع في القتل". هذه القدرة على النظر إلى الأمور بمنظور نسبي هو ما يفتقده المتشددون في كل الأديان تقريبا، ربما لأنهم يقفون على أرض المطلق، بحيث لا يمكنهم رؤية سواه. هنا تأتي المعضلة، إذ ينظر كثير من رجال الدين إلى العلم بوصفه نقيضا وتهديدا للإيمان، وهو قياس مغلوط لأنه من غير المنطقي قياس المطلق على النسبي، أو وضع النسبي في محل المطلق. وليس العلم، أو التفكير العلمي، نقيضا للإيمان بحال، لأنه يستخدم أدوات مختلفة ويقف على أرض مختلفة، لا يصح معها أن تقول إن الخشب نقيض للإنسان. ما يريده الناس من العلم هو تسهيل حياتهم العملية وفهم ظواهر الكون، وما يريدونه من الدين هم نيل الطمأنينة والسلام. أما ما يريده الكثير من رجال الدين، في أغلب الأديان، فهو الإبقاء على سلطتهم الاجتماعية بدون تهديد أو نقصان، حتى لو كان ذلك على جثة "الحياة".
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.