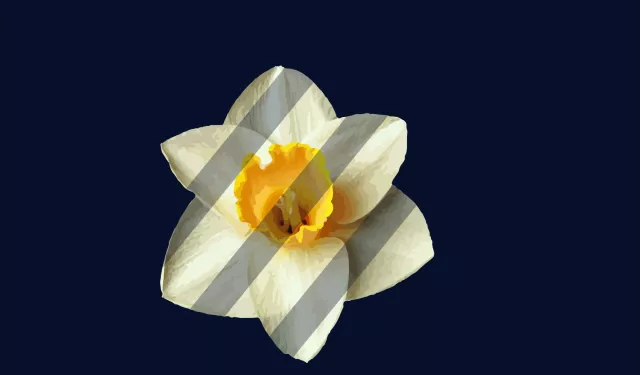
"يا رب".. أربعة حروف وأربع زهرات
"يا رب، يا رب، يا رب، يا رب..".
يأتي صوته ما بين التاسعة والتاسعة والنصف صباحًا، يخترق كل جدران الأصوات الصباحية؛ التلاميذ في فسحاتهم، والبوابون في غرفهم الصغيرة تحت بئر السلم مع أزيز عدادات المياه والكهرباء، وما تبقى من زقزقة عصافير الصباح الباكر، ومع أمثالي ممن يبدؤون يومهم في هذا التوقيت، يحيط بهم صوت أخبار الحروب والثورات.
يأتي صوت هذا الرجل ليرسم خطًا ممتدًا على أحد مسارات خيالنا، يقف عند تقاطعٍ ما بين الرجاء والاستغاثة، يتصاعد في جوف نفوسنا هذا الدعاء الحار، شديد الاختصار والتأثير، دعاء بلا ذيل أو مطالب، يحوي في كلمة واحدة كل شيء "في الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ. وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهُ".
يبدأ صوته خافتًا آتيًا من صحراء بعيدة في ذاكرتنا، ثم يتضخم ويقوى ويندمج شيئًا فشيئًا مع نسيج أصوات الحياة، عابرًا شوارعَ وعماراتٍ تُردِّدُ صداه.
خلال مروره السريع أمام بيتنا، لا تقل عدد المرات التي ينطق فيها اسم الله "يا رب.. يا رب.. يا رب" عن عشرٍ. يظل يرددها دون كلل، ودون أن تفقد حرارتها، كما رددها آلاف المرات في كل شوارع الحي الذي يبث بين جنباته استغاثاته الملهوفة.
في البدء، كان صوتًا صافيًا لشبح لا مرئي، مثل مسحراتي رمضان الذي كنا نسمع صوت ندائه المنغم على إيقاع طبلته. ثم يأتي يوم المفاجأة حين أراه في صبيحة العيد، واقفًا بجلبابه النظيف على باب بيتنا ليأخذ العيدية لقاء هذا النداء الذي كان يبيعه لنا ونحن نيام، فيأتي بالظلام الرحيم من الشارع ليضمه إلى أسرَّتنا، فيمنحنا دفئًا مضاعفًا.
رأيته أخيرًا، وطابقت هيئته على صوت استغاثته، فوجدت الصوت يفوق جسده النحيف الضئيل بمراحل. غيابه، مثل أي شيء، كان أقوى من رؤيته.
دعاء مختصر بلا بلاغة
بهذا الصوت القوي، كان يعري حاجته الماسة، ويُشهِد أهل الشارع والشوارع الجانبية عليها، ولم يعد هناك مكان داخل هذا الصوت لحاجة مخفية، بهذه الكلمة الوحيدة، الممتلئة بقداسة تاريخية، والتي هي عبارة عن أربعة حروف؛ كان يعترف ويستغفر، ويستنجد، ويستغيث، ويأمل.
نداءٌ عَارٍ يُشهِد فيه أيضًا الله على أهل الحي، فكل الكلمات الأخرى انسحبت من قاموسه الشخصي، ولم يعد هناك سوى الله الذي يراه ويقف أمامه بقوة صوته وحرارته، فهناك طريق مفتوح للاتصال معه عبر هذا النداء، فالله بالنسبة له ليس فقط الإله الذي يهمس له بالدعاء في ظلام نفسه، وإن كان هذا مشروعًا، ولكنه الله الذي يجأر أمامه بقوة، مستنجدًا به.
ربما تجعل الأُميَّة صاحبها بارعًا في صياغات بسيطة تشكل نظرته المختصرة للحياة
نداء مختصر بلا زيادات أو بلاغة، لا يعرف أي صياغات أخرى ممجوجة يتقنها الشحاذون عادة، يتحدثون فيها عن الأطفال اليتامى الذين ينتظرون في البيوت الطعام بينما أفواههم مفتوحة، أو المرضى المنسيين على أسرِّة مستشفيات عامة، ينتظرون إجراء عمليات خطيرة، وكل هذه الصيغ المستحدثة لترقيق القلوب.
لا يريد أن يستهلك استغاثته، فهو في النهاية فنان، يشكل حاجته ورسالته بأقل الإمكانات وأبسطها عبر كلمة وحيدة "يا رب"، يقيم عليها وظيفته في الدنيا، وطريقه للكسب.
حتى ولو كان يمثل، أو يدَّعي حاجةً ليست له، أو صوتًا ليس صوت مأساته الشخصية، فإنه يتقن هذا التمثيل وهذا التكرار اللا نهائي لكلمة "يا رب"، كأن كل أسماء الله توارت وراء الكواليس لتفسح لهذه الكلمة المفتاح دور البطولة والوقوف تحت دائرة الضوء، أمام جمهوره الصباحي الذي اعتاد الاستماع لندائه.
ربما كان شحاذًا أُمّيًّا، وهذا احتمال كبير، لا يعتمد على تشكيل حاجته باللغة، فقد جعلته هذه الأُمّيَّة يستنجد بأقل القليل مما يعرفه، بل ويتقنه ويجوِّده، ليحمل عنه رسالته إلى الله والناس.
فمن داخل هذه الكلمة تتناسل كل المعاني وتتفتح في آذان ووجدانات من يسمعها، وكلٌ على حدة يكملها بطريقته، هي المفتاح لباب تقف وراءه الكثير من المعاني والرجاءات.
ربما الأُمّيَّة، أحيانًا، تُغيِّر من شكل علاقة صاحبها باللغة، تجعله بارعًا في صياغات بسيطة تشكل نظرته المختصرة للحياة وللكون.
العذراء تنزل درجات المذبح
في قصة للكاتب الفرنسي أناتول فرانس اسمها الإيمان أو مهرج نوتردام يُحكى أن مهرج اسمه برنابا عاش سنوات حكم الملك لويس، يصفه المؤلف "كان رجلًا طيب القلب، يخاف الله، ويخلص كل الإخلاص للعذراء المقدسة، ولم يغفل أبدًا عند ذهابه إلى الكنيسة أن يركع أمام صورة والدة الإله، وأن يوجه إليها صلاته: سيدتي، احرسي حياتي إلى أن يحلو للرب أن أموت، وعندما أموت دعيني أمتع بمسرات جنة النعيم".
كانت مهنته التي يتكسب منها عيشه كمهرج أن يقذف في الهواء بسِتِّ كُرات نحاسية ثم يلتقطها بقدميه ثانية، بينما يضع رأسه ويديه على الأرض، أو يرتمي بجسمه إلى الوراء حتى تصل رقبته إلى رجليه ويُشكل من جسده دائرة، وعلى هذا الوضع الصعب يلعب باثنتي عشرة سكينًا.
هؤلاء الوحيدون الأميون غير المتأقلمين، يملكون موهبة ما لأن حياتهم محدودة وكلماتهم محدودة
ولكن هذه المهنة لم تكن توفر له عيشًا مُرضيًا. في أحد الأيام قابل كاهنًا ورئيسَ أحدِ الأديرة، تبادلا الحديث في الطريق، وجد الكاهن في كلامه وسلوكه طيبة، فأشار عليه بدخول الدير الذي يرأسه ليدله على طريق الخلاص. وجد هذا العرض صداه داخل نفس برنابا، فحياة الرهبان كانت بالنسبة له لها قيمة تفوق قيمة موهبته. دخل الدير وأصبح كاهنًا، ومن هنا بدأت معاناة جديدة له.
كان كل واحد من رهبان الدير متخصصًا، بفضل موهبته، في مجال له علاقة بعبادة وخدمة السيدة العذراء، فكان الرئيس يؤلف الكتب عنها، وهناك من ينحت تماثيلها، وهناك من يرسمها، ومن يمدحها أو يترنم باسمها، أما هو فكان حزينًا من قلة حيلته، وقصور أدواته التي تمنع إظهار حبه للسيدة العذراء أم الإله.
وفي إحدى الليالي، سمع برنابا أحد الرهبان يقص قصة راهب آخر، كان لا يعرف صلاةً غير "السلام لكِ يا ماريا"؛ لذا كان مُحتقرًا من طرف الآخرين لجهله وسذاجته. لكنه لما مات صعدت من فمه خمس زهرات تمجيدًا لكل حرف من حروف اسم "ماريا"، وبذلك ظهرت قداسته.
أعجب برنابا بتلك الحكاية، وجد فيها خلاصه، فكان يوميًا يختفي داخل الكنيسة أثناء تناول باقي الرهبان لطعامهم، مما أثار استغرابهم من غيابه اليومي، فما كان من رئيس الدير إلا أن راقبه ليعرف ماذا يفعل داخل الكنيسة، وذهب بصحبة راهبين، وأخذوا يراقبونه من شقوق الباب.
"رأوا برنابا أمام مذبح السيدة العذراء، ورأسه على الأرض ورجلاه في الهواء، وكان يلعب وهو في هذا الموقف بستِّ كُرات نحاسية واثنتي عشرة سكينًا! واستمر في القيام بعمل تلك الألعاب التي كان قد اتخذها صنعة، والتي صادفت أعظم استحسان في الماضي! ولكنه كان الآن يقوم بتلك الألعاب تكريمًا لأم الإله المقدسة".
شكوُّا جميعًا بأنه مسه الجنون، وسارعوا لإبعاده عن المذبح المقدس الذي لا يليق أن تقام أمامه مثل هذه الألعاب، "وبينما كانوا يستعدون للدخول والإسراع بإخراجه من الكنيسة، رأوا فجأة العذراء المقدسة تنزل درجات المذبح كي تجفف العرق الذي كان يتساقط من جبهة المهرج بثنية من ثنيات طرحتها الزرقاء". وكانت هذه علامة قداسته.
هؤلاء الوحيدون الأميُّون غير المتأقلمين
أصبح الصباح هو المذبح الذي يؤدي فيه هذا الشحاذ لعبته الوحيدة التي يجيدها، ويكرر نداءه، لعل الله يفتح له الباب ويشهد معجزاته.
لم أندهش عندما تتبعت الرجل في دورة عمله الثانية حوالي الحادية عشرة، قابلته عند محطة الترام وهو يعد حصيلة الصباح من النقود الورقية. ربما أردت أن أرصده متلبسًا في لحظة تناقض بين استغاثته، وإخلاصه وزهده، وكأني قبضت عليه متلبسًا بالرشوة بينما اسم الله على لسانه! كان من الطبيعي أن يجد ما يكفي حياته في حدودها الدنيا، ليعيش هذا النداء الحار، الذي لم يتعلم غيره في حياته.
هؤلاء الوحيدون، الأميون، غير المتأقلمين، يملكون موهبة ما، ليس لبراعة فيهم، ولكن لأن حياتهم محدودة وكلماتهم محدودة، وحاجاتهم مكشوفة، وداخل هذه الحدود الصارمة هناك إمكانية لفهم الحياة وتجاوز محدوديتها بتحويلها إلى جملة تكرارية، إلى صوت، إلى موهبة تُجوَّد كل يوم، لتعكس وضعهم الإنساني الحرج والناقص، وقد لا تعكس هذه الموهبة باقي العالم، ولكنهم لا يحتاجونه، ولا يحتاج باقي العالم أيضًا لسماعهم. فالآخر بالنسبة لهم هو الله "يا رب"، الكلي الذي يحوي الكون، ويتوجهون له بالدعاء والاستغاثة.
مثلما أفعل في حياتي أيضًا بالكتابة، أطرق يوميًا وبإصرار على باب هذا العالم لتنفتح لي كُوَّة، أحمل عليها كسفينة نوح رغبتي في الخلاص. مهما انفتحت لي من عوالم أخرى، في النهاية أنا مسجون داخل هذا الجسد وهذه الروح، أُمِّيٌّ بطريقة ما، أحمل نسخة محسنة من هذا الرجل الشحاذ.
عبر العلاقة العميقة بالكلمة، وإرادة التكرار، والأمل والثقة فيما نملك، حتى ولو كان قليلًا، اقترب صاحبنا الشحاذ من مهرج أناتول فرانس الذي آمن بموهبته، ومن الراهب، الذي كان يكرر "السلام إليك يا ماريا". وربما يومًا ما ستصعد من فمه أربع زهرات، بعدد حروف كلمة "يا رب".
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.
