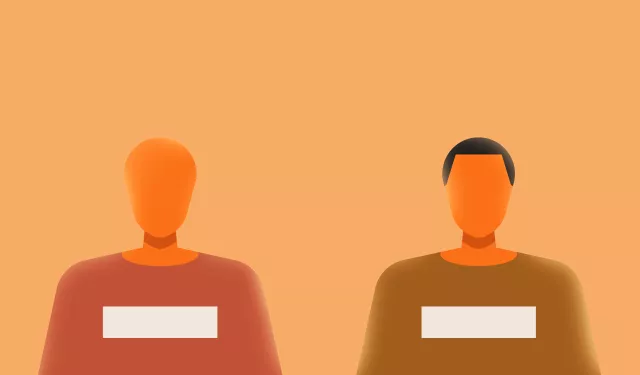
ذهبت الملكية وجاءت الجمهورية لتتوحش المعتقلات
في العام التالي لإعلان استقلال مصر ونهاية الحماية البريطانية عام 1922، أُقرَّ أول دستور في تاريخ البلاد، منهيًا حقبة قُنِّن فيها النفي الإداري وغيره من الإجراءات التعسفية في ظل أحكام عرفية سمحت للاحتلال باختطاف آلاف الشباب المصريين للعمل في خدمة جنود الإنجليز في الشام، فيما أصطلح على تسميته بـ"السلطة".
لكن دستور 1923 رسَّخ لحياة سياسية وحزبية فعالة، قيَّدت بدورها الأحكام العرفية لتقتصر على ظروف الخطر ولفترات مؤقتة تحت عين البرلمان، وهو ما حدث عام 1943 على وقع امتداد أثر الحرب العالمية الثانية إلى مصر، مع اقتراب الجيش الألماني بقيادة روميل من العلمين، واحتشاد البريطانيين لمواجهته.
في هذه الأثناء، انقسم المصريون بين من يرون الحل في مد أياديهم للنازي لأن هزيمة الإنجليز هي السبيل الوحيد لجلائهم عن مصر، وعلى رأسهم الملك فاروق وعلي ماهر وحزب مصر الفتاة، ومن يرون أن المفاوضات مع الإنجليز هي السبيل الوحيد للجلاء، وعلى رأسهم حزب الوفد.
ومع فرض الأحكام العرفية وإزاء احتدام الصراع في الشارع، اعتقل النحاس باشا العشرات من أنصار ألمانيا من بينهم الكاتب الصحفي موسى صبري، الذي يقول في كتابه خمسون عامًا فى قطار الصحافة؛ "تسلمنا لائحة الاعتقال التي تحدد أسباب الاعتقال وحقوق المعتقل وواجباته، وغالبًا لم يكن هناك ممنوع على المعتقلين إلا الخروج من المعتقل، وكان من بين بنود تلك اللائحة حصول المعتقل على 'مكافأة اعتقال' قيمتها تسعة جنيهات"، ويشير إلى أن هذا المبلغ كان يعادل راتب خريج الجامعة.
ويضيف "كان من بيننا نحن المعتقلين الفقراء الذين يحتفظون من المكافأة بجنيه ويرسلون الباقي لأسرهم، أما بعض الأثرياء فقد أنشأوا بمكافأتهم ميز واستأجروا طاهيًا وفرد مراسلة لشراء الطعام الشهي من خارج المعتقل، كما كنا نرسله إلى بيوتنا ليسلم أمهاتنا ملابسنا المتسخة ويأتي بغيرها نظيفة وبما نحب من كتب وأقلام وأوراق وسجائر وطعام وحلوى وجاتوه".
لم يذكر أحد ممن كتبوا مذكراتهم عن أيام الاعتقال في العهد الملكي شيئًا عن تعذيب أو ضرب أو إهانات
وفي سنة 1946، أُعلنت الأحكام العرفية مرة أخرى مع اتساع نطاق المظاهرات المطالبة بالجلاء، فأُعتقل كثيرون كان من بينهم الرئيس الراحل أنور السادات، والأستاذ محمود المليجي المحامي عضو حزب مصر الفتاة، الذي يحكي في كتابه "خرابيش على جدار الزمن" عن ظروف اعتقاله في سجن الأجانب الذي كان موجودًا بالقرب من ميدان رمسيس.
لم تكن هناك ممنوعات كثيرة، بل يتذكر المليجي أن أباه أتى من المنصورة ومعه قُفَّة مليئة بالفطير والحمام والبط وأبرمة الأرز المعمر. وعندما طلب من مأمور السجن أن يسمح لأبيه بقضاء الليلة معه في الزنزانة، وافق على إدخال سرير له مقابل عشرة قروش، "وفي المساء دعوت زملائي في المعتقل وإدارته من ضباط وجنود لتناول العشاء الذي جلبه أبي، وتحول العشاء إلى ندوة سياسية رائعة".
ويقول أيضًا "ولما زادت أعدادنا قررت السلطات إبعاد مكان اعتقالنا ليصبح قصر ماقوسة في المنيا، الذي كان مُلكًا لإقطاعي كبير جهزه بأثاث إيطالي ليتزوج أخت هدى شعراوى بنت محمد سلطان باشا، رئيس وزراء مصر لمرات متتالية في آخر القرن التاسع عشر، فلما رفض الباشا التركي ذلك الزواج زهد فيه الرجل وأجره للدولة التي اعتقلتنا فيه جميعًا، حيث كانت تأتينا ثلاث وجبات يومية من فندق إيتاب"، أهم فنادق المنيا في ذلك الوقت. ويضيف أيضًا "انتزعنا من إدارة المعتقل حق الخروج فى جولة حرة بمفردنا لثلاث ساعات في ميدان المحطة بالمنيا، وفى إحدى هذه الجولات فرَّ السادات من المعتقل".
أمثال هذه الحكايات تتكرر في كتب فوزي حبشي معتقل كل العصور ومحمود توفيق المحامي مع الأيام وغيرهما، وأهم ما يمكن ملاحظته هنا أن الاعتقال كان مجرد إجراء احترازي يتم فقط لمنع المعتقل من الوجود في الشارع والتواصل مع الناس.
لم يذكر أحد ممن كتبوا مذكراتهم عن أيام الاعتقال في العهد الملكي شيئًا عن تعذيب أو ضرب أو إهانات، وأعتقد أن لهذا سببين؛ أن الضباط والجنود كانوا يلتزمون بالقانون الذي يمنع الضرب والإيذاء ولا يرون مبررًا لاستعداء المعتقلين، والثاني أن تداول السلطة قد يجعل من معتقل اليوم رئيس وزراء الغد، مثلما حدث مع علي ماهر الذي اعتقله النحاس عام 1943، وعاد بعدها رئيسًا للوزراء.
.. وجاءت الجمهورية
لكن ذلك كله تغيَّر مع استلام الضباط الأحرار مقاليد السلطة، لتصبح المعتقلات شيئًا آخر. أُلغي دستور 1923، وحُلَّت الأحزاب السياسية، وانتهى عهد تداول السلطة، واحتكر الضباط العمل السياسي كله وسعى نظامهم أيضًا إلى احتكار الوطنية.
ومن هنا لم يعد المختلفون سياسيًا مع توجهات النظام مجرد معارضين؛ فقد أصبح العداء للنظام عداءً للوطن وُصِمتْ به قوى سياسية بأكملها كالشيوعيين والإخوان المسلمين. بل وتوسع النظام في المحاكم الاستثنائية بعيدًا عن القوانين الطبيعية التي تضمن تحقيق العدالة، مثل محاكم "الشعب" و"الثورة" و"الغدر"، وبعضها يرأسها ضباط، وتتوسع في عقوباتها.
فإلى جانب السجن، يمكن لهذه المحاكم الاستثنائية أن تعاقب بمصادرة الأموال والممتلكات، وتمنع من السفر بل وحتى تقيِّد حرية الانتقال والحركة داخل الوطن، وشهدت مصر فى الخمسينيات حملتي اعتقال هائلتين، طالت الأولى سنة 1954 الآلاف من الإخوان المسلمين عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية بالإسكندرية. أما الثانية فطالت الشيوعيين من جميع المنظمات الشيوعية مطلع 1959.
ورغم صعوبة الحصول على تعليمات تبيح التعذيب، فإن جميع أدبيات السجون ومذكرات المعتقلين في زمن عبد الناصر تذكر أشكالًا من الأهوال التي تعرض لها المعتقلون؛ من ضرب وجلد وتجويع وتكسير الصخور في الجبل، إلى حدِّ قتل شهدي عطية الشافعي والدكتور فريد حداد وغيرهما تحت وطأة التعذيب.
وفي زمن السادات استمر الاعتقال بممارساته رغم زعمه في بداية حكمه بتدمير وهدم المعتقلات. وتصاعدت عمليات الاعتقال حتى وصلت إلى أقصاها في سبتمبر/أيلول 1981، مع موجة الاعتقالات الشهيرة التي طالت أكثر من 1500 شخص من رموز القوى السياسية المختلفة؛ إسلاميين ويسارًا وليبراليين ووفديين وغيرهم، واغتيل بعدها السادات بشهر واحد، ليستكمل خليفته مبارك المسيرة، محتميًا بقانون الطوارئ الذي ظلَّ معمولًا به طوال فترة حكمه المديد.
أما في عهدنا هذا، فقد استمر الاعتقال مع تبديل اسمه إلى الحبس الاحتياطي، بل وجرى التوسع فيه بافتتاح 26 سجنًا جديدًا، وإقرار قوانين مثل قانون الإرهاب وانتهاج سياسات مثل التدوير. ولم يعد هناك معقب على قرارات نيابة أمن الدولة، حتى بات عاديًا أن يُحبس أحدهم أشهرًا طويلةً بسبب كتابة مقال مُعارض أو مشاركة بوست ناقد على السوشيال ميديا، أو رفع لافتة "لا للتعذيب" في الطريق العام.
شاعت التهم العامة عديمة المعنى مثل الانتماء لجماعة إرهابية أو مشاركتها في تحقيق أهدافها، أو سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة أخبار كاذبة. وهي تهم يواجهها ناشطون وصحفيون وفنانون لن يكون آخرهم المترجم والكاتب والرسام أشرف عمر، الذي يُجدد حبسه بشكل آلي منذ القبض عليه في يوليو/تموز الماضي، بسبب رسوماته الكاريكاتيرية التي نشرتها المنصة وفيها يسخر من عبثية السعي لحل الأزمة الاقتصادية بالقروض، أو من الإصرار على "الفشخرة" بالمونوريل في ظل أزمة الكهرباء، أو من بيع الوطن لمستثمري الخليج.
فإلى متى تستسهل الجمهورية في مصر، قديمة كانت أم جديدة، كل هذه التجاوزات لمبادئ العدل والقانون وحقوق البشر؟
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.
