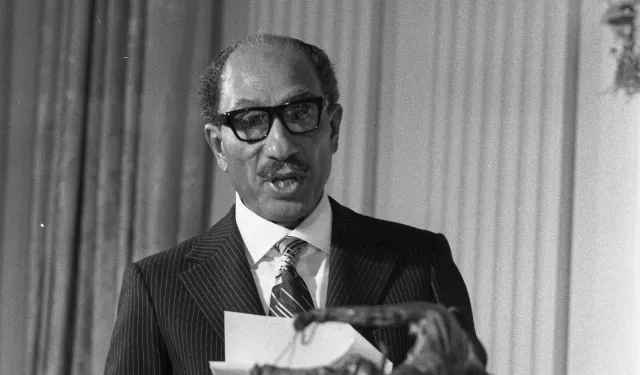
ذكرى أكتوبر.. نصر أفقده الاستبداد بريقه
تمر هذا العام، الذكرى الخمسون لمعركة السادس من أكتوبر المجيدة، ويخيل إليَّ أنه أصبح من المحتم تقييمها بنظرة ناقدة، تبتعد بقدر ابتعاد السنين عن العاطفة التي صاحبت ذكراها كل عام. وهو ليس بالأمر اليسير، خاصة وأني كنت أحد الجنود المشاركين في المعارك.
رغم ما يحمله هذا المقال من نقد، إلا أنه لا ينتقص من اعتزازي وفخري بمشاركتي في هذا الحدث، وبتضحيات الشعب المصري، وبما حققته قواته المسلحة في مدى زمني لم يتعد الـ6 أعوام من الهزيمة المروعة.
ما بعد الهزيمة
بدأ التخطيط لعمل عسكري منذ الشهور الأولى التي تلت النكسة لإزالة آثار العدوان، ولم تكن الخطة الأولية، التي تم على ضوئها تنظيم الجيش المصري وإعادة تسليحه وتدريبه، تختلف كثيرًا عن الخطة التي تم تطويرها خلال السنوات اللاحقة طبقًا للمستجدات في حجم القوات، ونوعية تسليحها، ونُفذت في 73.
في بداية السبعينيات، كانت الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة داخليًا وخارجيًا، تدفع إلى التحرك العسكري وفق الخطة التي استمر التخطيط لها والتدريب عليها سنوات عديدة.
تلك الخطة كانت تستهدف في الأساس القيام بعملية عسكرية محدودة لعبور القناة، وتدمير دفاعات العدو على الضفة الشرقية بطول القناة، فضلًا عن السيطرة على شريط بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلو مترًا، وتعزيز دفاعاتنا. يلي ذلك وقفة تعبوية لإعطاء الفرصة لحل سياسي؛ تشارك فيه القوى الدولية المدفوعة بالرغبة في إعادة فتح قناة السويس، وتأمين احتياجاتها البترولية.
أخطاء استراتيجية
وعلى الرغم من واقعية الخطة، وأخذها في الاعتبار قدراتنا العسكرية واللوجستية والاقتصادية، إلا أنني أرى أنها للأسف؛ تضمنت أيضًا تجاهلًا لمبادئ عسكرية وسياسية غاية في الأهمية يمكن تلخيصها في:
1- أهمية البدء بالهجوم، دون منح العدو فرصة لالتقاط الأنفاس، وحرية اختيار الخطوة التالية بعد تنظيم صفوفه وإعادة تسليح قواته، إذ يعد ذلك نقطة ضعف قاتلة، قد تؤدي إلى عكس مسار المعركة.
2- إعلان وقف القتال والرهان على موقف دولي إيجابي ومؤثر، مغامرة غير مضمونة وبالغة الخطورة، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد التسلح بضمانات كافية لتحقيق أهدافه.
3- لا يقبل الطرف الخاسر وقفًا لإطلاق النار، ثم الجلوس على مائدة المفاوضات دون قتال ممتد، ينتج عنه تدمير شبه كامل لقدراته العسكرية، وتعريض حدوده الدولية ومواطنيه لخطر داهم، مما يفقده الأمل في تحسين موقفه العسكري. وهو ما لم يحدث في المعركة.
خاصة وأن السيادة الجوية كانت للجانب الإسرائيلي منذ نشأت دولته، وفي ظل حيازتها لم يكن بمقدور القوات المصرية التغلغل في سيناء لتدمير قوات العدو واحتياطياته الرئيسية، فلم تتعدَ الخسائر العسكرية الإسرائيلية المؤكدة قوات مخصصة للمراقبة، والدفاع عن خط برليف، وقوات الاحتياطي التكتيكي في غرب الممرات.
4- حيازة إسرائيل قوة جوية تضمن لها تغيير مسار المعركة، إذا تمكّنت من إحداث ثغرة في حائط الصواريخ، سواء بالهجمات الأرضية أو بما لديها من أسلحة تشويش متقدمة، وذلك ما كانت تستهدفه قبل قبولها بإعلان وقف إطلاق النيران.
5- التعامل مع إسرائيل، ذات التاريخ الممتد في تحدي القرارات الدولية بدعم أمريكي، باعتبارها ستقبل وضعًا ليس في مصلحتها.
الحصار والمفاوضات
في ظني لم تكن هذه النقاط ذاتها غائبة عن الجانب المصري لحظة اتخاذه لقرار القتال، يبدو ذلك واضحًا في اعتماد خطته على ضمان دفاع قوي قادر على إنهاك العدو، وتكبيده خسائر جسيمة، عن طريق تحييد قدراته الجوية. كان الدفاع الجوي المصري المتمركز على الضفة الغربية للقناة فعالًا ومؤمنًا ومجهزًا هندسيًا، قادرًا على توفير الحماية للقوات التي ستعبر إلى شرق القناة.
غير أن محدودية الخيارات في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية التي كانت أمام صانع القرار في مصر، مع الإقرار بضعف قدرتنا على خوض حرب طويلة شاملة، دون إمدادات خارجية، في ظل توتر العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وطرد الخبراء، دفعنا نحو مائدة المفاوضات.
أصر السادات على تطوير الهجوم في توقيت خاطئ وخارج مظلة دفاعنا الجوي
مع الساعات الأولى للقتال، كان واضحًا تمكن القوات المصرية من تحقيق المفاجأة الكاملة التي أربكت العدو وأضعفت أداءه، بفضل بطولة وتضحيات الجنود، وبخسائر أقل كثيرًا مما كان متوقعًا، لكن ذلك لم يستمر، إذ أدرك السادات بداية من الخامس عشر من أكتوبر خسارته لعنصر المفاجأة لتنتقل للعدو، كانت نتيجتها تثبيت الجبهة المصرية، والقيام بهجمات مضادة على الجبهة الشمالية تمكنت من دفع القوات السورية إلى ما وراء خط بداية القتال، بعد خسائر حيدتها، ليتفرغ العدو بعدها للجبهة المصرية.
خروج الجبهة الشمالية مبكرًا من المواجهة، وهو ما لم يكن في الحسبان، أدى إلى قرار السادات المفاجئ بالتخلي عن الخطة الأصلية، وتطوير الهجوم لاستعادة زمام المبادرة المفقودة وتخفيف الضغط على الجبهة السورية.
هذا التطوير المفاجئ المفتقد للدراسة والإعداد، كان سببًا لخلافات بين القادة في غرفة العمليات والقادة الميدانيين.
أصر السادات على التدخل، لتنفيذ "تطوير الخطة"، الذي اعتمد على الدفع بقوات الاحتياطي التعبوي، المجهزة للقيام بالهجمات المضادة لسد الثغرات في جبهة القتال، وتطوير الهجوم في توقيت خاطئ وخارج مظلة دفاعنا الجوي. فضلًا عن نقص المعلومات عن تحركات العدو، ومواقع قواته نظرًا لافتقاد الجيش لوسائل الاستطلاع الحديثة.
فشل عمليات التطوير، وما تبعه من خسائر فادحة، أدى إلى إضعاف دفاعاتنا، ليفتح المجال للجانب الإسرائيلي للهجوم واختراق الجبهة، ومحاصرة الجيش الثالث فيما عُرف بثغرة الدفرسوار.
الاستبداد طريق الهزيمة
نتيجة لما سبق، هرع السادات، الذي كان لا يزال منتشيًا بالنصر، مذعورًا يطالب المجتمع الدولي بإلحاح التدخل لوقف القتال، وهو ذات الطلب الذي رفضه في الأسبوع الأول من المعركة.
بعد مماطلات، وبعد تأكدها من عدم قدرتها على احتلال مدينة السويس والإسماعيلية، أو إجبار القوات المصرية على التراجع إلى الضفة الغربية، قبلت إسرائيل وقف إطلاق النيران، الذي أصبح نافذًا بوصول مراقبين من الأمم المتحدة، وبدء محادثات الهدنة يوم 28 أكتوبر.
بدأت المحادثات، وفي يد إسرائيل ورقة رابحة، وهي الحصار الكامل لما يقرب من 40 ألف جندي مصري في الثغرة، وهو ما أجبر مصر على قبول عقد مباحاثات الهدنة، فيما تقف القوات الإسرائيلية على بعد 100 كيلو متر من القاهرة.
اُعتبر ذلك بمثابة انصياع مبكر للشروط الإسرائيلية، ومنها السماح بإمداد القوات المصرية المحاصرة بالغذاء والماء بمقادير متفّق عليها برعاية الأمم المتحدة، وبعد تفتيشها وموافقة الإسرائيليين على مرورها، وهو الشرط الذي لعبت به إسرائيل كوسيلة ضغط خلال محادثات فك الاشتباك على مدار 3 أشهر، هي مدة الحصار.
قدم السادات في محادثات كامب ديفيد تنازلات سياسية مؤلمة، دفعت بـ3 وزراء خارجية للاستقالة
لتنجح بعدها في إجبار القوات المصرية على الانسحاب الكامل للقوات المصرية من الضفة الشرقية للقناة، مع الاحتفاظ بقوات رمزية محدودة تم الاتفاق على أعدادها وتسليحها، بما لا يمثل عائقًا أمام القوات الإسرائيلية في حال رغبت في استعادة مواقعها لما قبل السادس من أكتوبر.
وهو ما يُعد في رأيي، نتيجة مباشرة للاستبداد السياسي وحكم الفرد، الذي قاد إلى خسارة فرصة تاريخية على المستويين العسكري والسياسي بالرغم من البداية الموفقة، وهي ذاتها الأسباب التي تكررت في 3 مواجهات سابقة على مدار 25 عامًا، متسبّبة في هزائم لا نزال نعاني نتائجها السياسية والاقتصادية إلى اليوم.
لم يتعلم السادات درسه جيدًا، وفي الوقت الذي انفجرت فيه مظاهرات يناير/كانون الثاني 1977 في المدن المصرية، بعد معاناة الشعب من الظروف الاقتصادية المتدهورة في سنوات الحرب، وما تلاها من وعود بتحسن المعيشة إثر قرارات الانفتاح الاقتصادي، سعى منفردًا للوصول إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل.
شعوره بتهديد سلطته، من المظاهرات التي كادت تطيح به، جعلته يسعى لدعم أمريكي، كانت نتيجته عقد اتفاق سلام متعجل تحت رعايتها، من دون موافقة شعبية أو تنسيق إقليمي. قدم خلال محادثاته، التي استمرت 12 يومًا في كامب ديفيد، تنازلات سياسية مؤلمة، دفعت بـ3 وزراء خارجية للاستقالة.
ليتأكد لنا بعد المواجهات المتتالية مع إسرائيل أن أهم مقوّمات القوة الحقيقية الشاملة لأي أمّة تعتمد على النظام السياسي القائم، فالأنظمة المستبدة المنتمية للعصور الوسطى لا يمكنها تحقيق أي إنجاز حقيقي لشعوبها في الحرب أو السلم، إذ تنحصر أهدافها الفعلية في البقاء في السلطة، ولو بدعم خارجي، دون رقابة أو حساب على أخطائها، أو جرائمها في حق شعوبها المقهورة.
كل عام والشعب المصري طيب، فهو من خاض معركة الكرامة ورفض الهزيمة، التي فرضتها عليه السلطة القمعية، ثم حاولت بعد ذلك نسبة انتصار الحرب لها وحدها، تطهرًا من عار هزائمها السابقة.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.