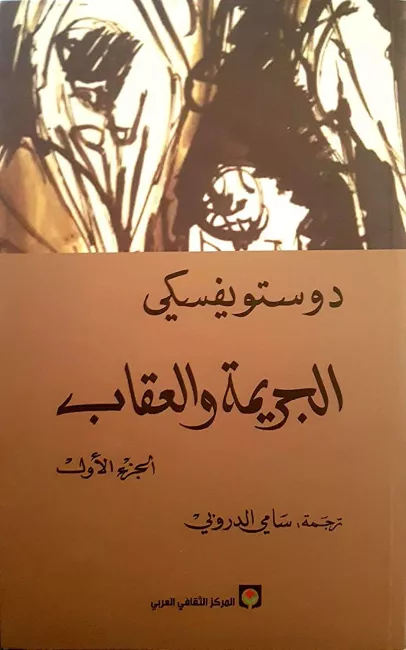عندما قابلت بطرس بتروفيتش لوجين
في رواية الجريمة والعقاب، لا يستهدف بطرس بتروفيتش لوجين من لقائه الأول براسكولينكوف غير إثارة إعجابه. يزوره في ملابس جديدة براقة كأنها خرجت لتوها من تحت يد الخياط، ثم يثير معه أحاديث متكلفة ليبرز حجم ما يحوزه من ثقافة، حتى أن رازوميخين، الجالس معهما، لا يتحرج أن يقول له قرب نهاية الجلسة أن أفكاره تبث "في نفسي التقزز (...) لقد تسرعت كثيرًا في إظهار ثقافتك وإبراز معارفك. وذلك أمر يمكن أن يغفر لك. ولست ألومك عليه". وقد قابلتُ لوجين، وعلى العكس من رازوميخين، أريد لومه.
ربما جاء لقاء "الخطيب" المفترض بصهره المستقبلي، راسكولينكوف، في توقيت غير ملائم، وأفاق الأخير لتوه من الحمى بعد قتله المرابية العجوز. ولا يسعدني أن أشبه مهنتي، محررًا صحفيًّا، بالقتل، أو أن أصف ما قد أواجهه فيها أحيانًا من ضغوط بتأثير الحمى على المريض. وإنما يُشْبه لوجين ذلك الصديق، الذي التقيته بدافع العمل، لنناقش بعض الأفكار لقصص صحفية محتملة ونتبادل التعليقات على أخرى عملنا عليها معًا.
حين اتخذ الخطيب الروسي الذي يعمل محاميًا، وينتمي إلى الطبقة الوسطى، القرار بزيارة صهره، فتأنق ورتب، ربما، ما سيخوضانه معًا من أحاديث، كان مدفوعًا برغبة تأكيد خلفيته الاجتماعية والثقافية التي تجعله ليس أهلًا لتلك الزيجة فحسب، وإنّما أرفع منها. وكان بيني وذلك الصديق تلك الندية المستترة، بسبب اقتراحاتي التحريرية التي فرضت إعادة بناء قصته وحذف الكثير منها، فكان في حديثنا كلما أشرت إلى فكرة أحالها إلى كتاب قرأه أو اقتباس من كاتب مشهور، في تكلّف جعله يجمع جادًا بين أشرف العشماوي ونجيب محفوظ، أو بين الأخير وأنيس منصور! دون أن ينسى، بالطبع، الإشارة إلى أصوله العائلية الأرستقراطية، التي لا أعرف حتى الآن علاقتها بلقائنا أو ما تضمنه من ثرثرة.
ربما الكتابة، لأنّها فعل يتطلب مجهودًا ذهنيًا، أنسب لتحقيق تلك الغاية من الكلام؛ غاية الإعلان عن النفس. ولذلك أيضًا لا تزال الكتابة، للصحافة تحديدًا، تملك وجاهة اجتماعية، مهما بدت تفاهة الفكرة. ورغم ما يثار يوميًا من ألسنة فارغة عن جهل الناس وبخسهم القراءة، لعل ذلك، للسخرية، ما يُكسبها تلك الوجاهة؛ أن تبدو وكأنك تمارس بأسى ونبل ما هو ضد التيار، أن تكون نبيًا في زمن يُعرض عن الأنبياء ويزهد في مفهوم النبوة.
وأنا لماذا أكتب؟
أكتبُ لأنني في الحقيقة فاشل في كل مهنة غير الكتابة، أو كسول بما يكفي لأدرك الفشل فيما سواها.
أكتب لأنها مهنتي. وهي الإجابة الرئيسية لسؤال دوافع الكتابة
في بداية سنوات الجامعة، كنت في الإجازة أبيع شاشات الكمبيوتر وأجهزة الديسكتوب "وارد خارج". وكانت المهنة، التي لم أصمد فيها غير أسبوعين، تعتمد كليًا على العضلات لا مهارة البيع. أرص مع زملائي بضاعتنا في الصباح أمام المحل وألمها في الليل، وإذا اشترى أحدهم مني شاشة أحملها إليه حتى سيارته، أو إلى خارج أبواب مول "كوين سنتر" بشارع الخليفة المأمون، حتى يمنحني "الشاي" (الإكرامية)، أو حين يصل ما يستورده صاحب المحل من كونتينرات البضاعة الجديدة فنذهب بعد منتصف الليل لتفريغها وتشوينها في المخزن بالكوربة.
أحبني زملائي، لأنني كنت الأصغر، وربما جعلني ذلك مستلطفًا، أو ربما كانوا يعاملونني بشفقة لأنني كنت أحمل إلى العمل ما أكتبه من قصص فأنقحها أو أعيد قراءتها على بعضهم عنوة، وكأنني لا أنتمي لذلك المكان، أو كأنني توهمت هذا بينما أبرر رغبتي في ترك العمل بعد أسبوعين فقط، لأيمن، أكبر العاملين في المحل، مؤكدًا أنني لا أصلح للأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا. هل ذهبت إلى مول "كوين سنتر" وأنا أرتدي معطف بطرس بتروفيتش لوجين؟
ربما هذا ما أدركه الآن! وربما ما زلت أرتدي معطفه، لكن في صورة أخرى، تدعي التواضع لإثارة الإعجاب أيضًا. رغم ذلك أودّ فعلًا أن أسأل ذلك الصديق: لماذا تكتب؟
أنا أكتب لأنها مهنتي. وهي الإجابة الرئيسية لسؤال دوافع الكتابة.
إتقان الكتابة، هو أن تكتب ببساطة قدرتك على الكلام. ويتحقق ذلك عندما يعامل الكاتب نصه بجدية
كنتُ في طفولتي، وربما ما زلت كذلك، أتحدث سريعًا فأستّف ما أريد قوله وكأن لساني يسابق أنفاسي، وكانت زوجة عمي تعلق ساخرة على طريقتي في الكلام بقولها "واحدة واحدة عليَّ يا أستاذ ملواني" في استعارة لشخصية عبد الله فرغلي من مسرحية مدرسة المشاغبين!
وفي فيلم النمر والثلج لروبيرتو بنجيني، وبينما كان البطل طفلًا، سقط على يده عصفور وغنى، فاندهش الولد لروعة الموقف والصوت على السواء، فجرى إلى أمه يصفر في عصبية مثلما كان يفعل الطائر، ويقص عليها ما حدث. لم تفهمه الأم أو تمنحه اهتمامًا، وكانت تلك اللحظة نفسها، التي فطن فيها الطفل "أتيليو" إلى ضرورة أن يصير كاتبًا كي يستطيع أن يحكي عن نفسه بصورة أفضل.
كل شيء حكاية؛ منذ بدأ الإنسان البحث عن ماهية وجوده؛ يحكي. ومهنتنا، مهنتي؛ الصحافة، في الأصل وسيلة العصر الحديث لتمرير القصص. ولكن أي سردية نحكي وبأي لسان نخبر عنها؟
أدعي أن إتقان الكتابة، هو أن تكتب ببساطة قدرتك على الكلام. وذلك يتحقق، في ظني، عندما يعامل الكاتب نصه بجدية لا استخفاف. ليست الجدة أبدًا عدوة للبساطة، على العكس هي قوامها الأساس، وإنما الاستعراض عدو الكتابة الرئيس، سواءً كان للمعرفة أو القدرات الأسلوبية.
وأدعي أيضًا أن كل كتابة أصيلة هي كتابة سؤال لا إجابة؛ سؤال تعيد من خلاله اختبار ما تعرف. عندما يتحدث فالتر بنيامين عن الحكواتي، فإنه يفسر تأثيره في المتلقي بقوله "إن الذكاء الذي جاء من بعيد، سواء من بلاد أجنبية بعيدة في المكان أو من تراث بعيد في الزمان، امتلك سلطة أعطته مصداقية، حتى لو لم يخضع للاختبار".
ويقول المثل المصري الدارج "الشيخ البعيد سره باتع". وأنا مع الأخير؛ إن ما بين بنيامين والمصري المجهول الذي ابتدع مثلًا عابرًا للزمن، هو الرحلة التي خاضها السؤال في سبيل اختبار ما جرب حتى استخلص معرفته الخاصة.
وحتى تكون هناك حكاية لا بد من دافع لسردها؛ اللبناني رشيد الضعيف له رواية ملهمة، اسمها أوكي مع السلامة، بداية من عنوانها هناك لدى الراوي سبب ليحكي للمتلقي شيئًا: ما الذي أدى إلى تلك الجملة المختصرة مفتوحة الاحتمالات؟ أوكي مع السلامة ثم إغلاق الخط؟ حسنًا سيقص عليك "الضعيف" ذلك. هذا هو الدافع السردي.
النص الحالي كتبته في نسخته الأولى من دون دافع سردي. كانت جملة "كل شيء حكاية؛ منذ بدأ الإنسان..." بدايته، وتوطئة لحديث عمومي منقطع الصلة بأغراضه عن الكتابة والقصص الصحفية وأسباب الخبر، قبل أن يختتم نصائحه "البناءة" بأمثولة عن ضرورة تخلي الكاتب عن "أناه" أثناء الكتابة. ولم يكن ثمة إشارة إلى ذلك الصديق الذي جاء يزورني في معطف لوجين.
مم كنت أخاف؟ ربما من الظهور في صورة أشد صلفًا من لوجين نفسه! أو أنني أخشى أن يبدو نصي نقيضًا للمبادئ التي يجب أن يسير وفقها المحرر والعمل الصحفي. لكن "يالهؤلاء المتعبين"، يقول رازوميخين في رواية دوستويفسكي "إنك جالس على المبادئ كجلوسك على خازوق، فلست تجرؤ أن تقوم بحركة واحدة على ما يشاء لك هواك. أما أنا ففي رأيي أن الإنسان الطيب الخير هو في ذاته مبدأ من المبادئ".
ربما قابلت لوجين، أو قابلت نفسي؛ هل للإشارة إلى نص رشيد الضعيف، تحديدًا، رغبة أخرى غير الإعلان عن قدرة ما على الفهم والتأويل؟ لذلك يجب ألا ألوم صديقي ذاك. ربما كتبت ذلك النص في صوره كلها رغبة في اتقاء الإصابة بالحمى، أو ربما كتبته لغرض آخر من أغراض "الأنا". لكن ما أعرفه حقيقة أنني كتبته بعيدًا، بعيدًا جدًا، عن الجلوس على كرسي "المبادئ".
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.