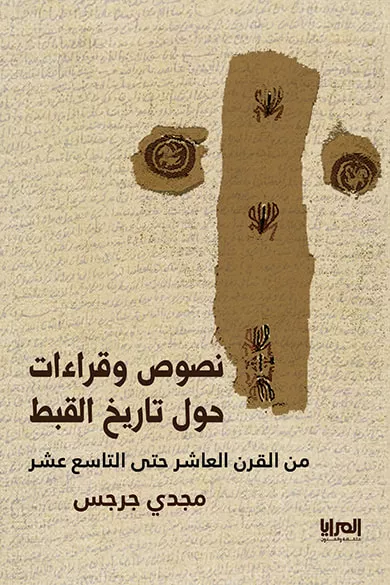قراءة في "تاريخ القبط".. الوثيقة تواجه الأهواء
يقع كتاب "نصوص وقراءات حول تاريخ القبط.. من القرن العاشر حتى التاسع عشر" للمؤرخ مجدي جرجس، الصادر مؤخرًا عن دار المرايا، في قلب الجدالات الدائرة حول الهويات المتخيلة لمصر والمصريين، ووهم الأصول التاريخية الممتدة بدون انقطاع أو غياب التضافر مع ثقافات مختلفة صاغت كلها مصر المتراكمة طبقات فوق طبقات كما نعرفها، وإن لم يكن ذلك بالتحديد مقصده المباشر أو الهم الأساسي لكاتبه.
لكنَّ المحتوى بالغ الأهمية بما يتضمنه من وثائق تاريخية، يجيب أسئلة كثيرة، أبسطها هل اللغة التي نتحدث بها الآن هي نفسها اللغة القبطية ومن ثَمَّ اللغة المصرية القديمة؟ وهل اللغة العربية فُرضت حقًا بالقوة حد قطع ألسنة من يتحدثون بغيرها كما يردد البعض؟ وهل مؤسسة الكنيسة القبطية المصرية كانت طوال تاريخها كما هي الآن بذات القوة والهيراركية؟ وهل النص.. أي نص، رسمي أو مؤسس أو مقدس بطبيعة الحال، يظل حاكمًا وله نفس السطوة التي اكتسبها في زمن ما، في أزمان تالية؟
لا يجيب الدكتور مجدي جرجس عن هذه الأسئلة مباشرة، ولا يطرحها مباشرة كذلك، ولكن ومن خلال عدد من النصوص الوثائقية والتراثية؛ المخطوطات التي تتعلق بقضايا الطائفة القبطية من القرن العاشر وحتى التاسع عشر، يضعها في تسعة فصول لتمثل سردًا تاريخيًا شبه متصل، يرسم للقارئ صورة شبه كاملة لحياة ومجتمع الأقباط ومن ثم المجتمع المصري في علاقته بالوافد الجديد: العرب والدين الذي حملوه معهم.
علاقات مرتبكة
على سبيل المثال، يرصد الكتاب في فصله الخامس ومن خلال نصوص الشكاوى التي رفعها أعيان القبط ضد البطريرك القبطي البابا غبريال الثامن (1587-1603) عندما قرر تطبيق التقويم الغربي الجريجوري في الكنيسة القبطية المصرية، اختيار أعيان القبط المحكمة الشرعية (الإسلامية) لتقديم شكاواهم. ومن فصول الكتاب نكتشف أن علاقة الأراخنة الأقباط (أعيان المجتمع القبطي من كبار الملاك والأثرياء والإنتلجنسيا العلمانية) برأس الكنيسة كانت شديدة التعقيد، بلغت حد أن سعوا أكثر من مرة إلى عزل البابا وأحيانًا اغتياله. وهي علاقة بدأ ارتباكها مع دخول العرب لمصر، واختيار عاصمة جديدة للبلاد هي الفسطاط، وبحثهم عمن يمثل الطائفة أمامهم.
لكن قبل هذه المحطة هناك محطة أهم؛ مرحلة المحلية في مواجهة الخطابات المسيحية العالمية والإقليمية، التي بدأت بعد عام 451 أي قبل ما يقرب من 200 سنة على الدخول العربي. ويشير جرجس إلى أنه مع اعتراف الدولة الرومانية بالمسيحية في أوائل القرن الرابع الميلادي، أصبحت الكنيسة المصرية واحدة من أربعة مراكز مسيحية كبرى أو كراسي أسقفية في العالم، هذه المراكز هي روما في أوروبا والقدس وأنطاكية والإسكندرية في الشرق الأوسط، ومثَّل مصر بالطبع كرسي الإسكندرية، وعلى ذلك لعبت الكنيسة القبطية أدوارًا مهمة في إدارة دفة العالم المسيحي.
وبلغ اهتمام ومراقبة العالم المسيحي للكنيسة المصرية مداه، حتى أن النزاعات الداخلية بمصر كانت تتحول إلى شأن مسكوني يشغل العالم بأسره. فما أن اندلع جدال لاهوتي في مصر، في الربع الأول من القرن الرابع بين القس السكندري آريوس والبطريرك القبطي الكسندروس (312-328م)، حتى صار ذلك الخلاف حديث العالم المسيحي، وتدخل الإمبراطور الروماني بنفسه ليجد مخرجًا لتلك الأزمة المصرية التي سرعان ما صارت عالمية.
ودعا قادة الكنائس لعقد مجمع مسكوني بمدينة نيقية عام 325 لحسم ذلك النزاع. وأخذ العالم المسيحي يشاهد بإعجاب هذا النزال بين عضوين من الكنيسة المصرية، وبرز اسم القديس أثناسيوس، بطل هذا المجمع، وصار اسمه علمًا على المسيحية بأسرها.
يعطينا ذلك فكرة عامة على وضع الكنيسة القبطية ضمن العالم المسيحي العالمي ومحيطها الإقليمي ومركزيه في القدس وأنطاكية، ولذلك وضمن تأكيد عالميتها، دونت أدبيات الكنيسة حينها باللغة اليونانية، مثل سيرة القديس أنطونيوس مؤسس الرهبنة، التي كتبها البطريرك البابا أثناسيوس.
غير أن المعارك العقدية التي شهدها العالم المسيح، التي دعت إلى تنظيم مجمع خلقيدونية الشهير والحاسم في تمايزات العقيدة المسيحية، كان من أعماله نبذ تعاليم وعقيدة الكنيسة القبطية، واعتبارها خارجة عن الإيمان المسيحي القويم، لكن البابا ديسقورس (444-454) ممثل الكنيسة المصرية تمسك بموقفه العقدي، وخلفه جموع القبط المصريين، وكان من أثر ذلك أن تعرضوا لاضطهاد عنيف من الدولة الرومانية وكنيستها الرسمية لإجبارهم قسرًا على الالتزام بما اتفقت عليه جموع المسيحيين والكراسي الأخرى. وكانت النتيجة أن أخرجت في النهاية الكنيسة القبطية من متن العالم المسيحي إلى هامشه، ومن ثم طورت الكنيسة القبطية من خطاباتها وطرق إنتاجها وتوجيهها.
كانت هذه لحظة تحول جذرية، تمثلت في تأكيد الكنيسة القبطية ومن خلفها جموع المسيحيين المصريين هوية خاصة ومختلفة، بعيدًا عن الدولة الرومانية الحاكمة ومذهبها، وعادت الكنيسة القبطية إلى تراثها القومي ممثلًا في التراث الفرعوني ليكون رافعة ثقافية لخطابها المحلي الخاص.
وبينما استمرت اللغة اليونانية لغة رسمية لرجال الحكم وللمخاطبات الرسمية، اعتمدت الكنيسة على وضع ما يشبه القواعد للغة قبطية لشعبها.
العهدة العمرية
يشير الكتاب، ومنذ فصله الأول، إلى أن هناك تغيرًا جذريًا حدث في الأدبيات القبطية بعد صدور قرار بتغيير اللغة الرسمية في الدواوين إلى العربية عام 705 ميلادية، وبذلك باتت العربية هي اللغة الرسمية، فأخذ الأقباط يهملون بالتدريج دراسة اللغتين اليونانية والقبطية، ويقبلون على اللغة الجديدة ويدرسون آدابها.
والمقصود بالأدبيات هنا، كل ما يخص القبط المصريين من نصوص، سواء كانت قانونية أو تنظيمية أو كنسية، وهو يختلف بالتعريف عن الأدب القبطي، الذي تضم تعريفاته طيفًا واسعًا من النصوص، وقد تجاوز ذلك القرار في تأثيره (التعريب) تأثير دخول العرب مصر، ومن ثم انضمام مصر إلى الحكم العربي الإسلامي عام 641، فبين التاريخين 641 و705، كان الوضع في مصر مختلفًا، فقد دخلت في حوزة جديدة عزلتها كليًا عن العالم البيزنطي.
وما من شك أن العقود الأولى للعصر العربي الإسلامي حفَّزت الكنيسة على تأكيد هويتها، وظهرت كتابات جديدة باللغة القبطية تعبر عن ذلك. على أن الآثار البعيدة لدخول مصر تحت الحكم العربي كانت بالغة التعقيد والعمق، حيث تغيرت كليًا بنية الطائفة وعلاقتها بالدولة، والأهم من ذلك هو التغيرات الاقتصادية، التي تسببت في تبدل مواقع الفاعلين داخل الطائفة القبطية.
لقد تعامل العرب فور استتباب الأمر لهم باعتبار المسيحيين المصريين أهل ذمة، مستندين في ذلك إلى ما يعرف بالـ"العهدة العمرية"، فكان أن دفع المسيحيون الجزية، لكن لم يقترب العرب في العموم من كياناتهم الدينية أو تنظيماتهم الداخلية، وكان رد الفعل الطبيعي أن استمسك القبط بكنيستهم، ومن ثَمَّ سعى البطريرك وكبار الأعيان من القبط إلى تمثيل المسيحيين أمام الحكام الجدد، وتسبب ذلك بالطبع في صراع داخلي على سلطان المسيحيين، خصوصًا أن عمرو بن العاص أبقى على ممتلكات الكنائس والأديرة، ولم تتعرض ثروات أعيان القبط للمصادرة.
لكن ذلك الأمر لم يستمر طويلًا بالطبع، فكثيرًا ما تعرضت ممتلكات الكنائس والأديرة للسلب والمصادرة، وانحصرت إلى حد بعيد المصادر المالية للمؤسسات الدينية القبطية فيما يقدمه القبط على سبيل النذر والصدقة.
ليس هذا كل ما في الأمر، بل إن هذه الصدقات الجارية (الوقف) خضعت لتقنينات فقهية وضعت ضوابط على المستفيد منها، ومصارفها الشرعية، حيث إن جميع المذاهب الفقهية قيدت الوقف على الكنائس، وأباحت فقط وقف الذمي (غير المسلم) على الفقراء والمساكين وجهات البر العامة كاستضافة الغرباء وتسييل الماء.. إلخ. تقلص موارد الكنيسة وتحولها من مؤسسة عير قادرة على دفع مرتبات رجالها، زاد من تردي وضع البطاركة وفقدان نفوذهم.
قبل ذلك، ومع الشهور الأولى لدخول العرب مصر، واختيار الفسطاط عاصمة جديدة للبلاد بدلًا من الإسكندرية، تأثر وضع البطريرك القبطي داخل مصر، إذ استمر البطريرك في الإسكندرية، بينما تدار أمور الطائفة من الداخل/ من العاصمة الجديدة/ من القاهرة، ومن ثم تضخم دور أسقف مصر على حساب دور البطريرك، وأصبحت صناعة القرار على مستوى الطائفة تتم فعليًا من القاهرة، من خلال الأعيان وبمساعدة أسقف مصر، بينما البطريرك بعيدًا في الإسكندرية لا حول له ولا قوة.
هكذا، ليس في كتاب مجدي جرجس تصور أو سردية تدعم الأهواء المسيحية أو الإسلامية حول مصر في تلك القرون العشرة، ولكن مجموعة من الوثائق، تكفي قراءتها ليعرف القارئ حقيقة الصورة وطبيعتها، فلا شيء أصدق من الوثيقة مهما كانت قوة الأحلام والأوهام التاريخية.