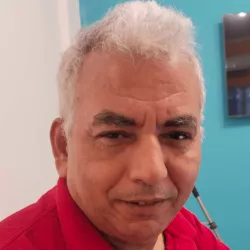هل أتاك صوت "الفئويين"؟
12 ألف احتجاج تثير الضجيج في سنوات الصمت
تبدو السنوات الخمس الماضية أكثر فترات الحياة السياسية في مصر جمودًا مع غياب مختلف أشكال العمل العام. ولكنَّ المفارقة أن خلف هذا الجدار من الصمت المطبق، يوجد ما يقرب من 12 ألف احتجاج منذ بداية عام 2017 وحتى منتصف عام 2021، بحسب منصة العدالة الاجتماعية.
ربما كانت آخر مظاهر الحراك السياسي الذي امتد منذ مطلع الالفية هي المظاهرات المعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عام 2016، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
مستوى القمع الذي واجهته الحركة المناهضة للتنازل عن الجزيرتين، أعقبه تراجع عام في الحياة السياسية، بحيث لم يتبقَّ من مظاهرها تقريبًا سوى متابعة النشطاء الحقوقيون للسجناء السياسيين. فيما لم تشهد الأحداث والقرارات السياسية والاقتصادية المهمة، ردود الأفعال المعتادة من المعارضة في مصر.
ولكن نظرة أكثر اتساعًا على المجتمع المصري، تكشف أن سنوات الصمت التي أعقبت 2016، لم تكن صامتة تمامًا، فبينما أصيب الحراك السياسي بالشلل الكامل، تحت ضغط الحصار الأمني، كان هناك حراك آخر لا يتوقف.
لا توجد الكثير من المصادر التي ترصد الحركة العمالية والاجتماعية في مصر، كما أن الطابع اللا مركزي لتلك الحركات، والتجاهل الإعلامي للاحتجاجات عمومًا يجعل رصدها أصعب. وفي هذا السياق يمكن اعتبار أن منصة العدالة الاجتماعية تقدم الصورة الأقرب للواقع حول الاحتجاجات، صورة تكشف مستوىً من الاحتجاجات يبدو مفاجئًا في ظل الجمود السياسي الممتد لسنوات.
بلغ عدد الاحتجاجات التي أمكن حصرها عام 2017 1518 احتجاجًا. هذا المستوى قد يمثل تراجعًا عن مستوى العام السابق 2016، الذي سجل 1878 احتجاجًا، ولكنه يظل مرتفعًا بالقياس لحالة الانغلاق في المجال العام التي شهدتها مصر في تلك المرحلة.
لم تمر دون مقاومة
الأهم أن تلك الاحتجاجات تكشف على نحو صريح أن "الإصلاحات الاقتصادية" التي نفذتها الحكومة في تلك الفترة، لم تمر دون مقاومة.
"الإصلاحات" التي تضمنت تحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الوقود والكهرباء، وأدت لموجة تضخم استثنائية، كانت تواجَه باحتجاجات من قطاعات متضررة، حتى وإن لم تكن الشعارات والمطالب التي رفعتها في مواجهة تلك السياسات مباشرة، لكنها وجهت على نحو مباشر ضد آثارها.
وبحسب التقرير، ارتبطت الاحتجاجات بالمطالبة بالحق في الصحة والسكن والاعتراض على غلاء الأسعار، كما انصبت المطالب العمالية على الأجور والإجازات والحق في التنظيم.
تجدر هنا الإشارة إلى أن ما تضمنته تقارير منصة العدالة الاجتماعية، هو ما أمكن رصده بالفعل، في ظل صعوبة الوصول إلى المعلومات وغياب قاعدة بيانات محكمة وضعف التغطيات الإعلامية ومنعها أحيانًا، وهذا بحسب ما أوردته تقارير المنصة ذاتها، وهو ما يعني أن الاحتجاجات التي شهدتها مصر في الأغلب أكثر مما أمكن رصده.
الملاحظ أنه على الرغم من التراجع النسبي للاحتجاجات الاجتماعية في 2016 بالقياس للأعوام السابقة، وهو التراجع الذي شمل كافة أشكال العمل العام في مصر وقتها، فإن السنوات التالية، التي شهدت استمرار إغلاق المجال العام، كانت الحركة الاجتماعية تتصاعد فيها.
كانت الحركة الاجتماعية في تلك السنوات، هي المقاومة الوحيدة على الأرض للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها السلطة
فالتقارير المتتالية لمنصة العدالة الاجتماعية ترصد أن عام 2018 شهد ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية إلى 2502 احتجاجًا، مثلما ارتفعت ثانيةً في 2019 إلى 2792 احتجاج، أما في عام 2020 الذي شهد جائحة كورونا فبلغت الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية 3832 احتجاجًا، وتتوقف التقارير عند النصف الأول من عام 2021، الذي شهد 1177 احتجاجًا.
الحركة الاجتماعية التي تصاعدت وتيرتها في أجواء غير مواتية منذ 2017، دارت جميعها حول الغلاء ونقص الخدمات والمرافق وتدني الأوضاع المعيشية. كانت الحركة الاجتماعية في تلك السنوات المقاومة الوحيدة على الأرض للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها السلطة، وألقت بأعباء الأزمة الاقتصادية على الطبقات الفقيرة.
الاحتجاجات التي خاضتها قطاعات مختلفة من المجتمع في تلك السنوات لم تكن دون تكلفة، فمثلما تربَّصت الأجهزة الأمنية بكل تحرك سياسي، لم تكن أكثر مرونة تجاه الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية خاصة.
ما خاضه العمال واجهته السلطة بالقمع نفسه الذي واجهت به الاحتجاجات السياسية. وفي هذا الصدد، ترصد دار الخدمات العمالية والنقابية في تقاريرها عن انتهاكات حقوق العمال، خاصة تقرير عام 2018 (سنة استنساخ القديم)، وتقرير عام 2019 (عام الاستنزاف) وتقرير عام 2021 (الحركة العمالية بين الترقب والحذر)، عشرات الأمثلة على القبض على العمال المضربين والفصل التعسفي والاحتجاز في أماكن غير معلومة والتقديم للمحاكمات والنقل من أماكن العمل.
شمل ذلك مختلف المواقع العمالية التي شهدت اضطرابات، بحيث أصبح الاحتجاج العمالي للمطالبة بتحسين الأجور أو التثبيت في العمل، أو حتى تطبيق القوانين واللوائح أمرًا في غاية الخطورة، ومع ذلك حافظت الحركة الاجتماعية على منحناها الصاعد منذ عام 2017، وهو ما تشير إليه أيضًا تقًارير منصة العدالة الاجتماعية.
لا تكمن جسارة الحركة الاجتماعية والعمالية والاقتصادية في صمودها أمام آليات القمع المختلفة فقط، ولكن الأهم أنها تمكنت من الحفاظ على تصاعدها رغم غياب أي حراك سياسي، أو أي ظهير تضامني مع الحركة، ووسط صمت إعلامي شبه كامل تجاهها، حتى أن الكثير من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية لم تتناولها سوى المواقع الصحفية المحجوبة.
على الرغم من هذا الرقم الضخم للاحتجاجات الاجتماعية، ومع الصعوبات التي واجهتها والتكلفة التي تحملتها، لم تحظ الحركة الاجتماعية بما يتناسب مع حجمها من الاهتمام في الحياة السياسية والمجال العام المصري.
"مطالب فئوية"
ولكن اللافت أن قطاعًا واسعًا من النخب السياسية المصرية لا تعتبر الحركة الاجتماعية جزءًا من حراك المجال العام في مصر، فبالنسبة لقطاعات مختلفة من النخب السياسية، تنتمي تلك الاحتجاجات إلى ما اصطلح عليه "الاحتجاجات الفئوية".
ظهر المصطلح في أعقاب الإطاحة بمبارك في فبراير/ شباط 2011 لوصف الإضرابات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية التي انتشرت على نطاق واسع قبل ثورة يناير، وامتدت بعدها. ولم تحظ تلك الاحتجاجات بتأييد القوى السياسية بشكل عام، بل وضعتها بعض القوى في مواجهة مسار الإصلاح السياسي واتهمتها بتعطيله.
وبعد فشل مسار الإصلاح السياسي وتراجع المسار بأكمله، لم يبقَ سوى حراك "الفئويين" الذي لا زالت النخب السياسية، أو أغلبها، لا ترى فيه سوى مطالب محدودة لفئات معينة، حتى وإن نظمت تلك الفئات 12 ألف احتجاج في سنوات يخشى فيها الجميع من الحديث.
لا يجب في هذا السياق تجاهل مشكلات الحركة الاجتماعية، التي تجعل تأثيرها أقل كثيرًا من حجمها الفعلي، مع افتقادها بكل تأكيد للتنظيم، فهي حركة تنهض في مواجهة إجراءات أو مواقف أو لمطالب محددة، ويرتبط صعودها وهبوطها بالعوامل التي تحركها، ولا تخلق امتداد تنظيمي يراكم خبراتها وآليات عملها، كما أنها لا تسعى عادة للربط المباشر بين مطالبها المباشرة والسياسات العامة للدولة.
ترجع مشكلات الحركة الاجتماعية في أحد جوانبها لطبيعتها العفوية، وفي جانب آخر للسياسات الأمنية التي تمنع وتحظر التنظيمات، مثلما حدث مؤخرا في الانتخابات النقابية التي سيطر عليها الأمن.
ولكن تلك المشكلات لا تقلل أبدًا من قيمة الحركة الاجتماعية ودورها، ففي السنوات الماضية كانت بالفعل المقاومة الوحيدة على الأرض للسياسات الاقتصادية للحكومة. وربما تكون قضية شركة الحديد والصلب مثالًا جيدًا على ذلك، فقرار التصفية نال معارضة واسعة من مختلف القوى السياسية، ولكن الاحتجاج على الأرض قام به عمال الحديد والصلب أنفسهم بالاعتصام في الشركة في يناير/ كانون الأول 2021، واستمروا في اعتصامهم هذا لأسابيع، رغم الحصار الأمني لهم والتهديدات والقبض على عدد منهم.
كذلك قرارات الإصلاح الاقتصادي في 2016، التي شملت تحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود وخفض الدعم على الكهرباء والغاز والمياه، تمهيدًا لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي الإجراءات التي كانت محل رفض بدورها من القوى السياسية المعارضة، أو أغلبها. ومع ذلك، لم تجد ردود أفعال سياسية تتناسب مع حجم تلك الإجراءات وآثارها.
أما على أرض الواقع، كانت الحركة الاجتماعية تعبِّر عن رفضها بمظاهرات الخبز في 2018 والاحتجاج على رفع أسعار تذاكر المترو والإضرابات والاعتصامات التي طالبت بتحسين مستويات المعيشة ورفع الأجور، واحتجاجات العمال ضد لوائح قطاع الأعمال.
سنوات الصمت لم تكن صامتة، صوت الحركة الاجتماعية (الفئوية) لم ينقطع في أي وقت، ورغم كل محاولة لقمعه أو لتجاهله ظل يتردد وفقًا لقانونه الخاص.
بالطبع حالت أوضاع الجمود السياسي والحصار الأمني دون تطور تلك الحركة مطلبيًا وتنظيميًا، ولم تتمكن القوى السياسية المعارضة في ظل القيود المحكمة من القيام بدورها السياسي والتضامني تجاه الحركة الاجتماعية، ولكن قدرة الاحتجاجات الاجتماعية على الاستمرار والتصاعد رغم كل العوامل غير المواتية تؤكد أن سياسات الإصلاح الاقتصادي لا تمر دون مقاومة، والأهم أن أي أفق لاستعادة الحياة السياسية والمجال العام، يجب أن تبدأ من عند هؤلاء (الفئويين).