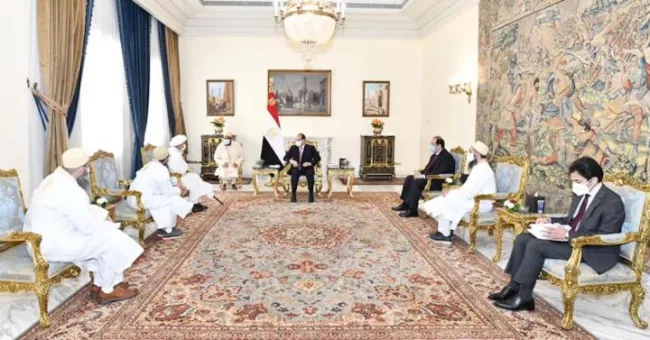أصحاب ولا أعز: مجتمع يرفض الحديث عمّا يعرفه
مجموعة من اﻷصدقاء من الرجال والنساء، أو للدقة أربعة أصدقاء من الرجال، هم من نسميهم عادة "أصحاب عمر"، سنعرف من خلال الحوار أن عمر صداقتهم يتجاوز العشرين عامًا، تجمعهم تركيبة تقليدية تمامًا، يتعلق مبرر وجود النساء فيها بأنهن نساء رجالها، أو للدقة نساء ثلاثة منهم، أو بعضهن، زوجاتهم تحديدًا، أي تلك النساء اللاتي اكتسبن حق الوجود برضا المجتمع عن طبيعة علاقتهن برجال لهم حق وجود أصيل ليسوا في حاجة إلى اكتسابه.
وكما سنعرف من الأحداث التالية للفيلم ليست النساء الثلاث هن كل نساء هؤلاء الرجال، أو مرة ثالثة للدقة، لسن كل نساء اثنين منهم، فثالث اﻷزواج ليست له علاقات خارج إطار زواجه، أما رابع الرجال، فلا نساء له، ولم تكن له نساء في أي وقت سابق، ﻷنه مثلي. سبع شخصيات هم أبطال فيلم أصحاب.. ولا أعز، وهم تقريبا كل من نراه طوال الفيلم الذي تدور كل أحداثه تقريبا في بيت المضيف وزوجته، وبالتحديد في غرفة الطعام حيث يجلس الأصدقاء إلى المائدة يتناولون العشاء ويتجاذبون أطراف الحديث، وهو في الحقيقة البطل الحقيقي للفيلم، فأحداث الفيلم، التي سنكتشف لاحقا أن أغلبها لم يحدث أصلا، تتكشف من خلال الحوار وتخدمه وليس العكس.
ما يحدث تاليًا هو ما سيتوقعه مشاهدو الفيلم منذ البداية، فللجميع أسرارهم بالطبع، وبعضها شائن في أعين زوجاتهم أو أزواجهن أو في أعين أصدقائهم، وساعات قليلة من إتاحة محتوى تواصل أي منهم مع آخرين خارج الغرفة كفيل إما بفضح هذه اﻷسرار مباشرة أو توجيه انتباه من يعنيهم اﻷمر ﻷن يتتبعوا الخيوط المتاحة لكشفها، وهكذا تتوالى الرسائل والمكالمات الفاضحة للأسرار ومعظمها خيانات زوجية إضافة إلى كشف أحد الأصدقاء لمثليته، إلى جانب مكالمة بين المضيف وابنته تستشيره فيها أن تقضي الليلة مع صاحبها مما يعني أن يمارسا الجنس لأول مرة.
تريلر فيلم أصحاب ولا أعز
يقلب كشف الأسرار حياة جميع الحاضرين رأسًا على عقب خلال ساعات قليلة، تنتهي زيجتان وتتقطع أواصر الصداقة بين اثنين على الأقل من الأصدقاء الأربعة، ويصبح من الواضح أن هذه المجموعة من الشخصيات لن تعود إلى الاجتماع على مائدة عشاء كهذه مرة أخرى، لا شيء يبقى على حاله بعد انكشاف الأسرار، فهي لا تطلع الآخرين فقط على حقائق صادمة يعرفون بها لأول مرة، بل إنها تجعلهم يكتشفون بشكل مفاجئ أنهم أمام أغراب عنهم لا يعرفونهم، ولن يكون بإمكانهم يومًا الثقة في أنهم يعرفونهم حقًا، وما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا يحدث في أضيق دوائر العلاقات الإنسانية وأكثرها حميمية، تلك التي يظن أفرادها بحق أنهم قادرون على التعري دون خجل، أو على الأقل قادرون على أن يكونوا أنفسهم حقًا، على خلاف حالهم في دوائر معارفهم ومن يتعاملون معهم في إطار العمل والجيرة وغيرها، وفي النطاق الأوسع للمجتمع ككل.
بطريقة ما، حياة كل من هؤلاء، وهي لا تختلف كثيرًا في هذا عن حياة أي منا، هي أضيق من هاتفه المحمول، المساحة الوحيدة التي قد يكون فيها نفسه مع نفسه، وفقط إن اطمأن إلى أنه الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى محتوياته، وأنه قادر على إخفائها عن الجميع.
ليس في أي مما سبق ما يثير الدهشة، نحن جميعًا أسرى أسرارنا، ولا أحد منا بخير، ففي سعينا إلى السعادة أو ما يشبهها لا يجد أغلبنا بديلًا عن سلك مسارات لا يمكنه أن يطرقها تحت أعين الجميع، وإلا فقد اعتباره بينهم بصورة أو بأخرى، وهذا يعني أننا، على الجانب الآخر، أسرى صورتنا العلنية، التي تنصاع لشروط دوائرنا الاجتماعية، حتى يكون بإمكاننا العيش فيها، وبما أن أحدًا لا يمكنه حقًا العيش إلا في إطار دائرة اجتماعية واحدة على الأقل، فحياتنا دائمًا مرهونة بتقديم صورة علنية مقبولة، على الأقل، لدى جماعة واحدة من البشر، وعلى أرض الواقع، تكون مرهونة بتقديم عدة صور علنية، كل منها مقبول لدى دائرة من دوائر علاقاتنا دون الأخرى.
فمتى نكون أنفسنا حقًا؟ أين نكشف صورتنا المطابقة تمامًا لما نحن عليه؟ وهل يحررنا انكشاف أسرارنا منها؟ أم أنه فقط يجعلنا أسرى عواقب كشفها، ومن ثم توصم شخصياتنا بها إلى الأبد؟ وفي المحصلة، هل نحن أفضل حالًا بينما نحتفظ بحيواتنا السرية بعيدًا عن العيون، أم عندما تنفضح هذه الحيوات، فيبدو أنه لم يعد لدينا ما نخفيه؟ هذا في اعتقادي السؤال الحقيقي الذي يطرحه الفيلم على مشاهديه، والتحدي الحقيقي الذي يضعهم في مواجهته، وهو لا يتعلق بأي حال بأية مواصفات تفصيلية خاصة بشخصياته، أو بالمكان الافتراضي الذي تدور فيه أحداثه، وهو بالتالي ما يجعل حبكته البسيطة عالمية وصالحة لأن تطرح بأي لغة، في أي مكان بالعالم.
في نهاية المطاف تتعلق الأسئلة والتحديات التي يطرحها الفيلم بتناقض يستحيل أن تخلو منه حياة أي إنسان يعيش في إطار أي جماعة بشرية، فلو افترضنا أن أحدًا ما لا يعيش أسرار عقله في واقع مواز يبقيه خفيًا عن الآخرين، فهذه الأسرار في حد ذاتها تنشئ الواقع الموازي داخل عقله، ويظل عليه إخفائه، لأن انكشافه سيجعل الآخرين يرونه في صورة مختلفة عن تلك التي يحرص على تقديمها لهم حفاظًا على قبوله بينهم.
انكشاف الأسرار ليس موضوعًا جديدًا على السينما، في الحقيقة هو أحد موضوعاتها الأكثر تكرارًا أيا كانت الحبكة الأساسية لأي عمل، انكشاف الحياة السرية للشخصيات سواء كانت حاضرة في مسار مواز لحيواتهم العلنية، أو كانت تنتمي إلى ماض لا يعرف به من حولهم، حدث متكرر في الأعمال الدرامية، منذ النماذج الأولى للتراجيديا الإغريقية.
لكن ما يختلف فيه سيناريو فيلم أصحاب ولا أعز في جميع نسخه (الفيلم مأخوذ عن أصل إيطالي بعنوان Perfetti Sconosciuti)، في تناوله لتلك الثيمة الشائعة هو أنه لا يقدمها بهدف تقديم تسوية لها. التسوية، أي حل التناقض الناشئ عن إخفاء الأسرار بكشفها، وعادة بشكل إيجابي، هي النتيجة المعتادة في أعمال الدراما، التي تنطوي على الحكمة التقليدية التي تقول إن الحياة في النور، الحياة النزيهة، دائمًا أفضل، أكثر تحققًا ومن ثم أكثر قابلية لأن تمنح المرء فرصة أن يكون سعيدًا.
غير أن هذا الفيلم لا يقدم تسوية من أي نوع، هو فقط يكتفي بطرحه كشف الأسرار كإمكانية لا تتحقق، مجرد افتراض ينتهي بنفي تحوله إلى واقع، ففي نهاية الفيلم ندرك أن شخصياته تختار عدم لعب اللعبة وتجنب التحدي، ومن ثم تستمر حيواتهم في ذات مساراتها التي كانت عليها في المشاهد الأولى للفيلم، لقد بقي كل شيء على حاله، أم لا؟ يترك لنا الفيلم هذا السؤال إلى جانب ما يواجهنا به من أسئلة وتحديات، ولا يقدم لنا حتى مفتاحًا لإجابة أي منها، وربما تكون رسالته المبطنة هي أنه ليس ثمة إجابة، فما يفرض على أي منا هذه الأسئلة هو على وجه التحديد واقع العيش في جماعة، أي طبيعة أن نكون بشرًا على أية حال، فنحن بشر فقط طالما عشنا في جماعة بشرية، وهذا العيش هو ما ينشئ الحدود الفاصلة بين الحيوات السرية داخل عقولنا من جانب، والحيوات العلنية تحت أعين الجماعة البشرية التي نعيش فيها من جانب آخر. وإذا مددنا ذلك الخط على استقامته فربما يقول لنا هذا الفيلم إن الوجود البشري محكوم عليه بتعاسة لا مجال لتجنبها، وهي محصلة فرويدية بامتياز.
من المثير للاهتمام أن تلقي الجمهور العربي والمصري بصفة خاصة للفيلم، ربما من حيث لا يدري أحد، يؤطر محصلته التي ذكرتها؛ يؤكدها ويبرزها، فبينما يفتح الفيلم نافذة افتراضية على حيوات عدد محدود من الأشخاص يمثلون دائرة شديدة الحميمية، على الأقل في الظاهر، وهي تعكس نمط حياة لا تعيشه إلا أقلية صغيرة عدديًا في مجتمعاتنا العربية، فكأنما يفوت بشكل متعمد ومحسوب على جمهوره العربي تحديدًا فرصة المواجهة الذاتية لأسئلته، أو يفتح لهذا الجمهور سبيل تجنب تلك المواجهة باستخدام التقرير الحاسم "ليس نحن، هؤلاء لا يمثلوننا، بل إنه لا وجود لهم في واقعنا بأي حال".
اقرأ أيضًا|وقائع موت اجتماعي طويل: الإنكار وجذور العنف الديني
لا يكتفي الجمهور العربي في معظمه بحصر المختلف في أقلية لا تشبهه في شيء، ولا يكتفي بإعدامه معنويًا بنفيه خارجه، بل يلجأ عادة إلى محو وجوده كلية بإنكاره، أو بعبارة أخرى، وسأستعير تعبيرًا سوريا تقليديًا قديما "بيحسب الله ما خلقه"، وهي عبارة تفيد حرفيا الإنكار المتعمد لوجود الآخر من الأساس، ولكنها في الحقيقة تكني عن تهديد بالقتل.
ركزت ردود فعل الجمهور، في معظمها، على حالتين تحديدًا، الحالة اﻷولى تقدم فيها إحدى الشخصيات (تؤدي الدور النجمة المصرية منى زكي) على خلع ردائها التحتي، قبل أن تغادر منزلها مع زوجها، في طريقهما إلى حيث يلتقيان بأصدقائهما لتناول العشاء، وبينما نراها تفعل ذلك في المشاهد اﻷولى للفيلم، دون أن نعرف لماذا تفعله على وجه التحديد، نعرف لاحقًا، مع كشف المستور، أنه كان استجابة لتحد هزلي، أو نوع من اللعبة الشهوانية، تمارسها مع شخص دأبت على الدردشة معه، من خلال فيسبوك، دون أن يتعارفا فعليا، فهما لم يلتقيا بعضهما البعض في الواقع، ولم يتحادثا بشكل مباشر، حتى إن أيا منهما لم يسمع صوت اﻵخر من قبل.
هذه الدردشة مع غريب، التي تبدو حميمية، هي أقرب إلى تلمس يائس ومحبَط لظل مشاعر شهوانية مفتقدة، ومفتقد معها شعورها بذاتها كإنسان، كامرأة لها احتياجات ورغبات، محتبسة في علاقة اختفى منها بشكل تام التقارب الجسدي، فيما ينخرط الزوج في سعي ربما لا يقل يأسًا لإشباع حاجاته الشهوانية من خلال علاقة، أو ربما علاقات، خارج إطار زواجهما، وهو في الوقت نفسه يشكو لصديقه إحساسه بأنه يعيش مع رجل، وهي مفارقة مثيرة للاهتمام، خاصة وأنه أثناء محاولة التنصل من صور عارية ترسلها له فتاة على هاتفه، يجد نفسه متورطًا في اتهام بالمثلية، بعد أن استبدل هاتف الصديق الرابع الذي يخفي عن الجميع مثليته بهاتفه.
الصديق المثلي، هو تحديدًا الحالة الثانية التي ركزت عليها معظم ردود الفعل، فرغم تباين مواقف شخصيات الفيلم نفسه منه بعد الكشف عن هويته الجنسية، بمعنى أن الفيلم نفسه لم يقدم بوضوح من خلال شخصياته موقفًا داعمًا أو متعاطفًا مع المثلية، بل طرح الطيف المتوقع لردود الفعل المتراوحة بين الرفض العنيف، حد التهديد بالقتل من جهة، وإظهار قدر من الدعم المتوتر على أفضل تقدير من جهة ثانية. ومع ذلك فالتهمة التي وجهها أغلب المعلقين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كانت "الترويج للمثلية"، وبعيدًا عن سخف التهمة المستحيلة، فليس باﻹمكان أصلا الترويج للمثلية أو نشرها بأي طريقة، فما نلاحظه هنا هو أن مجرد وجود شخصية مثلي بفيلم دون إدانة قاطعة، وكأن هذا الوجود في حد ذاته أمر (طبيعي)، كان كافيًا لتوجيه هذا الاتهام إلى الفيلم.
ما تكشفه ردود فعل الجمهور هو تحديدًا ما سبق أن أشرت إليه، فهي تدين الفيلم ﻷنه يقدم هويتين ينكر المجتمع المصري والعربي وجودهما، المرأة الشهوانية، والرجل ذو التوجه الجنسي المثلي، بفارق ملحوظ تركّز ردود الفعل أيضًا على هوية ثالثة وهي اﻷب المتفهم لنضج ابنته وحيرتها بخصوص الوقت المناسب لها لتمارس الجنس ﻷول مرة.
في المقابل تغض ردود الفعل هذه النظر عن الخيانات الزوجية، بما في ذلك تلك التي ترتكبها زوجة المضيف مع صديقه، فهي خيانات يمارسها رجال، وهم ضمنيًا تحركهم حاجاتهم الشهوانية (الطبيعية والمتوقعة) التي تخفق زوجاتهم في إرضائها، ولا يبدو أن أحدًا يرى أن خيانة الزوجة تشير إلى حاجاتها الشهوانية والحسية غير الملباة، فما يرونه؛ هو رجل خان صديقه وتسلل إلى فراش امرأته، ولكن ليس هذا هو الحال مع امرأة لم تتحدث عن إغراء رجل لها لتخون زوجها معه، وإنما أعلنت بوضوح عن لجوئها إلى ألعاب شهوانية لإرضاء حاجاتها.
لا يهتم مجتمعنا بممارسات وأفعال تتسبب في أذى مباشر ﻵخرين، مثل الخيانة، بقدر ما يهتم كثيرًا بإنكار وجود هويات بشر يحيون بيننا رغم أنها لا تهدد بإيذاء أحد، فحتى خيانة الزوجة من خلال ممارسة ألعابها الشهوانية شبه الطفولية مع رجل غريب، هي رد فعل على تجريد زوجها لها من وجودها ككائن له احتياجات جنسية، لا يرفض مجتمعنا الممارسات على أساس ما تتسبب به من أذى، بل يرفض هويات بمجملها، يحكم بعدم وجودها ويدين أي إشارة إلى خلاف ذلك، وهو يؤكد أنه "يحسب الله ما خلق" هؤلاء، فوجودهم عدم من اﻷساس، ومن ثم فقتلهم ليس فعلًا، قبل أن يكون جريمة، فإعدام العدم هو في ذاته وجود، وهذا المجتمع يمارس وجوده نفسه من خلال إعدام المختلف، وهذا يفسر قدر الهياج الذي يصيبه لمجرد اﻹشارة إلى وجود ما لا يعترف بوجوده، ﻷنه يستشعر في هذا الوجود في حد ذاته تهديدًا وجوديًا له.
المشهد الهستيري في مواجهة عمل فني، والغضب الجهادي المقدس ضد صناعه هو تكرار لمظاهر أزمة مجتمع غير قادر على التحرر من أسراره، وسره اﻷهم هو أن وجوده قائم على القتل دون الحياة، على التصالح مع اﻷذى وحماية الجناة دون المجني عليهم، ففي النهاية هو نفسه الجاني اﻷكبر، وأخيرا إنه مجتمع قائم على النفي دون إثبات ﻷي شيء.