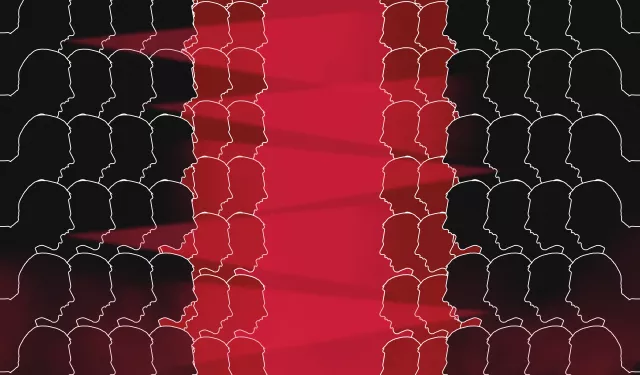
تصنيع الكراهية: كيف تشعل حربًا أهلية في ثلاث خطوات
عند الهولنديين مثل شعبي مطابق للمثل المصري القائل إن "الجار قبل الدار"، لكن ترجمته الحرفية تقول إن الجار أقرب إليك من الصديق. وهم يحرصون على اختيار جيرانهم قبل ديارهم، لأنهم يحرصون على إقامة علاقات طيبة مع الجيران. ومن عاداتهم أن الجارين إذا التقيا توقفا للحديث وتبادل الأخبار، وربما الاتفاق على تناول القهوة معا في أحد أيام الأسبوع.
في إحدى هذه الوقفات أمام البابين، سألتني جارتي إذا ما كنت سعيدًا في هولندا، فقلت لها إن أكثر ما أحبه في هولندا هو انفتاح أهلها على الآخر، وترحيبهم به. وقلت "لا أشعر أبدًا بأن هناك أي نوع من العنصرية في هولندا، كما يحدث معي في فرنسا وألمانيا مثلًا". لكن جارتي فاجأتني بردها "ما زلت لا تعرف هولندا جيدًا يا ياسر، ربما لأنك تعيش وسط مجتمع النخبة، فأصدقاؤك هم من الصحفيين والمتعلمين تعليمًا عاليًا، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10% من الهولنديين".
كان ردها صادمًا، فهي أستاذة جامعية، وباحثة اجتماعية تعمل في أوساط المهاجرين واللاجئين، وتقدم استشارات لجهات حكومية مهمة، ورأيها، لذلك، جدير بالأخذ في الاعتبار. هناك عنصرية، إذن، بشكل ما، وإن تكن غير مرئية، أو غير محسوسة، ولكن ما الذي يمنع أن تراها، أو تحسها؟ الإجابة بسيطة: القانون. فالقانون يجرم أي قول أو فعل عنصري، لكن القانون لا يستطيع تجريم الكراهية.
في بدايات حياتي سكنت في شقة أم أحمد في العجوزة. كانت امرأة عجوزًا تسكن في غرفة مع ابنها، الذي كان في مثل عمري، وتؤجر الغرفتين الباقيتين، وكان من حظي استئجار غرفة تطل على حديقتها الصغيرة المحاطة بأشجار الفيكاس ذات الأوراق العريضة والبراعم المبهجة. أخبرتني أم أحمد، ذات يوم، أن هناك شابا أفريقيًا "غلبان"، تريدني أن أستضيفه في غرفتي لأيام لن تطول، لو لم أمانع في أن أشارك سريري الكبير، فلم أمانع. كان شابًا إثيوبيًا جاء في زيارة عمل، فرحبت به ترحيب الصعيدي بالضيف، وأكرمته إكرام الصعيدي للضيف، وظننت أننا سنصير أصدقاء. وإذ نتشارك ماء النيل، فلا يوجد ما يمنع أن نتشارك الغرفة مؤقتًا. وكان أجمل ما في هذه الغرفة أنها تتيح لي أن أتمشى كل صباح على النيل، صعودًا إلى كوبري أكتوبر، وهبوطًا إلى الكورنيش، حيث يقع مقر عملي في مجلة الإذاعة والتليفزيون: 1117 كورنيش النيل- ماسبيرو.
اصطحبت الفتى معي، ذات صباح، وكنا نتبادل الأحاديث بود، إلى أن بلغنا النيل، فقال لي "لو علمت أن النيل سيأتي إليكم بهذا الشكل، لوضعت فيه السم". لم أفعل شيئًا سوى النظر إليه بإشفاق، والعبور إلى الجهة الأخرى من الطريق. هذه كانت المرة الأولى التي أقابل فيها الكراهية وجها لوجه. وطوال هذه السنوات، كنت أسأل نفسي عن سر هذه الكراهية التي رأيتها في قول "الضيف"، وفي عينيه، إلى أن قابلتني عبارة لابن رشد "الجهل يقود إلى الخوف، والخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف. هذه هي المعادلة". يساعدنا تفكيك هذه المقولة على فهم الكيفية التي تنشأ بها الكراهية، وتفادي النتائج التي قد تقود إليها.
تبدأ دائرة الكراهية من الجهل، الذي يقف وراءه سببان هما نقص التعليم أو انعدامه، ونقص المعلومات أو انعدامها. ولا بد أن وراء السببين ذا مصلحة، هو، في الغالب، صاحب سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية. ولكي تستقر هذه السلطة لصاحبها، أو تتوسع، سيكون عليه استخدام مفتاح الجهل، لقيادة قطيع من غير المتعلمين، أو غير العالمين، إلى العنف، مرورًا بباب الخوف. وغالبًا ما يستخدم صاحب السلطة والمصلحة عاملي نقص التعليم ونقص المعلومات، معًا، في تحقيق هدفه. قل إن فلانًا كافر، وسيتبعك القطيع. لن يسعى أحد إلى التحقق مما تقول، فيكفيك أن تدّعي الحرص على الدين، أو الوطن، أو ما تسميه المصلحة العامة، بدون تعريف أو تحديد. ستحتشد الجموع وراءك، لأن عقلية القطيع تميل إلى المعرفة الشفاهية المتناقلة السهلة، التي لا تحتاج إلى مجهود بحثي أو عقلي. وأنت لا تحتاج إلى مجهود كبير لتحقيق هدفك، إذا ما وجدت البيئة المناسبة، أو إذا استطعت أن توجدها.
وربما لذلك يشترك أغلب طغاة العالم عبر التاريخ في إهمالهم تعليم العامة، وحرصهم على أن يقتصر التعليم على الطبقة العليا، ذات الارتباط النفعي بالسلطة. عندما زرت ليبيا، للمرة الأولى عام 2000، قابلت صحفيًا هولنديًا عجوزا في بهو الفندق، سألني إن كنت أتحدث الإنجليزية، وطلب مني أن أتوسط للترجمة بينه وموظف الاستقبال. أدهشني أن موظف الاستقبال في أحد فندقي النجوم الخمسة الوحيدين في العاصمة طرابلس، لا يتحدث الإنجليزية. وكان علي أن أنتظر إلى عام 2012، عندما زرت بنغازي، بعد الثورة الليبية، لأعرف من أحد أصدقائي هناك أن القذافي ألغى تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس لأنها "لغة الاستعمار". ليس سوى إهمال التعليم بيئة مناسبة لأي طاغية يريد أن يضمن بقاءه ويؤمّن مصالحه ومصالح الطبقة التي يرتكز عليها حكمه.
ولكن الطغاة لا يكتفون بحرمان شعوبهم من التعليم، بل يذهبون إلى حرمانهم من المعلومات، لأن إتاحة المعلومات قد تؤدي إلى التفكير، ولأن الشعوب إذا ما فكرت أبصرت، وإذا ما أبصرت انتبهت إلى حقوقها المهدرة، وإذا ما انتبهت تحركت في اتجاه نيل هذه الحقوق، واستعصى على الحاكم حكمها. ليس من مصلحة الطاغية أن يوفر إعلامًا حرًا لشعبه، بل إن نوعا من الطغاة يذهب أبعد من ذلك، فيستخدم الإعلام لحرف اتجاهات الجماهير وتوجيهها إلى حيث يريد.
في 15 يونيو/ حزيران 2013، قبل أسبوعين من خلعه، دعا الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى مؤتمر حاشد في ستاد القاهرة، سماه "مؤتمر نصرة سوريا". كان الشارع المصري يغلي والمواجهات بين الإخوان ومعارضيهم على أشدها، ولم تكن نصرة سوريا، في ذلك التوقيت، سوى ادعاء لتغطية الهدف الرئيسي من المؤتمر، وهو استعراض قوة للإخوان المسلمين وحلفائهم من جماعات الإسلام السياسي. وبشكل أكثر دقة، كان المؤتمر استعراضًا لقوة الإسلام السياسي السني تحديدًا في مواجهة كل من يخالفه،أو يعارضه أو يحول دون استمراره في حكم مصر.
كان غريبًا أن يستضيف رئيس جمهورية أحد قتلة رئيس الجمهورية نفسها في وقت من الأوقات، وهو عاصم عبد الماجد، الذي شارك في قتل السادات. وكان على منصة رئيس الجمهورية، وفي ضيافته، اثنان لا يقلان تطرفًا هما محمد عبد المقصود ومحمد حسان. وألقى المشاركون كلمات تجاوزت حد الكراهية ضد المعارضين إلى حد التحريض المباشر على العنف. وكان المسلمون الشيعة بين مَن نالهم التحريض على العنف، وسط هتافات آلاف الحاضرين في الاستاد. لم تمض أيام حتى أثمر التحريض المباشر عنفًا مباشرًا. في 23 يونيو هاجم سكان من قرية زاوية أبو مسلم في الجيزة منزلًا جمع عددًا من المصريين المسلمين الشيعة الذين كانوا يحتفلون بليلة النصف من شعبان، وأسفر الهجوم عن قتل وسحل رجل شيعي يدعى حسن شحاتة، وثلاثة من مرافقيه. كانت جريمة قتل على الهواء مباشرة، كما أن التحريض عليها كان على الهواء مباشرة.
قبل ذلك بسنوات، استخدم الإعلام في تحريض القطيع على جريمة مشابهة. في 28 مارس 2009، عرضت قناة دريم 2 حلقة مسجلة من برنامج "الحقيقة" استضافت فيه الدكتورة باسمة موسى الناشطة البهائية وصحفيًا في جريدة الجمهورية، وفي الوقت نفسه عضوًا في مجلس نقابة الصحفيين. وقال الصحفي في الحلقة مشيرًا إلى الدكتورة باسمة بوصفها بهائية "دي واحدة تستحق القتل". في قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة في سوهاج، وبعد عرض الحلقة، هاجم العشرات من سكان القرية بيوت جيرانهم البهائيين الذين يسكنون القرية منذ سنوات، وألقوها بالحجارة، وحاولوا اقتحامها وتكسير أبوابها، لولا استنجاد الضحايا بالشرطة التي اكتفت بتفريق المهاجمين، دون القبض على أحد منهم. لكن الصحفي نفسه، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كتب مقالًا في جريدة الجمهورية يشيد فيه بالهجوم على بيوت البهائيين، ويعتبر المهاجمين "غيورين على دينهم". في اليوم التالي عاود "الغيورون على دينهم" الهجوم على بيوت البهائيين، لكنهم استخدموا كرات النار بدلًا من الحجارة وأحرقوها فيما اكتفت الشرطة بنصح البهائيين بالخروج من القرية.
في المثالين السابقين كان هناك استغلال لنقص التعليم، وإساءة استخدام لمنصات الإعلام بهدف إثارة مخاوف العامة على دينهم، لينتهي الأمر بعنف، بدا لمرتكبيه اختيارًا منطقيًا، ولمدبريه غاية توافق أهدافهم وتحققها، وهو ما حدث في أكتوبر 2011 في مذبحة ماسبيرو التي استخدم فيها التليفزيون الحكومي للتحريض ضد المسيحيين. كان بالإمكان أن يتحول الأمر في زاوية أبو مسلم والشورانية إلى مستوى ماسبيرو أو أسوأ. هكذا بدأت الحرب الأهلية في رواندا بين قبيلتي الهوتو والتوتسي عام 1994، وهي الحرب التي استخدم فيها الإعلام أسوأ استخدام. كانت إذاعية رواندية تبث أماكن وجود السكان من قبيلة التوتسي، محرضا أبناء الهوتو "اذهبوا لقتل الصراصير". قتل في تلك الحرب ما يزيد على 800 ألف رواندي، ولم ينتصر أحد، لأن الأطراف كلها تنهزم في أي حرب أهلية.
لا يحتاج الأمر أكثر من ثلاث خطوات لإشعال حرب أهلية: تسييد الجهل، إثارة الخوف، والتحريض على العنف.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.