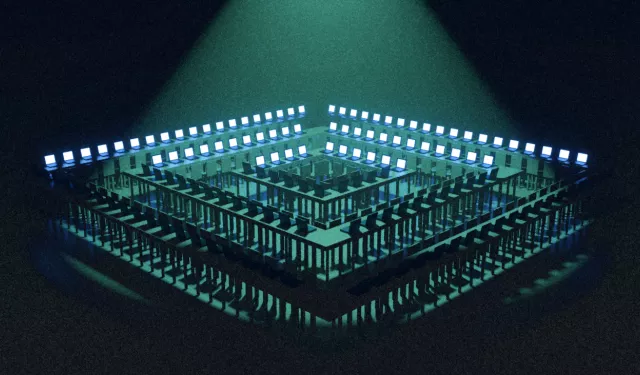
الماكينة في مواجهة العامل: لماذا لا تحررنا التكنولوجيا؟
على بوابة معسكر أوشفيتز نقش النازيون عبارة "العمل سوف يُحرركم". فهل كان النازيون بحاجة إلى شعار ومُبرِّر تشجيعي للعمل القسري؟، ولماذا استخدموا هذا المُبرِر على بوابة معسكر يُوقِن المارون إليها أنها عبور إلى الجحيم اللاعقلاني؟
لا يُميّز البشر في مجتمع اليوم عن يهود أوشفيتز سوى أن العمل القسري، وماكينة الطحن اللانهائية لأجل ضمان أساسيات الحياة، لا تنتهي داخل فرن الغاز، وإنما تنتهي بموت بطيء يائس بعد محاربة المرء لنيل قدر من التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.
تُنتج الآلة الرأسمالية اليوم قلقًا بقدر ما تنتج من بضائع، يساعد القلق في خلق مُستهلكين جُدد لابتلاع كم البضائع الهائل، الذي يروج له مهندسو رغبات زائفة متخصصين في خلق الأوهام، وموظفو بورصات متخصصين في خلق الديون.
هكذا لم تنفعنا التكنولوجيا الهائلة في تقليل ساعات العمل، بل أنها تقريبًا ضاعفتها لخلق كمية أكبر من البضائع عبر استغلال فائض الوقت الذي أتاحته الآلة، مع وجود جيش من كهنة الرأسمالية المعاصرين، أي خبراء التسويق، وهم فئة تافهة من محترفي الكذب، واستفزاز المشاعر.
يعمل المسوّقون على خلق رغبات استهلاكية جديدة تخدم تحقيق المزيد من الأرباح لأصحاب العمل، حيث يخلقون لدى الفرد دافعًا لبذل المزيد من العمل بما يفوق حاجة المجتمع الحقيقية كي يلبي رغبات مُتخيلة لا يلبيها أبدًا، لأنه في اللحظة التي يتمكن بها من نيل السلعة التي أقنعته الإعلانات بأنها وسيلته إلى الراحة والرفاهية والسعادة، يخلق المختصون سلعًا جديدة برغبات جديدة تُشعِر الفرد المُجهَد بأن السلعة القديمة التي لم يكد ينعم بها ليس لها قيمة تُذكر، وأن عليه القلق مجددًا بشأن السلعة الجديدة التي يعرضها الإعلان.
لقد صُممت الدعاية لا لتمنحنا السعادة، ولكن كي تخلق رغبات لا تنتهي، تجعلنا نشعر دومًا بأن ما لدينا لايكفي، وأن الجديد المعروض بالإعلان هو ما سيكفينا حقًا، وعندما نمتلك ذلك الجديد، يظهر على الفور جديد آخر يعدنا بامتلاك السعادة، وهكذا ندور في دائرة مغلقة.
يجب عليك أن تكون سعيدًا، هذا أمر، لكن أين تجد السعادة؟، في زجاجة "الكوكاكولا" وشيكولاتة "جالاكسي" بالطبع، "اضحك والضحكة تبقى ضحكتين"، لكن كم من الناس يضحك بالفعل رغم ملايين الزجاجات الفارغة؟ هل زجاجة الكوكاكولا غاية في ذاتها أم وسيلة مساعدة لوضعي في استعداد نفسي مُعين خلال موقف ما من حياتي لا تصنعه الكوكاكولا، وإنما تصنعه ضرورة التواصل والاجتماع البشري.
اسأل نفسي، هل تصنع الكوكاكولا أو القهوة مثلًا بهجتي للقاء حبيبتي، أم ابتسامتها هي التي تصنعها؟، وهل أنا سعيد فقط لأنني أشرب الكوكاكولا أم لأنني أشاركها مع صديق؟، إذًا، فالكوكاكولا مجرد وسيلة وخادم لحياتي اليومية، لكن الدعاية تخلق منها إلهًا قادرًا على جعل الناس يُعرّفون أنفسهم ويتعرفون على بعضهم البعض من خلال السلع التي يمتلكونها، وليس من خلال خصالهم النفسية والاجتماعية، والمواقف التي يختبرونها يوميًا.
مستخدم منتجات أبل قد يكون مُستعدًا لخسارة صديق يُفضّل سامسونج، وذاك لا يَعرف شيئًا عن نفسه سوى في ماركة سيارته، وهكذا تتحول العلاقات الاجتماعية أكثر فأكثر إلى علاقات أحادية البُعد بين تجار وزبائن، أو بين أشياء تمتلك أشياء، حيث تتوسط بينهم السلع في تسمية وتشكيل مسار تلك العلاقات دون الانتباه إلى حقيقة أن السلعة "س" لا تخلق السعادة وإنما الطلب الاقتصادي على السعادة.
لقد تسبب الضغط الإلزامي للسعادة في جعل الناس غير سعداء، حيث تقوم الحياة الآن على ما "نشاهده ونشتريه ونستهلكه، أكثر مما نفعله أو نصنعه"، وحيث يكون الفرد مُجرد مُتلق سلبي للتصورات الاستهلاكية حول السعادة التي يُصدّرها الإعلام باختزالها في شراء المزيد من الأشياء.
أنت تملك أيفون 11 لكنك لا تشعر بالسعادة لأن شركة أبل أنتجت بعده أيفون 11 برو لا تملكه، بالرغم من عدم الفارق الكبير والحاسم في الإمكانيات بين الاثنين أو أنها لا تمثّل فارقًا جوهريًا بالنسبة لك، وبالمثل تنتج شركة سامسونج عدة موديلات في العام الواحد، يمكن بعد مجهود شاق استخراج فارقًا واحدًا صغيرًا أو اثنين بينهم.
مزرعة الحيوان التكنولوجية
كان العمل ضروريًا للبشر من أجل إعادة إنتاج حياتهم المادية والاجتماعية، لكن كلما اقتربت إمكانية التحرر من تلك الضرورة، ومعها إمكانية تبديل بنية الوجود الإنساني، مالت الرأسمالية المُعاصرة إلى قمعها عبر كبح نتائج تطور التكنولوجيا التي تتيح تلك الإمكانية.
إذ تخلق التكنولوجيا باستمرار مساحة للإنسان يمكن أن تحوله من ذلك الكائن الذي ينبغي أن يؤدي أعمالًا شاقة، أو مُستهلِكة للوقت، بهدف إعادة إنتاج حياته المادية/الاجتماعية، إلى إنسان مُوجه/مُسيّر لتلك الأعمال بصورة تمنحه وقت فراغ لا سابق له، وتجعله بالفعل قادرًا على تقليص وقت العمل.
لكن بخلاف المنطق، والإمكانيات التي أتاحتها التكنولوجيا، فإنها في نفس الوقت تخلق ضمن الرأسمالية المزيد من العمل وما يترتب عليه من توتر نفسي.
من الثابت أن مصدر الربح لم يعد نابعًا من الوقت المبذول في العمل وإنما مصدره فعالية الآلة الإنتاجية، فعقلانية المجتمع الرأسمالي التقني تتضمنها لا عقلانية تتمثل في سعيه الدائم لتحقيق "الكمال التقني" بالاختراعات الجديدة، لكن مع كبح الثمار المنطقية لذلك الكمال عند كل منعطف.
كلما تجددت وسائل تنظيم العمل الأكثر فعالية بواسطة التكنولوجيا، والتي تُمكّن الإنسان من تحقيق وقت حر، وتُقرِبّه من إلغاء العمل الإلزامي، تظل علاقات الإنتاج على حالها، وبدلًا من تعميم وفرة البضائع التي ينتجها التصنيع التكنولوجي الحديث، تُعمَم السيطرة على مُنتجي هذه الوفرة الحقيقيين، وبدلًا من توسيع نطاق الحرية التي تتيحها وسائل التنقل والاتصال الفائقة، تتوسع الرقابة، والقيود المفروضة على التنقل، وتفترس الحدود قاصدي الترحال.
إن وسائل النقل المُعاصرة فائقة السرعة تثير السخرية، إذا قورنت حرية السفر المتاحة أمام 90% من سكان العالم المُعاصر بحرية أكثر رحالة العصور القديمة كسلًا. هكذا نقلت التكنولوجيا سيطرة الإنسان لأقصى مداها، لكنها على عكس المُنتظر منها؛ قلّصت حريته.
رغم أن التكنولوجيا أتاحت للمرة الأولى على الإطلاق إمكانية إلغاء العمل، وتوجيه إنجازات التكنولوجيا إلى الإبداع الحر للمواهب، والعمل بدافع الرغبة وتحقيق الملَكات وليس الإرغام، لكنها حققت في المقابل التعبئة العامة الدائمة في خدمة مُتطلبات الاستهلاك، حيث تخلق وسائل الدعاية رغبات جديدة تخدم استمرارية الإنتاج وروتينه الوظيفي اليومي المُستنزِف للوقت، والذي يحرم بدوره غالبية المُنتِجين من تجريب تلك الرغبات، لأنه يسلبهم إما الوقت أو المجهود أو كليهما.
فرغم تحول العمل اليدوي شبه الكامل إلى العمل نصف الآلي المُتمثل في تشغيل أو تحريك الآلة، إلا أن وتيرة العمل تزداد بإطراد يستهلك نفس وقت العمل اليدوي بل أكثر منه، ويستهلك العامل نفسيًا وذهنيًا، "ليحل التوتر النفسي أو الذهني محل التعب العضلي"[1].
المقصود هنا بالعامل ليس النموذج "البروليتاري" الكلاسيكي، الذي انتهى منذ زمن بعيد، وإنما كل مُوظف، وأجير يدفع قوة عمله ووقته وتفكيره ثمنًا لرب العمل. إنه إذًا مجتمع تعبئة عامة ليس في سبيل الإيمان أو الأيديولوجيا، وإنما في سبيل الرغبة، تلك الأخيرة التي لا تتحقق أبدًا، طالما أنها ظلت مُجرد وسيلة لتجديد دماء العمل اليومي، والذي يظل بدوره وسيلة لتجديد ثروات النخبة الحاكمة.
[1]الإنسان ذو البعد الواحد، هربرت ماركوزه، ترجمة جورج طرابيشي، 61
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.