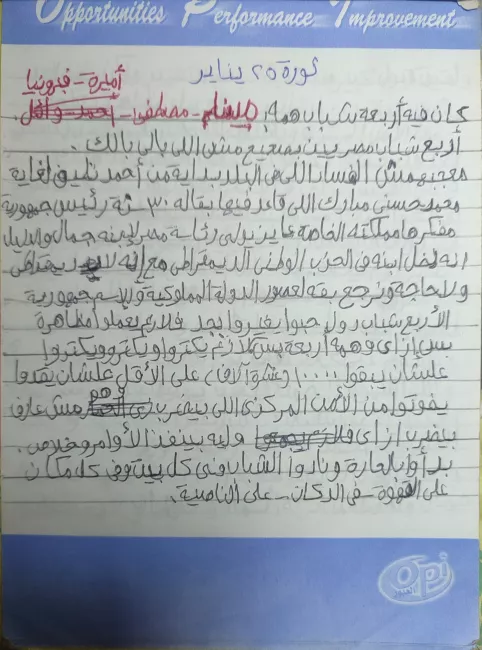يناير وGen Z| نعم.. إحنا "العيال" اللي كانت في ابتدائي!
يستفزني البوست الكلاسيكي ليوم 25 يناير "ساعات بخاف تبقي ذكرى ونبعد عنك تموت الفكرة"، ليس لأن الميدان أصبح ذكرى بالفعل، أو لأن الفكرة تحتضر تحت ثقل المسلة والكباش، بل لأني إذا شاركته على صفحتي، سأجد التعليق الأول جاهزًا من أحد الأصدقاء "ثورة إيه يسطا أنت كنت في ابتدائي!"
إزاء هذا التعليق لا أملك سوى الصمت. فأنا من مواليد عام 2000، "دفعة سبيستون" كما يروق لهم أن يسموها. لم أذهب إلى التحرير ولم أقف في لجنة شعبية. لم أهتف للعيش والحرية، ولم أحمل العلم أو الميكروفون، ولم أفر من عربات الإطفاء التي أطلقت الماء على المتظاهرين. لم أرسم على الدبابة، وإن كنت التقطت صورًا معها بعدها بشهور عندما استقرت أمام محكمة طنطا.
ساهمت مدينتي "طنطا" في هذه العزلة، فالمسافة بيننا وبين القاهرة لم تسعفنا بمحاولة الاشتباك معها. كانت كل علاقتي بالثورة بضع فيديوهات على موبايل والدي، التقطها للمسيرات القليلة التي انطلقت خلال الـ18 يومًا في مدينتنا المسالمة بطبعها. على الرغم من أن جارتنا، مدينة المحلة الكبرى، كانت مشتعلة بالغضب والعنف.
قد يُفهم من هذا أني لم أكن حاضرًا خلال الأحداث، لكن العكس هو الصحيح. فالشأن العام كان جزءًا من نقاشات بيتنا على مدار سنوات ما قبل يناير. أتذكر أحاديث والدي معي، رغم حداثة سني، عن الفساد وتردي مستوى المعيشة وتدهور التعليم والصحة والتلوث البيئي وغيرها من الآفات التي صاحبتنا أيام مبارك.
كما حدثني أبي كثيرًا عن صولاته وجولاته أيام شبابه؛ مشاركته في "انتفاضة الخبز" حين كان طالبًا بكلية الحقوق، واعتصامه محاميًا شابًا بمحكمة طنطا حينما أُهين زميل لهم، حالفني الحظ لأشهد يومًا من هذه الأيام حينما اعتصم أبي مرة ثانية بالمحكمة مع زملائه المحامين بعد واقعة محامي طنطا ووكيل النيابة الشهيرة في 2010.
أما في 2011، وكنت في الصف الخامس الابتدائي، وعلى عكس الكثير من أصدقائي بالمدرسة الذين لم تعنِ الثورة لهم سوى تأجيل بداية "الترم الثاني" لعدة أسابيع، فكانت يناير حاضرة في منزلنا بقوة، صحيح أني لم أذهب إلى الميدان لكن مَن قال إن المشاركة يجب أن تكون جسدية؟ على مدار الـ18 يومًا لم تنقطع سيرة الثورة أو أخبارها.
في بيتنا ثورة
على شاشة التليفزيون شاهدت الملايين يصطفون للهتاف حاملين علم مصر، شاهدتهم مسلمين يؤدون صلاة الجمعة بينما يؤمّنهم المسيحيون، تابعت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، حضرت عبر الشاشات موقعة كوبري قصر النيل في يوم "جمعة الغضب"، وهجمة الجمال والخيول على الميدان يوم 2 فبراير.
تابعت أحداث مدينة السويس وكذلك الإسكندرية والمحلة، حفظت أسماء أماكن لم أكن أعلم بوجودها من قبل، مثل مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وميدان الأربعين بالسويس. رأيت أثر خطاب مبارك العاطفي على الكثيرين، وسمعت بشائعة وجود قوات أمريكية في قناة السويس.
وعلى الراديو استمعت إلى أغانٍ مثل يا بلادي وإزاي. كانت الـ بي بي سي مصدر الأخبار في بيتنا لأن أمي قالت أن الجزيرة تهوّل من الصورة والتليفزيون المصري يكذب. لم نكن من هواة القنوات الفضائية المصرية أو التوك شو وقتها، لكني أدركت معنى التحيز الإعلامي في سن مبكرة!
رغم كون بيتنا "متفتح فكريًا"، إلا أن الكلام في السياسة ظل لسنوات "محظورًا" خارج حدود المنزل. كان مبارك هو "الرجل الذي لا يجب ذكر اسمه"، والانتقاد يكون بالرسائل المشفرة لكيلا "نروح ورا الشمس". كان لدي شعور دائم بأن الأخ الأكبر يراقبني، كما في رواية جورج أورويل الشهيرة، إلا أنني اندفعت مع يناير بحماس الطفل التوّاق للتغيير.
أتذكر أنني لم أنفتح على الكلام العام إلا بعد ثورة يناير، مع أنه كان كلامًا بريئًا لدرجة السذاجة بحكم سني وقتها، إلا أنه كان حماسيًا بما يليق بـ"ثورية" الفترة. أثناء بحثي في كتبي القديمة عثرت على قصة قصيرة بعنوان "25 يناير" من تأليفي وقتها، أعتقد أنها شكلت جزءًا من توجهي بعد ذلك للعمل بالصحافة.
خلصتنا الثورة من حالة الإحباط السائدة وقتها. وهي حالة عامة انعكست حتى على السينما والدراما. المشهد الشهير لعادل إمام وهند صبري في "عمارة يعقوبيان" عبّر عنها حينما عابت "بثينة" على "زكي باشا" أنه يرى الدنيا من منظوره الأرستقراطي، معللة بأن "مصر بقت قاسية أوي على أهلها" وأن رغبة الناس في الهروب منها "مش كره فيها لكن محدش قادر يتحمل ظلمها".
لم يكن هذا الإحباط اقتصاديًا فقط ولكن سياسيًا أيضًا، كان الكل يائسًا من أي تغيير، ولسان حالهم أن "القيامة لو قامت الشعب ده مش هيقوم". كان مبارك عشرة 30 عامًا و"العشرة متهونش إلا على ابن الحرام".
للأسف، كان هناك من يخجل من مصريّته إما ضيقا بالأحوال المعيشية أو لأنه "لم ير منها خيرًا" لكن الأمر تغير مع الثورة. أورثتنا شعورًا بالفخر والكرامة، "ارفع راسك فوق أنت مصري" كانت تُقال بصدق ومن القلب، حتى إن الكشاكيل المدرسية استبدلت بصور أبطال الكارتون على أغلفتها صورًا من الثورة، وكانت من الأكثر مبيعًا، تحول علم مصر من أداة تشجيع أثناء مباريات كأس الأمم الأفريقية إلى أيقونة بالمنزل، وقتها اشترينا علمًا واستقر على حائط غرفة جلوس منزلنا.
في المنطقة الرمادية
أدين للثورة بالفضل في ما أنا عليه حاليًا. ومع أني عاصرت يناير من كرسي المتابع إلا أنها شكلت علاقتي بالسياسة ومتابعتي للشأن العام بانتظام منذ 2011 وحتى الآن. أتذكر أني كنت أناقش أبي في أنظمة الحكم المختلفة، وإن كان يناسب البلاد النظام الرئاسي أو البرلماني أو خليط بينهما؟ تعرفت إلى مصطلحات كالرأسمالية، الديمقراطية، الإئتلاف، التكتل، الفرق بين المظاهرة والإضراب والاعتصام. سمعت مصطلحات المطالب الفئوية وحكومة التكنوقراط، بل وأخذت أجادل الكبار، عبتُ على "حزب الكنبة" جلوسهم بلا حراك، وسهرت على خناقات "التوك شو" المسائية. أعتقد أنه لولا يناير وما تلاها لما أصبحت صحفيًا.
كبرت وفهمتُ أن معظم الأحداث تقع في المنطقة الرمادية، فلا خير مطلق أو شر مطلق. ورغم حالة الجدل التي تتجدد مع تلك الذكرى "ثورة ولّا مؤامرة" فإني حتى الآن لا أستطيع أن أراها إلا بعين الطفل ذو الـ11 عاما، حلمًا ملائكيًا مسّنا مرة ومازلنا نعيش على أثره ونبكي أطلاله.
لن أخجل، شاركت في الثورة وإن لم يكن بجسدي.. وفي العام القادم سأعيد شير بوست "ساعات بخاف تبقي ذكرى".. نعم أنا "العيل اللي كان في ابتدائي"، وأفتخر.
مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.