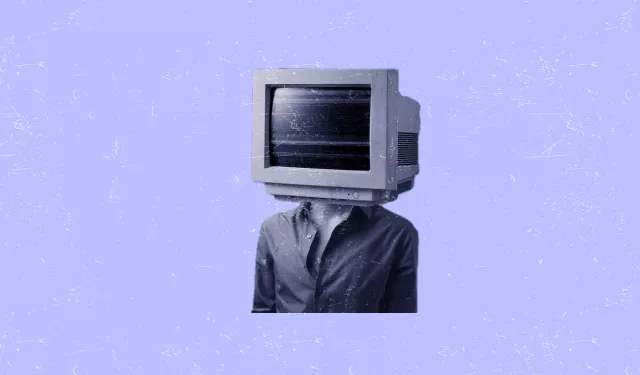
صناعة البرمجيات.. بدأت حلمًا ممكنًا وانتهت كفانتازيا
إنتاج بلا تكلفة تبخر من إيدينا فأضاع المليارات
كان والدي مشغولًا بعلوم المستقبليات، يقرأ ويكتب عنها كثيرًا. ولما حانت لحظة الحقيقة في اختيار الكلية لملء رغبات التنسيق، وذلك عام 1999، دار بيننا حوار لا أنساه.
حصلت على 97% علمي رياضة، وكنت أضمر رغبتي في دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حتى يحين الوقت. فعلت كل ما بوسعي، وهو الحصول على مجموع عالٍ يضمن لي النفاذ من ثقب الإبرة، إذ كان الأفق في مصر ضيقًا للغاية والأقاليم خانقة ومختنقة؛ الحياة محجوبة عنها تقريبًا.
ما كنت أشعر به في مراهقتي في مدينتي المحلة والمنيا، حيث تتواجد عائلتي، هو نفس ما رأيته وعشته في كل محافظات مصر التي زرتها مرارًا بسبب انخراطي في العمل السياسي لاحقًا، وحتى الآن.
كانت الفرصة لحياة أفضل مرهونة بدراسة الطب أو الهندسة ثم السفر للخليج، ولكنني كنت أريد رحابة أخرى لحياتي؛ سأدخل جامعة القاهرة.
عندما حان الوقت، صرحت لأبي بما أضمرته فانزعج بشدة "هتشتغل إيه بعد سياسة واقتصاد، معندناش واسطة توديك الخارجية، هتعمل إيه بقى؟!". ليس لديَّ رد، تلك هي رغبتي ولكني لا أعرف المصير والمسار بعدها، فقلت طيب إعلام، فرد بالمثل "وهيا فين الجرايد ولا القنوات؟ ولو اشتغلت في جرنال من القليل المتاح هتاخد كام؟! عاوز تضحي بمستقبل مضمون وتبهدل نفسك!".
أسهب والدي يقنعني بهندسة البرمجيات حديثة العهد في مصر، والتي توقع من خلال قراءاته أنها ستكون صناعة المستقبل هنا كما هي في بلدان كثيرة، وأن المهندسين الأوائل سيكون لهم شأن عظيم. اقتنعت برأيه خصوصًا وأن هذا الحل سيكفل لي الدراسة في جامعة القاهرة حيث أرغب، إذن فلمَ لا؟
دفعة مميزة
كنت في الدفعة الرابعة التي تدرس هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات في مصر، وكافح وقتها الدكتور إبراهيم فرج رحمه الله لخلق هذا التخصص، مستعينًا بمناهج أمريكية وإنجليزية لتدريسها بجامعتي القاهرة وعين شمس، على أن تكون الدراسة باللغة الإنجليزية، بينما للأسف كانت الفروع الأخرى في جامعات الأقاليم تدرِّس مناهج مصرية باللغة العربية، وما زال الحال كما هو حتى الآن.
ومنذ اللحظات الأولى في الجامعة شعرنا كطلاب بالتميز، فالسوق فارغة ومتعطشة وبمجرد تخرجنا سنكون "الألفا". لقاءات مستمرة ومحاضرات مع مديرين مصريين وأجانب في مايكروسوفت وأوراكل وIBM، نسمع فيها عن تطور هذه الصناعة في العالم سواء الدول النامية أو المتقدمة، ونستشرف مستقبلنا ومستقبل بلدنا الذي يمكن أن نكون لبنة في تطويره ونقله نقلة نوعية من خلال هذه الصناعة.
وبالطبع كانت تجربة الهند حاضرة في الأذهان طوال الوقت، وتماشى ذلك مع توجه الدولة في مصر وقتها لدعم تلك الصناعة على مستويات عدة، كالتوسع لاحقًا في تدريس البرمجيات وإنشاء مراكز حكومية مضطلعة بالأمر، ولكن الأهم كان الوعي بضرورة خلق طلب محلي حكومي على منتجات البرمجيات.
مبادرة حكومية
أطلقت وزارة الاتصالات في عام 2002 برنامج تنمية الطلب المحلي، وكان هدفه توفير فرص للتعاقد بين الحكومة وشركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة. فهمت الوزارة حينها أن نمو صناعة البرمجيات مرهون بقدرة الشركات المصرية على بيع ما تنتجه. بما أن الطلب لدى القطاع الخاص كان ضعيفًا للغاية، فلا سبيل سوى توفير فرص في إطار الطلب الحكومي.
لذا، بدلًا من التعاقد مع شركات أجنبية على تنفيذ قواعد البيانات والبرمجيات التي تحتاجها الحكومة، اتجهت الأخيرة لطرح ذلك على القطاع الخاص المصري الناشئ، ما سيساعده على بناء وتطوير برامجه الخاصة التي يمكنه لاحقًا بيعها لمستهلكين آخرين.
ما يميز صناعة البرمجيات عن غيرها أنها صناعة نظيفة منتجاتها عالية الثمن والربحية
يتطلب ذلك أن تستثمر شركة برمجيات ما في الطاقة البشرية، ممثلة في مهندسيها ذوي الخبرات، تدفع لهم مرتبات ليطوروا برنامج "س"، الذي تعاقدت عليه مع جهة ما. وبعد أن يكتمل البرنامج يمكنها إعادة بيعه مرات لجهات أخرى.
مثل نظام التشغيل ويندوز المستخدم على اللابتوبات الآن، فما هو إلا برنامج تم إنتاجه لمرة واحدة ثم باعه بيل جيتس ملايين المرات بعد ذلك، حتى زادت قيمة شركة مايكروسوفت المالكة لويندوز، وبرمجيات أخرى، عن تريليوني دولار، أي ألفي مليار دولار (اختصار مخل ولكن يقرب المعنى).
ليس هذا فحسب، بل ستقدم الشركة مالكة البرنامج "س" خدمات ما بعد البيع، أي الدعم التقني، للبرامج التي باعتها للمستهلكين، سواء كانوا أفرادًا أو مصانع أو شركات أو مؤسسات حكومية، إلخ.
ما يميز صناعة البرمجيات عن غيرها أنها صناعة نظيفة منتجاتها عالية الثمن والربحية، نظرًا لإمكانية بيعها أكثر من مرة، ولأن مدخلات إنتاجها ليست موادَّ خامًا مادية؛ لا يوجد طوب ولا أسمنت ولا غيرهما مما نحصل عليه بالعملة الصعبة. فقط معرفة وتعليم.. رأسمالك هو مهندس برمجيات جيد، فقط.
وادي الهند السحري
خلال النصف الثاني من السبعينيات، وبينما يلهو أنور السادات في بناء مشروعه الاقتصادي العبثي في بلدنا المحبوب، كان أحد المسؤولين الهنود يحلم بتأسيس وادي سليكون هندي يماثل الوادي الأمريكي الذي تأسس في بداية السبعينيات في سان فرانسيسكو، وتحول لعاصمة التكنولوجيا في العالم.
اختار المسؤول الهندي مدينة بنجالور لتكون مقرًا للحلم، وتحولت بالفعل في التسعينيات لما يمكن أن نسميه وادي سليكون هندي؛ أحد أهم معاقل الصناعات المرتبطة بتقنية المعلومات في العالم للشركات العالمية والمحلية. هكذا تُبنى الدول وترتقي وتتقدم، مبادرات بخيال مفتوح ودأب مخلص في البحث والتنفيذ، وتوجه حكومي يُسخِّر ما يمتلكه من أدوات لإنجاح المبادرة.
من أجل تحقيق هذا الحلم توسعت الهند في فروع التعليم المرتبطة بالتكنولوجيا، وخصوصًا البرمجيات، معتمدة على مناهج أجنبية باللغة الإنجليزية. وتنامى ذلك بشكل مضطرد حتى قارب عدد الخريجين المتخصصين في هذه الفروع النصف مليون سنويًا، وصار الوادي الهندي مقرًا لمئات الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا المختلفة وآلاف الشركات المحلية.
هكذا صارت الهند المُصدر الأول لمطوري البرمجيات في العالم، حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وصل الأمر أن أكثر من 15% من الشركات الناشئة في وادي السيليكون الأمريكي أسسها هنود، بل وثلث الشركات الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية عمومًا يؤسسها هنود! لماذا؟ لأنهم تلقوا تعليما جيدا.
انتعاشة مؤقتة للشركات المصرية
في سياق برنامج تنمية الطلب المحلي في مصر، والذي استمر حتى 2009، تم تنفيذ مشروعات قومية بواسطة شركات برمجيات مصرية.
من ضمن هذه المشروعات مشروع "التنسيق الإلكتروني" الذي نفذته كلية هندسة القاهرة، ووُضع قيد الاستخدام بشكل نهائي في عام 2005، وكذلك مشروع ميكنة المحليات، بإنشاء مركز تكنولوجي في كل حي لتقديم خدمات المواطنين من خلاله، والذي بدأ في 2004 في حي شرق بالإسكندرية. ومشروع خدمات الانتخابات الذي تم تطويره قبل 2011 واستُخدِم لأول مرة في انتخابات البرلمان 2011.
استغللت إتاحة الإمكانيات أثناء فترة التجنيد لأتعلم العمل على بناء قاعدة البيانات أوراكل
وهناك أيضًا مشروع المشتريات الحكومية، الذي ينظم مناقصات الدولة عبر موقع إلكتروني، ويتلقى طلبات الشركات بالتنفيذ ويضمن رؤية مركزية للمخازن بكل قطاعات الدولة، وهذا توقف طبعًا. كما كان هناك مشروع بطاقة التموين، الذي بدأ من السويس في 2005 وتم تعميمه بحلول 2010، وبناءً عليه تم بناء قاعدة بيانات الأسرة، وتكاملت لاحقًا مع الرقم القومي لاستخدامها في أغراض متعددة. وفي هذا النموذج كانت الشركة الخاصة تدير العمليات على البرنامج بينما قاعدة البيانات موجودة في وزارة التموين، وذلك بحسب حديث دار بيني وبين وزير سابق مطلع على الملف.
الدخول الأول للسوق
استغللت إتاحة الإمكانيات أثناء فترة التجنيد لأتعلم العمل على بناء قاعدة البيانات أوراكل، حيث كنت أحد المسؤولين عن نظم المعلومات بأحد المطارات الحربية. وأوراكل كان وقتها هو البرنامج/قاعدة البيانات الأكبر، المستخدم لبناء قواعد البيانات في الشركات الكبرى والحكومات الإلكترونية.
بعدها بدأت حياتي المهنية بالعمل في إحدى الشركات الخاصة الشهيرة بحي الزمالك، وكانت تستخدم أوراكل، ثم انتقلت للعمل مع فرع شركة سعودية بالقاهرة لديها تعاقد لتنفيذ جزء من مشروع الحكومة الإلكترونية السعودية.
بعد فترة، وتحديدًا في 2008، قررت الشركة إغلاق مكتب القاهرة ونقل جميع المهندسين العاملين على المشروع إلى السعودية، وبالفعل تم الأمر، وما زالوا جميعهم في السعودية حتى يومنا هذا. ولكني قررت عدم السفر، إذ كنت وغيري من زملاء الدفعة نعتقد أن السوق بمصر واعدة ويمكننا اتخاذ القاهرة مركزًا لتصدير منتجاتنا من البرمجيات للدول العربية.
هكذا كنا قبل تحولات 2011 وطغيان السوشيال ميديا وموجة الشركات الناشئة؛ شبابًا صغيرًا في منتصف العشرينيات لا نملك سوى ما تعلمناه، وخبرتنا البسيطة في بعض الشركات، نعيش في أجواء محدودة ومنغلقة ولكننا نفكر في تأسيس شركات وتصدير برمجياتنا للخارج، لأننا ببساطة نستطيع.
تم بالفعل تأسيس عدد كبير من الشركات آنذاك، وساهم برنامج تحديث الصناعة في تطوير المصانع من خلال تثبيت أنظمة قواعد بيانات، مما أتاح فرصًا عديدة بالسوق للشركات الناشئة.
الحياة مش لونها بمبي
مع القطاع الخاص سرعان ما ظهرت العقبات التي تحورت كدورة حياة فيروس، من بسيطة يمكن تجاوزها ومعالجتها، لمعطلة، ثم لوحشٍ عصيٍّ على الترويض؛ فالمنشآت الصناعية والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وجزء من المؤسسات الكبيرة، كانت تتعامل مع الشركات الناشئة بريبة ترق لدرجة الاتهام.
ينظر صاحب المنشأة لمسؤول التسويق بالشركة الناشئة على أنه فهلوي أتى ليبيع له الهواء في أزايز، "برمجيات إيه ومرقعة إيه ماهي دايرة بالدفاتر"، وإذا تكرم بالموافقة على التعاقد معك يسلبك أعز ما تملك؛ السعر الجيد الذي يُمكنك من الاستمرار. حدث هذا على الرغم من تكفّل برنامج تحديث الصناعة وقتها بجزء من التكلفة.
من ناحية أخرى، كان باب المشروعات الأكبر مع الحكومة يتضاءل مع الوقت، فمعدلات نمو قطاع البرمجيات البطيئة تدهورت مع حلول عام 2009، بحسب الوزير السابق الذي أشرت له أعلاه، فضلًا عن تكلفة الصيانة الدورية التي تتحملها الشركات.
صارت الهند في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في إنتاج وتصدير البرمجيات عالية الجودة
من ناحية مقابلة، فالبنية التي تقدمها الدولة لدعم تلك الصناعة ضعيفة أو بها مشاكل. هناك شركات غادرت البلد أو أغلقت أبوابها بسبب وقوع خدمات الـ VPN من وقت لآخر، بسبب سوء الخدمة أحيانًا وبسبب إغلاقه عمدًا من قبل الحكومة للتأثير على برامج المكالمات أحيانًا أخرى.
ناهيك عن أن مصر أصلًا في المركز التسعين عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت بـ47 ميجابايت.
البريق الزائف للقرية الذكية
زاد من تفاقم الوضع تركيز وزارة الإتصالات على توريد العمالة للكول سنتر/call center outsourcing، إلى جانب تقليل الأطروحات الحكومية للشركات المصرية الخاصة، والاعتماد على التعاقد مع الشركات الأجنبية الكبيرة.
ومع تعاظم نصيب القطاع الحكومي من الاقتصاد، كانت الأطروحات تتركز بشكل أكبر في أيدي مشروعات البرمجيات وقواعد البيانات المعتمدة على الشركات الأجنبية، ما ساهم في إخصاء صناعة البرمجيات المصرية بالبطيء على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
ليس هذا فحسب، بل تم توجيه الدعم والتسهيلات لفكرة "الكول سنتر"، حتى أن الشركات الأجنبية الكبرى ذات المقرات الفخمة في القرية الذكية، تحولت لمراكز للدعم الفني والتسويق والمبيعات، ولم يعد يتم بداخلها تطوير أو تصنيع للبرمجيات، وذلك بحسب الوزير السابق الذي تحدث لي.
أحد أوجه الاستثمار الهامة في العالم الآن، هو تقديم الخدمات المعتمدة على قواعد بيانات ضخمة/data centers، ومن خلال الخدمات السحابية/cloud service providers. وكانت شركة مايكروسوفت شرعت في بناء أحد مراكز البيانات تلك في مصر، وهو استثمار كبير يقدر بمليار دولار، ولكنها مع تقليل وجودها في مصر إلى الحد الأدنى، والذي وصل ذروة دنوه مع 2017 بسبب سوء مناخ الاستثمار، قررت توجيه أعمالها إلى السعودية ودبي، على الرغم من كونهما متحفظتين أمنيًا، بالإضافة إلى اليونان وجنوب إفريقيا، بحسب نفس الوزير السابق ذكره.
في المقابل، أنشأت الدولة مركزين للبيانات في العاصمة الجديدة مخصصان لخدمة الحكومة فقط، على أمل أن يتم نقل بيانات الوزارات وتطبيقاتها إليهما، ثم إنشاء سيستم موحد. ولكن حسب فهمي، فهذا السيستم لن يدعم العمل عن بُعد، ومركز البيانات الأخير تمتلكه الشركة المصرية للاتصالات وتحاول جاهدة تسويقه بالخارج، والشيء بالشيء يذكر، فمشروع الحكومة الإلكترونية تحول لبوابة مصر الرقمية بخدمات متواضعة لم تتطور، وذلك بحسب نفس المصدر المطلع على الملف.
لماذا نجحت الهند وفشلت مصر؟
يدعم النظام الضريبي الهندي صناعة البرمجيات والتطوير الخارجي للخدمات، فهناك إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للشركات المزودة للإنترنت، وإعفاء لمدة عشر سنوات للمجمعات التقنية مثل الذي شيدته شركة صن مايكروسيستمز في بنجالور، والذي يضم خمسة آلاف مبرمج وفني، بينما تمنح الهند الشركات العاملة في البحث العلمي إعفاءً ضريبيًا لعشر سنوات.
من ناحية أخرى، أسست الهند بنية اتصالات قوية، خاصة في مراكز الإنترنت، فمزودو الاتصالات اللاسلكية ينتشرون في أنحاء البلاد، علاوة على شبكة فاعلة من الأقمار الصناعية والكابلات البحرية التي تؤمن اتصالًا جيدًا مع جميع أنحاء العالم.
تقوم تلك البنية التحتية العملاقة بدور مهم في تنمية خدمات تطوير البرمجيات للخارج، مما جعل الشركات الأجنبية على اتصال مستمر ودائم مع مزودي هذه الخدمات، وساهم في نمو صناعة التصنيع للغير/outsourcing في الهند على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبالتالي أوكلت شركات غربية مهمة التصنيع والدعم الفني إلى شركات هندية، صنّعت برمجيات بأسعار رخيصة مستفيدة من انخفاض كلفة التشغيل بسبب الإعفاءات الضريبية.
وبفضل هذه السياسات، صارت الهند في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في إنتاج وتصدير البرمجيات عالية الجودة، ويتم فيها تطوير حوالي 40% من البرمجيات المستخدمة في الهواتف الذكية، وصارت الصناعات المرتبطة بتقنية المعلومات توفر فرص عمل لقرابة أربعة ملايين شخص بشكل مباشر، ولعشرة ملايين آخرين بشكل غير مباشر.
والآن، وصلت صادرات الهند من خدمات البرمجيات إلى 156 مليار دولار في عام 2022، أما الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا عموما فأصبحت 245 مليار دولار في ذات العام.
نهاية سعيدة متوقعة
أغلقت أغلب الشركات الناشئة في المجال أبوابها، بينما استمر البعض في المجائرة لفترة ثم أغلق هو الآخر، واتجه أغلبية المهندسين للعمل كموظفين في شركات أكبر، محدودة ومحددة. أما من لم يجد فرصة مناسبة فسافر للخليج، وبدأت موجات متلاحقة من هجرة مهندسين البرمجيات المصريين للاستقرار ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، ونسبة قليلة ما بين أمريكا وكندا وأستراليا.
وإذا كان يراودك الآن سؤال عن مصيري الشخصي ولماذا أكتب لك تلك السطور، فتقريبًا أنا الشخص الوحيد في هذه الدفعة، والدفعات التي سبقتها وتلتها، الذي هجر المجال مع قيام ثورة يناير واتجه للعمل بالصحافة والتليفزيون. ولا أخفيك سرًا، لم أحب تلك المهنة قط، فانتهزت الفرصة وخلعت.
