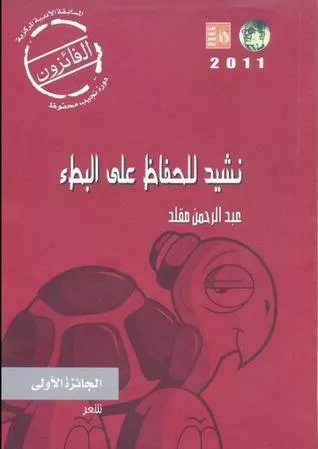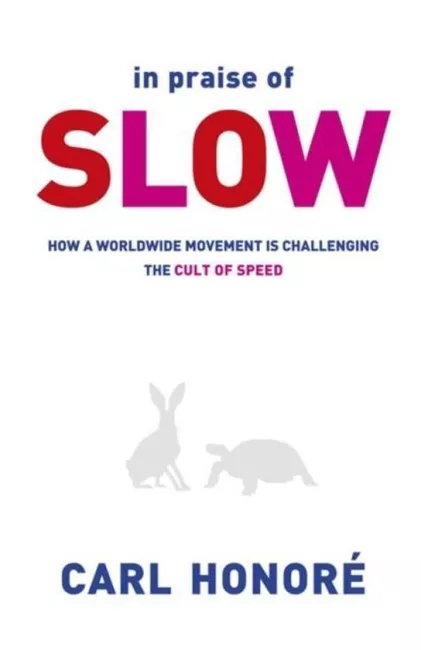الحنين إلى طمأنينة السلحفاة
عن عالم لا مكان فيه للمتباطئين
بلغ عدد الرسائل الورقية والبطاقات البريدية التي تبادلتُها مع أصدقاء من مختلف أنحاء العالم في مطلع العام الجاري المئةَ أو يزيد. وكان هذا في حدِّ ذاته إنجازًا ووقوفًا في وجه تسابق جنونيٍّ مع عقارب السّاعة، وردَّ فعل مقاوم لسيولة جارفة حبست المرء بين مخالب السّرعة.
جاءت مبادرة التراسل البريديِّ تدريبًا عمليًّا يعزّز من صفات الصبر والتريّث والانتظار في زمنٍ لم تعد فيه هذه المواصفاتُ مطلوبةً ولا مرغوبًا فيها، وصار البقاء للأسرع والأكثر تحمّلًا للـ"عجقات". وكبديلٍ متمهّلٍ للرسائل الإلكترونية التي تصلُ في جزء من الثانية، فتفقد التواصل جوهره وتؤدّي إلى أفول معناه، وتبدو الحياةُ تبعًا لذلك خاويةً مجرّدة.
وبينما كنتُ أستشعر البطء الموسوم بنبرات التحدّي وأخطّ حروفًا متمهلةً لصديقة في باكستان، تذكرتُ ديوان نشيدٌ للحفاظ على البطء للشاعر عبد الرحمن مقلّد، الذي يقول فيه، السلحفاة تعيشُ حتّى لا تجنّ الكائنات/ بهاجسِ الزّمن السّريع/ فتستحيل وقود باخرةٍ يفرّقه الهواء/ ولا نحسّ بها/ إذن للسلحفاةِ ضرورةٌ/ لتعلّم الصبر المحبّ.
دفعتني الأبيات السابقة إلى التساؤل، لماذا أصبحنا مهووسين بالسرعة إلى هذه الدرجة؟ وما الخطب في سرعة السلحفاة؟ ألم ينتهِ بها المطاف إلى التفوّق على الأرنب في السباق الشهير الذي جرى بينهما؟
عالمٌ يأكل السّريعُ فيه البطيء
يعرّف قاموس أكسفورد مصطلح بطيء slow بأنّه مرادف لألفاظ "غير سريع وبليد ومتردّد ومعيق"، ويقودنا التعريف إلى تخيّل الأثر السيئ الذي توحي به كلماتٍ كهذه عن صفة كان مفترضًا أن تكون محورية في حياة أكثر هدوءًا واستقرارًا؛ فالبطيءُ بالمعايير الحديثة شخص منبوذ معرّض للإقصاء، ولا يمكن له بأيّ حال أن يحجز مكانًا في هذا القفص الحديديّ، الوصف الذي أطلقه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر على الحياة الحديثة.
الحياة الحديثة التي قال عنها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب "إنّنا ننتقل من عالم يأكل الكبيرُ فيه الصّغير، إلى عالمٍ يأكل السريع فيه البطيء"[1] فأصبحت السرعة بذلك أمرًا مألوفًا، يجري في حياة الناس مجرى العادة، ويلقي بظلاله على المجالات جميعها.
صار كلّ شيء على غرار القهوة إكسبرس؛ السيارة والهواتف واتخاذ القرار والتخرّج والإنترنت والزواج والطلاق والمناسبات والزيارات. وصار الجميع يلهث وراء أهداف لا سقف لها؛ دوران مستمرّ في حلقاتٍ مفرغة، لتغدو النهاية على شاكلة الكاروشي اليابانية التي تعني الموت من إجهاد العمل والولاء المطلق للشركة، ظاهرة راح ضحيتها نحو 745 ألف عامل في العام 2016 طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.
مع اختلاف أنّ الكاروشي في مصدره اﻷصلي يعني الموت من السرعة والحياة الحديثة بأكملها باعتبار أنّ إرهاصاتها شديدة الوطء على المرء، ومدعاةٌ للإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية المفضية إلى الموت، فيما نستدعيه هنا للإشارة إلى آثار عصر السرعة.
في العام 1982، صاغ الطبيب الأمريكيّ لاري دوسي مفهوم مرض الوقت ليصف الفكرة الوسواسية بأنّ الوقت قليلٌ، موشكٌ على النفاد ويجب الاستعجال باستمرار للحاق به.
والواقعُ أنّ العالم برمّته اليوم، مصابٌ بمرض الوقت؛ فإنسانُ العالم الحديث لا يعترف بوجود كائن اسمه السلحفاة، فهو يريد أن ينجز كلّ شيء في أسرع وأقصر فترة ممكنة، لأنّ الظروف التي يعيش فيها تحتّمُ عليه تنافسًا جنونيًا يورّثُ مباراة مستمرّة مع الوقت كما يقول عالم الاجتماع البولنديّ زيجمونت باومان "إنّ مجتمعنا الذي تسوده النزعة الفردية والاستهلاكية لا يخلق التضامن بل الريبة والمنافسة المتبادلة" [2]، كأنّ العالم بات متجرًا، وغدا البشرِ متسوقين يسعون إلى استهلاك أكبر قدرٍ من التجارب وتكديس الجانب اﻷعظم من المعارف في فتراتٍ وجيزة.
إنّنا لا نكتفي بالسّعي إلى الحصول على وظائف مرموقة تدر دخلًا جيدًا، بل نريد إضافة إلى ذلك التسجيل في صالات الرياضة، والالتحاق باليوجا، وقراءة الكتب الأكثر مبيعًا، ودراسة الكورسات على نحو سريع للحصول على الشهادة لأنّ الورقة أهمّ من المعلومة، وممارسة الجنس صبحًا وقبل الذهاب إلى العمل، ومواكبة صيحات الموضة المتسارعة التي تطرح موديلات جديدة في السوق كلّ ساعة، وتكوين معارف جديدة كل يومين؛ فما أسهل وما أسرع التعرّف على الآخرين! ثمّ لقائهم ودعوتهم إلى المنزل، ومشاركتهم تناول الطعام، لينتهي بنا المطاف إلى نسيانهم وقطع علاقتنا بهم، هكذا بسرعة وبساطة.
حياة تالفة
يروي تود سلون في كتابه حياة تالفة.. أزمة النفس الحديثة، قصصًا متخيّلة عن أشخاص من مناطقٍ متفرّقة هي، فنزويلا الريفية، نيويورك، والقاهرة، بغرض وصف آثار الحياة الحديثة على الأفراد باختلاف أطرهم الثقافية والجغرافية. وعلى خطى سلون تعالوا نتخيل معًا ثلاث قصص، يمكن أن نسبر من خلالها أغوار المسألة على نحو أعمق.
الإسكندرية: تشتكي غادة من تغير طفيف في لون الحقيبة البنية التي اقتنتها قبل شهرين، وتقرّر التخلص منها في سلة المهملات ضاربةً اقتراح أمّها بأن تعيد مسحها بطلاء الأحذية عرض الحائط. وفي طريقها إلى الجامعة، تشتري كعادتها كوب قهوة مصنوع من البلاستيك قبل أن ترميه إلى جانب مئات الأكواب، ثمّ تتذكر موعدها مع صديقتها، لكنها تعتذر عن عدم الذهاب برسالة نصية قصيرة "لدي محاضرة الآن".
وبينما كانت ستقطع الطريق إلى الجهة المقابلة، التقت صدفةً بعمتها التي لم ترها منذ أشهر، تبادلتا كلمات على عجالة، وافترقتا على وعد غير محدّد باللقاء مرة أخرى في مطعم ما، ثمّ مضت كل واحدة منهما إلى وجهتها.
برشلونة: ينتظر الطفل الصغير خوسيه أباه الذي سيقصّ عليه حكايةً قبل النوم. يرجع الأب إلى المنزل منهكًا بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاريع التي وجب ضبطها قبل نهاية الأسبوع، ما يدفعه إلى قراءة قصة قصيرة من كتاب قصص مدّتها دقيقة واحدة للأطفال بوتيرة سريعة، لكنّ الطفل الصغير يتذمّر من قراءة أبيه المستعجلة ويطلب حكاية أخرى "بابا لماذا تنتهي قصصك بسرعة؟".
يحاول الأب بعدها أن يتحايل على ولده، ويطلب منه الاستعانة بأمه. الأمّ منشغلة بكتابة خبر عاجل للصحيفة التي تعمل فيها. ينام الولد دون قصة أخرى.
لوس أنجلوس: زحمة المواصلات في أوجها السابعة صباحًا في الطريق الرئيسيّ، ولا مجال للعبور بنجاح إلا بصعوبة بالغة، فالكلّ مستعجل للحاق بأشغاله وأعماله. وبينما يمر ميشيل بسيارته في شارع ضيّق، كانت امرأة عجوز تعبر الشارع، فتوقّف ميشيل ليسمح لها بالمرور، ففوجئ بأصواتٍ متتابعةٍ تصدر من كلاكس سيارات تأتي من خلفه، وتطالبه بالتقدّم. لم يعلّق، فلو كان مكانهم لفعل الشيء نفسه.
هذه المواقف الثلاث على تنوعها واختلاف تفاصيلها وسياقاتها الزمنية والمكانية، فإنّها تشتركُ في ضرورة الاستعجال الذي يؤرّق حياة أصحاب هذه المشاهدات في مدن من قارات مختلفة. كما تبرهن على عالمية هذا الحراك الذي يستجيبُ لمتطلبات السّرعة وشموليته، فلا يمكن لأحد أن ينجو منه مهما كان موقعه من المعمورة.
المشهدُ الأول في الإسكندرية يصوّر موجة الاستهلاك العنيفة التي تسبّبت فيها حركات الموضة المتسارعة، وأنتجت بالمقابل كمية أكبر من الأشياء التي لا مآل لها سوى سلة المهملات. غادة لا تريد أن تعيد تدوير حقيبتها ولو على نحو خفيف؛ لأنّ البديل موجود بوفرة وفي آخر صيحة.
التدوير بالنسبة لها يجعلها في صدامٍ مع الحياة التي تتغير وتيرتها، ولا يمكن معها الاستقرار على خيار واحد دون تبديل، الحقيبة القديمة صارت إذن في مصافّ الفضلات، واقتناء حقيبة جديدة شكلٌ من أشكال التملك وإثبات الوجود على حدّ قول إيريك فروم في كتابه الإنسان بين الجوهر والمظهر "كلّ استهلاك سابقٍ سرعان ما يفقد تأثيره الإشباعيّ، وهكذا فإنّ هويّة المستهلك المعاصر تتلخّص في الصيغة الآتية: أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك"[3].
كما أنّ إيقاع الحياة فرض على البنت وعمتها أن تتفقا على موعد لقاءٍ في المطعم، لا في المنزل، لأنّه أكثر اختصارًا لمتاعب عديدة ولا يحتّم عليهما الاجتماع مع أفراد العائلة و"تضييع وقت أكثر"، فهناك قائمة طويلة من المهام تنتظر الإنجاز، والوقت قليل، واجتماع العائلة أقلّ أهمية من ذلك.
الموقفُ الثاني يصف تأثير السرعة على مجالات واسعة امتدّت لتمسّ قصص الأطفال، وتحصرها في حيّز يقلّص من الوقت الذي يمكن أن يقضيه هؤلاء مع والديهم، ومن تفاصيل كثيرة أخرى كانت لتفتح آفاقًا واسعةً تحفّز تفكيرهم الإبداعيّ، وتغذّي خيالاتهم، وتشعرهم بالأمان أكثر.
السّرعةُ ساهمت إذن بطريقة مباشرة في تآكل تماسك الأسرة وأنتجت مصطلحًا بائسًا عرّفها به عالم الاجتماع الأمريكي كريستوفر لاش بـ مرفأ في عالمٍ بلا قلب.
يظهر جليًّا في المشهد الثالث كيف حدّدت السرعة سلوك المرء وخلقت حالةً من عدم الاكتراث بغيره؛ فاﻵخر بهذا المنظور لا أهمية له، لأنّ النزعة الفردانية تحتم سعي الفرد لنفسه فقط. لذلك، لم تكن تلك العجوز التي ستعبر الطريق تستحقّ الانتظار؛ لأنّها لا تضيف لخانة المنافع الشخصية شيئًا.
لماذا أصبحنا مهووسين بالوقت؟
يجيب الكاتب والصحفيّ الكندي كارل أونريه في كتابه في مديح البطء على السؤال السابق، من خلال تحليل النقلة النوعية التي غيرت حياة الإنسان، وشكّلت نظرته للوقت؛ فظاهرة التسارع هذه لم تنتج دون مقدمات؛ وقبل اختراع السّاعات، كانت المواعيد تسير وفقًا للوقت الطبيعيّ، وكانت المهام تُنجز في الوقت الذي يراه صاحبها مناسبًا، ولم تكن تلك الضجّة حول الدقائق المضبوطة والأزمنة المحدّدة تؤرّق مضجعهم بعد.
خلال الثورة الصناعية، بدأ الاهتمام بالمواعيد والسّاعات يتحول إلى أسلوب حياة؛ ومع عصر الصناعة واختراع الآلات والمحركات ووسائل النقل، وتوسّع المدن التي تستقطب أشخاصًا ذوي نشاط وكفاءة، أصبح من الممكن للإنسان أن يختصر المسافات، وينجز أعمالًا أكثر وأصعب بفضل تحكمه في الوقت؛ فسرعة الإنتاج هنا، تعني مزيدًا من الاستهلاك والربح، بالتالي إحراز تقدم في السوق والتفوق على المنافسين.
وحثّ الأمريكي بنجامين فرانكلين آنذاك على الدمج بين الربح والسّرعة "الوقت هو المال"، فكلّ دقيقةٍ تنتج ربحًا، وكلّ دقيقة تكلّف خسارة، ممّا جعل الشركات تخوض سباقًا لتسريع الإنتاج وزيادة الربح؛ لأنّ "السّاعة هي نظام تشغيل الرأسمالية الحديثة" كما يقول أونريه.
ولهذا الغرض، اعتبرت الطبقات الحاكمة الالتزام بمواعيد العمل واجبًا وطنيًا ومبدأً أخلاقيًا لا يمكن الحياد عنه، وأصبحت السّرعة معيارًا يحدّد كفاءة العمّال ومهنيتهم.
والواقع أنّ هذه المستجدّات لم تنجُ من المقاومة، لأنّ أي فعل لا يلبث إلّا أن يكون مصاحَبًا بردّ فعل. ومع اختراع الآلات الميكانيكية وانتشارها في أوروبا، عبّر الكثير من الشعراء والكتاب عن رفضهم، ووصفها الشاعر ديفيد جويلم على نحو لاذع، "اللّعنةُ على السّاعةِ سوداء الوجه على ضفة النهر، التّي أيقظتني وليتحطّم رأسها ولسانها وعجلاتُها التي تصيحُ كأنّها تتوقّع مجريات اليوم وأعماله التي لا تهدأُ أبدا"[4].
في السياق ذاته، جاءت حركات الأدب والفن الرومانسيّ في القرن الثامن والتاسع عشر كردّ فعل مقاوم على الوتيرة الصاخبة وعبادة السرعة وتقديس الوقت. وفي سنة 1776، دخل عمال تجليد الكتب بباريس في إضرابًا طالبوا فيه بتقليص ساعات العمل إلى أربعة عشر ساعة فقط. تبعهم أطباء النفس الذين بدأوا منذ سنة 1881 في دراسة الأثر السلبيّ للسرعة على الإنسان، وتسببها في زيادة حدّة التوتر ونوبات القلق، على نحو يمتدّ إلى اللحظة.
ولا تزال الجهود إلى الآن معتبرة للحثّ على ثقافة البطء والوتيرة المتمهّلة، أبرزها حركة "الطعام البطيء" التي تأسست من قبل عالم الاجتماع الإيطالي كارلو بيتريني احتجاجًا على فتح فرع لماكدونالدز في روما سنة 1986، وتوسّعت اهتماماتها لتدعو إلى ترسيخ ثقافة البطء، ولا تقتصر على محاربة الوجبات السريعة فحسب.
كل شيء سريعُ البلع
من المؤسف كيف خلقت ثقافة الإسراع حالةً من التبسيط المخلّ لكلّ زوايا الحياة، وأسبغ التسطيح على كلّ الميادين، وبدا كل شيء سريعًا وجاهزًا: تريدُ معلومة ما؟ تفضل كبسولاتٍ سريعة وسهلة البلع. تخيّل يا رعاك الله، أن تتصفّح يوتيوب فتجد مرئيات على شاكلة: مقدمة ابن خلدون في عشر دقائق، نظرية التطور في دقيقتين، تعلم معنا الروسية في سبعة أيام. أليس الأمر برمّته سخرية؟
عزّزت السوشيال ميديا بدورها هذه الظاهرة، ومنحت منصّات سهلة لكلّ من أراد أن يبلور رأيًا سريعًا؛ فالأخبار يجري تداولها بسرعة البرق، والمقالات التي تتناول هذه الأخبار وتحلّلها تنتج في استعجال يواكب الحدث ويستغلّ الترند للوصول إلى أكبر عدد من القرّاء، بالتالي لا تعصم من هذه الأخيرة من سطحية الطرح، وعدم استيفاء المعطيات اللازمة، لأنّ صياغة الآراء كالطعام، تطبخ على مهلٍ حتّى تنضج.
وجاء في كتاب نظام التفاهة لآلان دونو "هذا الفكر التراكميّ السّريع الذي يبلور بسرعةٍ وبدقّة موضوعًا محدّدًا نجح في اختصار مسيرةٍ طويلة كان تبادل الفكر فيها يتطلّب أجيالًا من التفاعل (المناظرات والخطابات والمراسلات والكتب والنشر والتوزيع والقراءة والنقد ونقد النقد)".
الناس الآن لا يصبرون على الإطالة والتنظير، ولا يتحملون كل هذه الخطابات والكتب وغيرها من "وجع الراس"، يكفيهم الحصول على مربط الفرس من كلّ عنصر أو خبر بأسهل وأسرع طريقة ممكنة، الأمر الذي غيّب صفة مهمّة وهي التفكير النقديّ والرّصين.
وشركات وسائل التواصل الاجتماعيّ تعلم ذلك، وتعمل على تعزيزه من أجل أرباح أكبر؛ فطوّر فيسبوك خوارزمية تجعل البوستات القصيرة هي الأكثر وصولًا للمستخدمين، وأضاف يوتيوب خيار الستوري إلى منصته التي ينصح المختصّون أنّها الأنجع لكسب متابعين أكثر، وحدّث انستجرام خاصية الريلز التي تضمّ لقطات أو مجموعات فيدوهات لا تتجاوز ستين ثانية، ويجد المرؤ نفسه خلالها ينتقل بين أفكار كثيرة وصور متنوعة عشوائيًا، ويغذّي ما يسمّى بـ"عقل القرد"، فيفقد شغفه حيال الأشياء الطويلة البطيئة، ويكتسب صفة التشتّت وفقدان التركيز والانتباه، وهذا دمار!
في خضمّ هذه الحياة الضيّقة اللاهثة، نحتاج إلى أن نركن إلى العزلة والهدوء، ونلعن السّرعة، كما لعنها من قبلُ المسرحي الروماني بلوتوس: فلتحلّ لعنة الآلهة، على أوّل إنسان عرف كيف يميّز بين السّاعات، واللعنة أيضًا على من شيّد المزولة في هذا المكان، لكي يقطع أيامي ويمزقها، إلى قطع صغيرة.
مراجع وهوامش:
[1] كارل أونريه: في مديح البطء، حراك عالمي يتحدّى عبادة السرعة، ت- ماهر الجنيدي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، مشروع كلمة، ص12.
[2] زيجمونت باومان وستانسواف أوبيرك: عن الله والإنسان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2018، ص78.
[3] إيريك فورم: الإنسان بين الجوهر والمظهر، ت-سعد زهران، المجلس الوطني للثقافة والفنون واﻵداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، ع 140، أغسطس/ آب 1989، ص40.
[4] كارل أونريه: في مديح البطء، ص56.
[5] آلان دونو: نظام التفاهة، ت-د.مشاعل عبد العزيز الهاجري، دار سؤال للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2020. ص52.